من خصائص الثورة السورية

ظهر المقال على موقع المجلة الدولية لدراسات الثورة السورية (مغلق) في 22 أبريل، 2012
لا شك أن كل ثورات الربيع العربي غنية بمفاجآتها والهزات العنيفة التي أحدثتها في مجتمعاتها. إنها ملاحم مسرحية تراجيدية ملفوفة في سجادة شرقية انحل عقدها وانداحت على المشهد العالمي خلال مدد تراوحت بين الأسبوعين والسنة. لكن الثورة السورية تفوق هذه الثورات كلها بطولها وتراجيديتها وكم القضايا الشائكة التي أظهرتها على سطح الماء الراكد. ما نراه هو مشاكل قرن كامل من التغيير بدأ في نهاية المرحلة العثمانية واستمر مع الإنتداب وظهور الدولة غير القومية وفشل القومية العربية. وكأن سوريا كانت برميلاً مغلقاً من قشور الفاكهة والخل والنبيذ تغلي دون نار حتى انفجر الغطاء وانتثرت الجفأة والرائحة المخرشة مخلوطة بالدماء والأشلاء والتخوين المتبادل. وهنا لا أتكلم عن سيرورة التغيير التي بدأت بالإنتفاضات الشعبية واستمرت بعد خبوت غبار المعركة، وإنما عن ملحمة الثورة نفسها التي دامت 18 يوماً في مصر ولا تزال مستمرة في سوريا منذ ما يربو على السنة. هناك الكثير ليقال، هناك الكثير ليُكتب، عن اسباب الإنتفاضة الشعبية في سوريا وتحولها إلى ثورة قد تجرف سوريا كما عرفناها إلى الفناء، وعن التوازنات الدولية التي تقضي للمرة الثانية على شعب عربي، وعن المجتمع السوري المنقسم على ذاته عشائرياً وطائفياً ومناطقياً، وعن النظام الإجرامي الذي تباهى دائماً بقدرته على إذهال خصومه من خلال إجرامه الفائق لأي تصور وعدم احترامه لأية قواعد، فحتى لعبة الإجرام لها قواعد لكن لعبة إجرام حكم الأسد ومخابراته لا قواعد لها فكل شيء مباح. لكن ما أريد أن أتكلم عنه الآن هو ديناميكية الثورة فقط، وبالتحديد أريد أن أتكلم عن أهم مميزاتها. قد يبدو للقارئ للوهلة الأولى أني أنتقد بقسوة أو أني آخذ النواحي السلبية وأتغاضى عن الإيجابيات. إنني في الحقيقة أصف الواقع الذي لا مهرب منه والذي لا أخجل منه، ولونظرنا إلى المقالة ككل لوجدنا أنها تتحدث عن عملية تغيير هائلة يمر بها المجتمع السوري، والتي قد يكون لها ثمن باهظ لكنها في النهاية ستقود إلى مستقبل أفضل. كتب أحد الزملاء في مراسلة شخصية يقول بما معناه “إن سوريا تنفض عن نفسها غبار سنوات الإستعمار ومن ثم سنوات التدخل الغربي خلال الحرب الباردة وتبعاته؛ سيكون التغيير أليماً لكنه تغيير نحو الأحسن”.
إن من أهم ما يميز الثورة السورية إلى الآن ويمنعها من تخطي المراوحة في المكان وتحقيق انتصارات تراكمية تنتهي بالقضاء على النظام القائم هو غياب المؤسسات والثقافة المؤسساتية في المجتمع السوري. في الحقيقة فإن التشخيص أسهل ألف مرة من العلاج لأن تكوين المؤسسات وبناء الخبرة والثقافة القادرة على بناء وتسيير هذه المؤسسات لا يتحققان في أشهر أو سنة، والثورة السورية تتعلم من ملحمتها نفسها ومن كيسها وسيكون لهذه المعرفة المكتسبة بالدماء الزكية الأثر العميق في بناء المجتمع السوري الجديد. إن ثورات القرن التاسع عشر في أوروبا بما فيها الحروب القومية كانت المخاض الذي برزت من خلاله المؤسسات التي تميز الدولة الغربية الحديثة. هذه البنيات غير المشخصنة والمؤلفة من وظائف وقواعد وبروتوكلات هي ما يسمح بتنظيم واستيعاب قدرات مئات الآلاف من البشر، وهي بعكس بنيات المجتمعات التقليدية العشائرية أو الطائفية أو الدينية المؤلفة من أشخاص تحكم تصرفاتهم الأعراف والتقاليد الموروثة. المؤسسة أو الشخصية الإعتبارية (التسمية القانونية للمؤسسة) تختلف اختلافاً جذرياً عن الفرد أو مجموعة الأفراد أو الشخصية المادية الفيزيائية. في غياب هذه المؤسسات التي تؤطّر القيادة والتبعية، الأوامر والإنصياع، والضوابط والإنضباط، تظهر تجمعات عضوية صغيرة ذات قيادات “طبيعية”، أو تجمعات تقليدية ذات قيادات “تقليدية”، بالإضافة إلى تجمعات هلامية يصنعها الإعلام الحديث ليس لها قيادات حقيقية وإنما أقطاب “مشهورة” تصوغ الرأي العام.
غياب المؤسسات وتبعاته
إن من أهم سمات الثورة السورية وما يميزها، سلباً بالطبع، عن ثورات الربيع العربي هو الغياب التام للمؤسسات، وخاصة المؤسسات السابقة للثورة من مؤسسات أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني. أما بالنسبة للدولة ومؤسساتها فهي تعمل في طرف النظام وضد مجتمعها. من أجل فهم هذه الوضع غير المتوازن يكفي ذكر خمسين سنة من احتكار الدولة السلطوية لبناء المؤسسات وحرمان المجتمع المدني من أية بنيات تنظيمية يواجه من خلالها تسلط الدولة، ويحافظ من خلالها على توازنه في حال ضعف الدولة أو غيابها، ويقدم من خلالها الخدمات الإجتماعية التي تقننها الدولة لشراء الولاءات أو لا تضطلع بالقيام بها أصلاً. حتى مؤسسات الدولة هذه التي احتكرها النظام تم تفريغها من محتواها المؤسسي (أي الشخصية الإعتبارية وهيكلية الوظائف وبروتوكولات العلاقات والمعاملات) لتتحول إلى عصابات (مجموعات أفراد) تقوم على الولاءات العشائرية والطائفية والمصلحية الضيقة. وأذكر أمثلة على مؤسسات المجتمع المدني الشركات الكبيرة والمتوسطة التي يقوم عليها إقتصاد السوق الحر، الجمعيات الخيرية التي تتحمل أعباء الضمان الإجتماعي، الجمعيات المهنية التي تضع قواعد المهن وتدافع عن مصالح ممارسيها، الجمعيات الثقافية التي تقوّي الهوية المشتركة للمجتمع وتنشر ثقافة التبادل الثقافي السلمي وتنشر أنماطاً من التعليم تكمّل التعليم المدرسي والجامعي، الأحزاب السياسية التي تقود الدولة وتمارس التفاوض السلمي بين فئات المجتمع ممثلة بالأحزاب. هذا الغياب لا ينتج عنه فقدان الخدمات الهامة التي تقدمها هذه المؤسسات فحسب بل فقدان الوعي والمعرفة اللتين تستطيعان بناء هذه المؤسسات وتسييرها؛ لأن المؤسسة ليست فقط جماعة من الأفراد كالعشيرة بل جماعة مدرَّبة على العمل ضمن هيكلية معينة وعلى احترام القواعد والأنظمة الداخلية وعلى إعادة إنتاج هذه الهيكلية وثقافة الإحترام للقواعد هذه يومياً. غياب المؤسسات وثقافتها يشرح تصرفات معروفة ومشهورة عند السوريين يتعجب لها الناس ويعزونها إلى ما يسميه البعض التخلف أو إلى الكسل أوالجهل، وأعني عدم احترام قوانين السير مثلاً، عدم احترام الطابور، كسر القانون والتفاخر بكسره، الرشوة والفساد وكسر قواعد عمل المؤسسات. حتى القبائل القديمة كانت تحتكم إلى قضاة من المعروفين بالحكمة والعقل والحلم، أما في سوريا فمؤسسة القضاء من أكثر المؤسسات فساداً مما يعني انعدام العدل وضياع الحقوق، فلا حرمة للممتلكات ولاحرمة حتى للحياة.
نتائج غياب المؤسسات
لنتخيل حالة مجتمع مثل المجتمع السوري لا توجد فيه مؤسسات (خاصة الأهلية منها) تؤطّر عمل أفراده خاصة حين تكون الحاجة ماسة إلى هذا التأطير كما هو الحال الآن في الثورة حيث الشعب يعادي المؤسسة الأمنية والعسكرية للدولة، وحيث هذه المؤسسة تقتل الشعب وتحرمه من حقوقه الاساسية وحتى من خدمات بقية مؤسسات الدولة. في هذه الحالة سيتجمع الأفراد ليتعاونوا فيما بينهم على تأمين حاجياتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس بالإضافة إلى تنظيم حركة الإحتجاج ضد النظام. في أي تجمع بشري نرى مباشرة ظهور شيء من التنظيم الذي يضمن تحريك جهود الأفراد في اتجاه معين ونحو هدف معين. هذا التنظيم يأخذ شكل التخصّص، وتوزيع المهام، والتخطيط، ونشوء قيادات لاتخاذ القرارات الهامة ووضع السياسات الطويلة الأمد والتواصل مع الجماعات الأخرى وحل المشاكل التي تنشأ بين افراد الجماعة أو بين الجماعات المختلفة. في الجماعات الصغيرة قد تكون القيادة غير ملموسة وتظهر فقط عند مناقشة أمور هامة حيث يتصدى بعض أفراد المجموعة لمهمة تحقيق الإجماع. وعندما تكبر الجماعة لا بد لها من فئات متخصّصة ولابد من قيادات. حين تغيب الثقافة المؤسساتية فإن ظهور القيادات يتبع إما القنوات الطبيعية (كاريزما وقدرة على الإقناع، قوة جسدية وشجاعة، ذكاء وحكمة، موارد مادية) أو القنوات التقليدية (الأعيان والكبراء، رجال الدين، مشايخ العشائر). وسنتكلم عن هذه القنوات حين مناقشة نماذج القيادة في القسم الثاني. أما الآن فلا بد من فهم طريقة عمل هذين النوعين من القيادات ونتائج هذه الطريقة في القيادةعلى جدوى العمل المشترك.
لنتكلم أولاً عن العمل المؤسساتي لنضع معايير للمقارنة مع ما نجده على ساحة الثورة السورية. عندما تعمل أية مجموعة ذات قيادة ضمن إطار مؤسساتي (ولسنمها المؤسسة) فإن
- قواعد المعاملات ضمن المؤسسة: قواعد العمل والتعامل بين الأفراد معروفة وموحدة ومتاحة للجميع ليطّلعوا عليها ويتعلموها،
- قواعد إنتقاء القيادة: كما أن انتقاء القيادات يتم حسب قواعد معروفة أيضاً (إنتخاب أو تعيين حسب هرمية) ويمكن لأي فرد من المجموعة أن يدخل حلبة التنافس المشروع للوصول إلى المراكز القيادية،
- تنظيم التنافس: هرمية القيادة (المراتب الأعلى والأدنى) معروفة مما يجعل التنافس على الوصول إلى مراكز أعلى خاضعاً لقواعد تمنع التنافس الهدام (أي تهديم المجموعات المنافسة وامتصاص أعضائها في سبيل الوصول إلى مركز قيادي أعلى).
- تكافؤ الفرص: آليات المساءلة للافراد والقيادات معروفة وتقوم بها جهات حايدية ذات سلطة مما يسطّح مستويات التنافس ويجعله عادلاً ويؤمن تكافؤ الفرص وتوزيعها حسب الكفاءة.
- عدالة التوزيع: توزيع الموارد على المجموعات يخضع لقواعد تضمن استمرار العمل الجمعي وتحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق إنطباع بعدالة التوزيع وعقلانيته.
- توحيد أهداف العمل: الجهود الفردية والجماعية تنصب في قنوات معروفة توجهها نحو تحقيق أهداف عامة للمؤسسة باسرها.
- قواعد التعامل بين المؤسسات: إن فكرة وجود دستور أو نظام داخلي يجعل تمثيل المؤسسة أمام المؤسسات الأخرى ممكناً وسهلاً. قيادات المؤسسة تمثلها أو تفوض من يمثلها. وهذا يجعل التعاون بين المؤسسات ممكناً رغم تعقيده وصعوبته ويؤمن بروتوكولات التعاون ومرجعيات حل المشاكل والتحكيم.
وكما في القانون، العقد شريعة المتعاقدين. فالمؤسسة مهما صغرت (شركة صغيرة) أو كبرت (دولة) هي عقد بين أفراد وجماعات يضبط علاقاتهم بعضهم ببعض. أما المجموعة غير المؤطرة (ولنسمها العضوية) مؤسساتياً فهي مجموعة لا يحكمها أي عقد، أي قانون، أية قواعد، وهي لذلك مستقلة في أهدافها وقراراتها ومواردها وأعمالها ووجودها وتتصرف كفرد يحاول البقاء على قيد الحياة (كجماعة) ضمن وسط “عضوي” من الوحدات المشابهة والمتنافسة معها على كل شيء. عندما تعمل مجموعة عشوائياً دون ضوابط وقواعد متفقد عليها (أي دو نعقد أو نظام داخلي أو دستور) فإن:
- الصراعات تتكاثر ولا تجد حلاً: في المجموعة العضوية تتكاثر الصراعات ويصعب حلها لعدم وجود ضوابط أو آليات تحكيم. تتراكم هذه الصراعات لتنفجر بعدها المجموعة إلى أفراد منفصلين وينعدم وجودها كوحدة.
- التنافس على القيادة يحتدم: إذ لا توجد معايير لتقييم عمل الجماعة كوحدة ويصبح أي عمل فردي مثل غيره أو أية فكرة مثل غيرها. فإذا عجزت الجماعة العضوية عن تحقيق الإجماع وتراكمت المشاكل واحتقنت النفوس ليتحول الأعضاء إلى متنافسين، كلٌ يريد فرض رأيه ونظرته وأفكاره ومشاريعه على الآخرين لأنه يعتقد بصحتها ونجاعتها فليس هناك من سبب لأن يكون رأي الواحد أحسن من رأي الآخر أو عمل الواحد أفضل من عمل الآخر. وتنعدم أسس مشروعية القيادة، والتي تقوم غالباً على حسن الأداء والقدرة على تحقيق الإجماع.
- التنافس غير النزيه: التنافس على المراكز القيادية بحد ذاته امر موجود دائماً ومطلوب من أجل إبراز المواهب. لكن في الجماعة العضوية حتى وإن حاول الفرد الوصول إلى الإجماع وإبراز حسن الأداء فإن الآخرين المتنافسين معه سيضعون العراقيل في وجهه ويهدمون عمله، فلا توجد معايير ولا مساءلة ولا هرمية وإنما قيل وقال ومناحرات فردية.
- تفاضل الفرص: وحتى إن نجحت الجماعة العضوية في إيجاد قيادة فإن هذه القيادة ستكون إما كارزمية أو تقليدية وفي الحالتين فإن القائد يتقمص الوظيفة وتصبح مرتبطة ومتحدة مع الشخص القائد وغالباً ما تخضع لتوازنات يقف الشخص القائد على رأسها بحيث يجمع بيديه خيوط الإجماع وخيوط تماسك الجماعة تستمر باستمراره في القيادة وتزول بزواله عن القيادة. هذا النوع من القيادات الذي يعتمد على الشخص يخلق هرمية قائمة على الولاءات الشخصية (الحالة الكاريزمية) أو الإنتماء إلى الفئة القائدة (كالعائلة أو العشيرة) في الحالة التقليدية. ووصف عدد من المراقبين لساحة الثورة في سوريا العشائرية الضيقة ومبدأ “أنا ما بأقدر إشتغل خذوا إبني” أو “بدي مساعد لذلك سأعين إبن عمي”. وفي الحالتين لا يوجد تكافؤ في الفرص قائم على حسم الأداء. وحتى القائدالكاريزمي يتحول مع الزمن إلى ديكتاتور يقضي على محاولات إقتلاعه من مكانه على رأس المجموعة.
- الإحتكار والتعسف في التوزيع: توزيع الموارد ضمن الجماعة العضوية يخضع لهرمية القيادة التي ذكرنا أنها تقوم على الولاءات والإنتماءات العشائرية. المجموعة العضوية غير عادلة بالتعريف واحتكار الموارد والسلطات هي سمتها المميزة. المجتمعات التقليدية مثلاً متراتبة (غالباً حسب معايير الدين والإنتماء العشائري) وهي وإن لم تتألف من طبقات بالتعريف الماركسي فإنها تتالف من جماعات غير متساوية. الجماعة العضوية ليس لها هدف واحد لأنها مجموعة من الأهداف الفردية التي تنحصر بالوصول إلى القيادة والبقاء فيها. ومثالنا على ذلك مفهوم الدولة في التاريخ العربي الأوسطي. التعبير الأقدم هو دولة بني العباس أو بني عثمان وليس دولة سوريا، وتعني المكان والزمان حيث تتفوق العشيرة العباسية أو العثمانية على منافسيها وتحتكر لنفسها المال والسلطة. وإذا نظرنا إلى تاريخ سوريا الحديث ومفهوم التنافس بين الأحزاب (وهو ما يعتبره البعض تجربة ديمقراطية) فإننا نرى هذا التنافس قائماً على مفهوم “دولة الحزب” أي وصول الحزب إلى السلطة واحتكاره لها وحتى لأموال الدولة وليس على مفهوم تداول السلطة دورياً (أساس الديمقراطية). ومسؤولو حزب البعث هذه الايام حين يتكلم الناس عن إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل الحزب “قائد الدولة والمجتمع” فإنهم يجاهرون بوقاحة “بأنهم وصلول إلى الحكم بجهدهم وهو بالتالي حق لهم وحكر عليهم” ونسمع ذات الشيء من أنصار دولة الاسد وخاصة المخابرات والشبيخة الذين يتكلمون عن “سادة البلد” و”الثورة على أسيادكم” و”الأسد أو نحرق البلد”. ولذل فإن تعبير “دولة البعث” يتبع المعنى القديم وليس المعنى الحديث. ولو استلم الحكم أي من الأحزاب الموجودة على الساحة في فترة الستينات (قومية أو إشتراكية أو إسلامية) لكانت النتيجة ذاتها أي الإحتكار. ومن المؤسف أن نسمع الآن بعض التعابير من بعض الإسلاميين تقول “جربنا القوميين واليساريين والآن حان الوقت لتجريب الإسلاميين” وهو يعنون حان الوقت لظهور “دولتنا” أي احتكارنا للحكم. فإذا عدنا إلى الجماعة العضوية نجد أو الوصول غلى القيادة “حلم” يمارسه الجميع ويتآمرون للوصول إليه، ويتعلقون به متى ما وضع اليد عليه. ولنا في المجلس الوطني السوري خير مثال فحتى النظام الداخلي بقي حبراً على وقت من أجل أن يستطيع من وصلوا إلى الراس البقاء هناك واحتكار السلطة والمال. المجلس الوطني للأسف كرر تجربة “دولة البعث” بان اصبح “دولة غليون” او “دولة المكتب التنفيذي”.
- إنعدام الهدف : إن الهدف الوحيد للجماعة العضوية هو بقاؤها كما هي وبالتالي بقاء قيادتها. وفي وسط من نقص الموارد تتحول الجماعة العضوية من خلال قيادتها إلى منافس شرس لا على اقتسام الموارد بل على الإستيلاء عليها. فلنتخيل مثلاً مجموعة مقاتلين في مدينة ثائرة، أغلبهم من المدنيين، مؤلفة من 200 مقاتل، يتزعمهم شخص واحد وصل إلى الزعامة من خلال شخصيته أو من خلال وجاهو عشيرته أو من خلال علاقات بالممولين. في حالة وقف إطلاق النار” لن يكون للزعيم من هم إلا الإبقاء على جماعته بالتالي على زعامته. فهو 1. يرفض التعاون مع الجماعات الأخرى إلا بقدر ما تحقق أغراضه السابقة الذكر، 2. ويتنافس على التمويل ولا يتقاسمه مع الجماعات المقاتلة الأخرى لان الإقتسام يعني فرط الجماع ونشوء جماعة أكبر قادرة على توزيع الموارد بالمناصفة (أي لكل نفس الحصة)، 3. ولا يشترك في عمليات “خطرة” لأنه سيفقد رجالاً وسلاحاً مما قد يضطره للإنضمام إلى جماعة أخرى وبالتالي فقدان زعامته، 4. سيفعل المستحيل لتمويل جماعته وعائلاتهم وإبقائهم معه حتى لا يرحلوا عنه وينضموا إلى جماعة زعيم أغنى وأقدر، وبالتالي فهو مستعد للقيام باعمال نهب وسرقة وابتزاز، 5. لا يترك منطقة تمركزه لأنه سيفقد المأوى لجماعته وسيفقد كذلك مصدر الرزق (الضرائب) ومصدر مشروعية جماعته (أي حماية المنطقة من المعتدين). إن في سوريا مئات الجماعات المقاتلة التي ترفض للأسباب السابقة الذكر تشكيل قيادات عسكرية موحدة (كقيادة الجيش الحر) تنظم جمع التمويل وتوزيعه العادل وتنقل المقاتلين وتخطيط العمليات والتعاون مع الجماعات الأخرى المنضوية تحت القيادة.
- البقاء للأقوى وليس التعاون: الجماعة العضوية لا تستطيع التعامل مع الجماعات الأخرى لأنها لا ترى فيهم إلى أعداء أو منافسين. إذا تقربت منها جماعة ما أو فرد منها حاولت امتصاصه حتى لا يرتبك توازن القوى ولعبة “دولة الفئة القائدة”. وإذا تعاونت مع جماعة أخرى في الوصول إلى هدف حاولت الإلتفاف عليها والإستيلاء على مقدراتها وتفرقتها أو امتصاصها. ولذلك فإن الجماعات العضوية دائماً جماعات قزمة لا تكبر لانها لا تستطيع إستيعاب القادمين الجدد ضمن هيكلية عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين القدماء والجدد وتضمن التنافس النزيه على القيادات وفقاً لحسن الأداء. وهذا ما قد يشرح تقزّم الجماعات العاملة على ساحة الثورة السورية. أغلبها جماعات عضوية تصل إلى حد معين من التوسع وتتفكك بعدها بسبب التنافس والعراقيل الداخلية. وبما أن الجماعات العضوية قزمة ومتنافسة فهو تقوم بنفس الوظائف وتعيد ما يفعله آخرون لا بل تتنافس معهم في “سوقهم” من أجل التوسع والإستيلاء على الموارد.
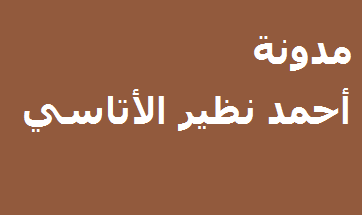

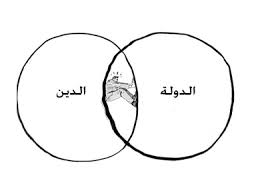


 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات