أفكار لتأسيس حزب

ظهر المقال على موقع المجلة الدولية لدراسات الثورة السورية في 30 أبريل، 2012
الفصل الأول – لماذا حزب وليس مجموعة عمل؟
من المعروف الآن وبعد عام من الثورة السورية أن أغلب السوريين يفضلون العمل ضمن مجموعات غير أيديولوجية. مجموعات الداخل تنقسم إما إلى مجموعات مقاتلين أو مجاهدين أو إلى مجموعات خدمات (إعلام وإغاثة وطبابة وتمويل). أما مجموعات الخارج فهي في غالبها مجموعات دعم لثورة الداخل وهذا يعني أنها خدمية (إعلام، إغاثة، تمويل، تجهيز، تسليح، ودعاية وقد يشارك بعضها مع مجموعات الداخل في تنظيم فعاليات ثورية قصيرة الأمد تعجز في الغالب عن شمول القطر كله أو عن الوصول إلى نتائج ملموسة). وليس هذا التوجه نابعاً من معرفة بقصور الأحزاب وعدم ملائمتها للحالة السورية أو لحالة الثورة وإنما بسبب ثقافة الخوف التي زرعها النظام في قلوب السوريين من العمل السياسي بشكل عام والعمل الحزبي بشكل خاص. وحتى الذين انتسبوا يوماً ما لحزب البعث ويعرفون آليات عمل الأحزاب فإنهم يقرفون منها ويربطونها دائماً بحزب البعث وما يمثله من نفاق وشعارات فارغة وسيطرة على الدولة ووصولية. لكن الحقيقة هي أن العمل الحزبي، حتى وإن تشابه من حيث الشكل البيروقراطي مع العمل داخل حزب البعث، فهو ضروري وأساسي لبناء حياة سياسية صحية في سوريا المستقبل. وقد رأينا أن مجموعات العمل داخل وخارج سوريا لا تستطيع أن تكبر لتشمل آلاف الأفراد وذلك لأسباب عديدة منها صعوبة التواصل ومنها عدم معرفة كيفية بناء المؤسسات وكذلك غياب الثقافة المؤسساتية (كتابة النظام الداخلي، وضع الأهداف والمبادئ، إحترام القواعد والأنظمة، آليات العمل الجمعي المشترك، إدارة بيروقراطية كبيرة، الخلط بين القيادة الهرمية والديكتاتورية). هناك سبب آخر لا ينتبه إليه كثيرون وهو نوع من الإنكار الذي لا زال الكثير من السوريين يعيش فيه وأعني الإعتقاد بقرب نهاية الثورة وسقوط النظام وارتباط ذلك في الأذهان بعدم جدوى البدء بأعمال بناء (مثل بناء حزب سياسي) قد تستغرق أشهراً أو سنوات. لا يوجد وقت مناسب وآخر غير مناسب للبدء بالعمل مهما طال أو صعُب. ولا أرى أنسب من الآن للبدء بتأسيس حزب سياسي يساهم في إنجاح الثورة وينتظم من خلاله كثير من المواطنين بعد إسقاط النظام من أجل دفع عجلة البناء وتسريع العمل السياسي في المرحلة الإنتقالية.
ويتميز الحزب عن أية مجموعة عمل بالمزايا التالية:
- يُفترض في الحزب الدوام بينما يُفترض في مجموعة العمل الزوال حال تحقيق الهدف التي أنشئت من أجله.
- يسعى الحزب دائماً لأن يكون مؤسسة على مستوى البلد كله، بينما نرى أن مجموعات العمل لها طابع مناطقي في الغالب.
- الحزب مجموعة كبيرة من الأفراد المؤمنين ببرنامج سياسي معين ولذلك فهم ملتزمون بهذا البرنامج مما يزيد الثقة المتبادلة بين الأعضاء ويزيد وحدتهم بسبب وحدة الهدف والفكر، وهذا بالطبع يجعل العمل الجمعي المشترك أسهل.
- الحزب هو مثال المؤسسة وذلك في هيكليته وأهدافه ونظامه الداخلي وثقافة الإنضباط التي يزرعها في أعضائه.
- الحزب ضمانة المحافظة على الخبرات التي تراكمت أثناء الثورة والإستفادة منها في مراحل ما بعد الثورة.
- الحزب يجمع الكفاءات الفكرية والتكنوقراطية والسياسية (التفاوض وصنع الإجماع) مما يمكنه من إدارة أجهزة الدولة في حال نجاحه في الإنتخابات. هذه الكفاءات تبقى ضمن الحزب عندما يخسر الحزب الإنتخابات ليعود فيوظفها حين ينجح في الإنتخابات من جديد.
- إن ثقافة الديمقراطية (وحتى الديكتاتورية كما في حالة حزب البعث) تبدأ في الحزب. ولذلك فإن ضمانة الديمقراطية هي الثقافة الحزبية الديمقراطية.
الفصل الثاني – ماذا نحتاج لتأسيس حزب؟
- الإسم: يجب أن يكون سهلاً، واضحاً، ويعبر عن أهداف الحزب.
- الشعار: لا بد للحزب من شعار (صورة أو كلمات تعبر عن أهدافه وأفكاره). ونقترح هنا شعار “جيرة وحرية، حقوق وجمهورية”. فالجيرة تعني التعايش والتكافل والتضامن، والحقوق هي أساس القانون، والحرية أساس الحياة الكريمة، والتمثيل أساس حكم الشعب.
- النواة المؤسِسة: وهذه النواة تتألف من عدد من الأشخاص المؤمنين بأفكار سياسية متقاربة والملتزمين بالعمل الطويل الأمد.
- الشرعية: لا بد من إعلان تأسيس الحزب على الملأ فالحزب السري يثير الشكوك ولا يحظى بالإعتراف من الرأي العام وبالتالي الشرعية. طبعاً لا بد من تسجيل الحزب عند الجهات المختصة ووفقاً للقوانين الناضمة لتأسيس الجمعيات والأحزاب. لكن وفي ظل غياب هذه الدولة والقوانين العادلة الناظمة لتأسيس الأحزاب لا بد من الإشهار، ووضع أدبيات الحزب وهيكليته على الإنترنت ليطلع عليها الجميع، وكذلك لابد من محاولة تسجيل الحزب في دولة مجاورة والحصول على اعتراف عدد من الدول به كحزب شرعي يمثل شريحة من المجتمع السوري ويسعى لترخيص وجوده حالما تسمح الظروف القانونية بعد انتهاء الثورة.
- البرنامج أو/و الأيديولوجيا: إن هدف أي حزب في العالم هو الوصول إلى الحكم (الجهاز التشريعي، الجهاز التنفيذي، المجالس المحلية). طبعاً تقتضي الديمقراطية أن لا يطهّر الحزب الدولة التي يحكمها من معارضيه ويتحول إلى ديكتاتورية. وعندما يحكم الحزب في أي من الأجهزة السابقة الذكر فإنه يسعى من خلال مرشحيه لتطبيق برنامجه. ويشمل البرنامج رؤى لكيفية إدارة الدولة والإقتصاد وتحقيق المساواة والعدالة وإعلاء سلطة القانون. وقد يقوم هذا البرنامج على أيديولوجية مفصّلة ومعلنة أو على مجموعة من الرؤى والأفكار السياسية. ليست كل الأحزاب أيديولوجية فبعضها مجرد تحالف بين أعضاء ومناصرين لدفع تطور الدولة في اتجاه معين.
- الأهداف: البرنامج يتضمن الأهداف الدائمة التي يسعى الحزب لتحقيقها كلما وصل أحد مرشحيه إلى موقع من مواقع السلطة في الدولة (على أي مستوى). لكن لابد في كل مرحلة من تاريخ الحزب والبلد من أهداف يسعى الحزب إلى تحقيقها تدفعه خطوة أخرى إلى الأمام على طريق تحقيق برنامجه.
- الهيكلية: الحزب مؤسسة ولذلك فلا بد له من هيئات متخصصة تضطلع بالقيادة ووضع السياسات العامة وتطوير البرنامج وإدارة الحزب وزيادة الأعضاء وتدريبهم ودعم المرشحين وإنشاء الفروع واحترام النظام الداخلي.
- النظام الداخلي: كأية مؤسسة لابد للحزب من نظام داخلي يضبط العلاقات بين الهيئات المؤلِفة لهيكليته.
- التمويل: غالباً ما تعتمد الأحزاب على اشتراكات سنوية تحصّلها من الأعضاء، لكن هناك مصادر أخرى للتمويل مثل التبرعات المعلنة من مناصرين للحزب ولبرنامجه.
- الأعضاء وسياسة العضوية: في الستينات كانت الأحزاب الطليعية هي السائدة على الساحة السياسية. وهي أحزاب لا تسعى إلى توسيع عضويتها وإدخال العدد الأكبر من المواطنين في صفوفها وإنما تسعى إلى إجتذاب أعضاء متميزين وتعتبر نفسها نخبة المجتمع القادرة على قيادته. ونعرف كيف انتهى بنا هذه النموذج إلىديكتاتورية الحزب الواحد الذي يتعالى على الجميع ويعتبر نفسه “قائد الدولة والمجتمع” ويفرض برنامجه فرضاً بقوة الدولة بعد ان يستولي عليها. هناك أيضاً نموذج الأحزاب الشعبية التي تحاول جمع العدد الأكبر من الأعضاء من أجل ادّعاء تمثيل المجتمع بأسره (مثل حزب البعث بعد حكم الأسد ومثل جماعة الإخوان المسلمين). وهذا يقودنا أيضاً إلى حزب يدّعي التفويض الشعبي الكامل فيُقصي بقية الأحزاب عن السلطة ويستأثر بها وحده بدعوى أنه يمثل كل شرائح المجتمع. يجب أن يختار الحزب سياسة للعضوية تجعله أولاُ لاعباً جدّياً على الساحة السياسية، وتجعله ثانياً قادراً على ترشيح مرشحين لأي منصب وفي أية منطقة في القطر، وتجعله ثالثاً ممثلاً لمصالح شريحة حقيقية في المجتمع تؤمن بمبادئه وأهدافه وبرنامجه، وتجعله أخيراً يحقق توازناً يضعه في وسط الطيف بين النموذج الطليعي والنموذج الشعبي.
الفصل الثالث – في نقد الايديولوجيا في سوريا الحديثة
خلال القرن الماضي سيطرت أربعة أنواع من الأيديولوجيات على الساحة السياسية السورية: والقومية و الليبرالية والإشتراكية والإسلامية. ونستطيع ان نقول دون الوقوع في خطأ فادح من التعميم أن أياً من هذه الأيديولوجيات لم تتطور لتكون حاملة فكر ومشروع وطني محلي متكامل. هذه الأيديولوجيات كانت إما إستيراداً فكرياً من الخارج بلبوس محلي أو رد فعل على هذه الإستيراد (ونعني الإيديولوجيا الإسلامية).
الفكرة القومية نشات في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر ورافقت ظهور الدول الأوروبية الحديثة وساهمت في إنشائها، لكن لم تنجح لا القومية العربية ولا القوميات المحلية (من سورية أو فينيقية أو فرعونية أو مغاربية أو كردية) أن تبني دولة متماسكة إجتماعياً وسياسياً إذ استمر حكم الفرد، الملك أو الخليفة أو الديكتاتور، الذي يعتبر الشعب رعايا له واستمرت الهويات المحلية والعشائرية والطائفية بالوجود والنمو وانتصر بعضها أحياناً كما في الحالة اللبنانية أو العراقية (ما بعد الإحتلال الأمريكي). والحقيقة هي أن القومية العربية مثلاً لم تكن أيديولوجيا واحدة عامة بل أيديولوجيات مختلفة باختلاف البلد ومغرقة في المحلية تحاول كل منها السيطرة على الأخريات بادعاء زعامة الأمة العربية. فأيديولوجية البعث ليست أكثر من الهوية السورية تفرض نفسها كهوية عربية عامة، والأيديولوجيا الناصرية ليست إلا هوية مصرية تفرض نفسها كهوية عربية ووبدا ذلك واضحاً في فترة الوحدة بين سوريا ومصر. وحتى اليوم ومن خلال برامج مثل أراب أيدول وسوبر ستار نرى تنافساً شرساً أحياناً بين اللهجات المحلية والثقافات والقوميات القطرية تحت مظلة السلم الموسيقي الشرقي (المسمى تعسفاً بالعربي).كانت مصر زعيمة يوماً (الناصرية) وحاولت سوريا (البعث) واليوم السعودية (الوهابية السلفية) وغداً ستحاول دول أخرى أن تكون زعيمة المنطقة لتحاول امتصاص الدول المجاورة جغرافياً أو ثقافياً او ديبلوماسياً أو إقتصادياً بادعاء التشابه الثقافي واللغة الواحدة والتاريخ الواحد. في الحقيقة ليس هذا بالغريب فالقوميات جميعاها تسيطر عليها هوية وثقافة الطبقة الحاكمة التي تصوغ وتقولب الثقافات المحلية المجاورة على نسقها وقدها. ولذلك ندخل نتوسع في الأيديولوجيا القومية أو نحاول تطويرها لأن القومية مجرد مشروع هوية وانتماء وليست مشروعاً إقتصادياً أو مشروع إدارة دولة أو مشروع فلسفة قانونية. ولا نهمل هذا الإنتماء وإنما نحصره في سوريا ونترك القومية العربية ومشروعها للمدى الطويل إذا لا نرى ما يشير غلى مصلحة أي من النخب المحلية في إنجاز وحدة عربية عامة تفقد معها هوياتها المحلية الخاصة بأن تُفرض عليها هوية نخبة مركزية معينة.
ما نحاول الوصول إليه هنا هو مشروع دولة ومشروع مجتمع تكون الهوية أحد مكوناته. ولا ضير أبداً من تقوية هوية سورية متعددة الجوانب ذات أصالة في تاريخ سوريا العريق وتشبث بلغات وثقافات القوميات والطوائف والمذاهب المكونة للشعب السوري. لا نريد هوية وطنية سوريا يطغى عليها فقط الهوس الفينيقي أو العربي الإسلامي أو العربي الجاهلي أو المسيحي البيزنطي أو المسيحي السرياني أو الكردي أو الآشوري أو التركماني أو الأرمني. وإنما هوية تعايش مشترك لمكونات متعددة، واحترام لقانون يحمي هذا التعايش ويضمن حقوق الجميع، ومواطنة في دولة تحترم الجميع وتضمن حقوقهم. نريد أن يتعلم أولادنا عدة لغات للتواصل، وأن يدرسوا في مدارسهم التاريخ السوري-العربي والسوري-البيزنطي-السرياني والسوري-الكردي والسوري-الفينيقي، وأن يقرؤوا آداب كل الشعوب التي مرت على سوريا منذ آلاف السنين وأثرَت حضارة البلد وحضارة البشرية جمعاء. نريدهم أن يتعلموا أيضاً لغة تواصل دولية (إنكليزية أو فرنسية أو ألمانية أوغيرها) دون إحساس بالنقص أو التبعية ودون خوف على لغتهم الأم وثقافتهم الوطنية. نريدهم أن يتعرفوا على كل الأديان والفلسفات التي مرت على أرضنا دون تقوقع وانعزال. نريد أن نبني ثقافة وطنية واثقة من نفسها، تملك لغة أو لغات تستطيع بها التعبير عن نفسها، وتملك بحثاً علمياً وفلسفة وثقافة توطد علاقتَها بلغاتها الوطنية وتساعد في تطوير هذه اللغات. ألم نسأم من الإزدواجية اللغوية في العربية مثلاً بين العربية الحديثة القاصرة القائمة على الترجمة والتي يقودها الصحفيون فقط من القرن التاسع عشر، وبين العربية القديمة التي يسيطر عليها مشايخ الدين والتي على جمالها وبلاغتها لم تتطور بما يناسب العصر مع إيماننا بقدرتها على ذلك؟ ألم نسام من أن يتعلم أولادنا الشعر العربي البدوي الجاهلي وأن تُهمل الاشعار السريانية والإغريقية والأوغاريتية كما تُهمل أيضاً الآداب العالمية الحديثة؟ ألم نسام من الإزدواجية اللغوية بين المحكية والمكتوبة، المحكية التي نظرت لها القومية العربية على أنها مسخ، والمكتوبة التي لم تعبر يوماً إلا عن أحلام النحويين ومؤلفي القواميس؟ ألم نسأم من فرض القومية العربية على السوريين من غير الإنتماء العربي؟ ألم نسام من “أمة خالدة” و”خير أمة أخرجت للناس” لكنها لا تستطيع أن تعيش مع بعضها البعض وأن تعترف بوجود الآخر الجار المختلف ضمنها؟
لم تتجذر الليبرالية كأيديولوجيا في سوريا رغم أن أسس دولة الإنتداب ودولة الإستقلال ليبرالية تؤمن بالقانون والنظام البرلماني والأحزاب وتداول السلطة والنظام الإقتصادي الرأسمالي. لم يُقيّض لهذه التجربة أن تفرز فكراً يعبر عنها أو أن تعيش لفترة طويلة لتطوّر أفكارها ومؤسساتها، إذ سرعان ما قضت عليها الأيديولوجيات الإشتراكية والقومية. لسنا بصدد الحكم على هذه التجربة الآن وندع ذلك للابحاث التاريخية المستقبلية البعيدة عن الأيديولوجيا الإشتراكية التي وصمتها بالإقطاعية المدينية والرأسمالية الزراعية والبرجوازية الصناعية الفاشلة، وعن الأيديولوجيا القومية التي ألقت على عاتقها ذنب ضياع فلسطين وتدخل الدول الكبرى في شؤون المنطقة خلال الحرب الباردة في الأربعينات والخمسينات. وعلى الرغم من أن ستينات البعث اليساري والبعث العسكري لم تثمر إلا عن تأميمات عشوائية ودولة عسكرية قمعية وحكم الحزب الواحد ورئاسة طائفية ديكتاتورية، إلا ان موضوع الفترة الليبرالية في سوريا ما زال يثير النقاشات الحادة والمفرّقة والتي لسنا بحاجة إليها الآن لأن التاريخ تجاوزها ويجب علينا أيضاً أن نتجاوزها، فسوريا اليو تختلف اختلافاً شاسعاً عن سوريا ما بعد الإستقالا كما تختلف سوريا ما بعد اندلاع الثورة عن سوريا ما قبلها.
ورغم أن الإشتراكية الغربية أسالت بحوراً من الحبر في الفلسفة والأدب وعلم الإجتماع والمقالة إلا أنها لم تُنتج أدبيات تستحق الذكر في اللغة العربية وحتى الأدبيات الإشتراكية الغربية لم تطلع عليها إلا النخبة القلية جداً من السوريين الملتزمين بالإتجاه الإشتراكي. الأحزاب الشيوعية بقيت احزاب أقليات دينية وقومية والأحزاب الإشتراكية لم تخرج من قوقعة ما يسمى بالإشتراكية العربية التي تخرج عن كونها أحلام طبقة متوسطة ناشئة ذات أصول ريفية أو مدينية فقيرة لا تملك فلسفة خاصة ولا تحلم بأكثر من تأميم بعض المصانع والأراضي الزراعية دون أن توزعها على أحد وإن وزعتها فرضت حداً أعلى على الملكية الزراعية أدى إلى إشتراكية الملاكين الزراعيين الصغار وإلى تذرر الأرض الزراعية بسبب التوريث وضياع مفهوم الملكية الخاصية بدعوى أن “الأرض لمن يعمل بها”. وهذه الأحزاب كلها لم تخرُج عن النموذج الروسي الستاليني الذي أنتج ديكتاتوريات القائد الملهم والحزب الواحد ودولة المحسوبيات والمافيات الأمنية.
أما الأحزاب الإسلامية فهي كغيرها من الأحزاب الأيديولوجيا صاحبة الحقيقة المطلقة والأحقية في الحكم والتفويض المطلق (أو الإلهي أو الشعبي)، فإنها أخطأت ورفضت كغيرها أن تلقي نظرة نقدية على تاريخها منذ نشات. لقد قدمت هذه الأحزاب نفسها على أنها أحزاب الأصالة التاريخية، والهوية الإسلامية الجامعة التي تعلو على أية هوية قومية، والشريعة الإلهية التي تحكم باسم الله وليس باسم الشعب. فمثلاً ما يزال الإخوان المسلمون، وهم الجماعة الإسلامية الأهم في الوطن العربي إلى اليوم، لا يزالوا يرددون علينا ادعاءهم بأنهم “جماعةٌ من المسلمين وليسوا جماعةَ المسلمين” ولسان حاله وتصرفاته تقول نحن الإسلام الحق (إسلام الدين والدولة، والدنيا والآخرة) وصوت الأغلبية ويد الله على الأرض وولاية الفقهاء الذين هم ورثة الأنبياء. يعتمدون النظام البرلماني ويطالبون بالخلافة (التي لا تعدو كونها ملكية شرعية)، ويطالبون بالإنتخاب ويعتقدون أن الأغلبية هي أغلبية الدين، ويؤمنون بدولة القانون مادام قانون الإله وليس صنيعة يد الإنسان، ويؤمنون بالحرية وفردية المسؤولية أمام الله (لا تزر وازرة وزر أخرى) لكن لا يجدون حرجاً في فرض الصلاة والصيام والحجاب وفصل الجنسين في الفضاء العام، ويحترمون حقوق الأقليات ماداموا أهل ذمة كالأطفال القصّر، ويؤمنون بالملكية الخاصة بما فيها ما ملكت أيمانكم، ويعارضون الفائدة ويقبلون بالمرابحة وهي فائدة مبطنة. ويؤمنون بحرية التعبير ويكفرون ويقتلون بالكفر. واليوم يأتي السلفيون ليقولوا العلمانية هي فصل للدين عن الإنسان (ما لم تقله حتى العلمانية الفرنسية المتشددة) وكفر صراح، والديمقراطية ديكتاتورية الأغلبية ويعنون الأغلبية السنية، والبرلمانية كفر لأنها ليست شورى، والجهاز التشريعي تعدٍ على حاكمية الله، و”طاعة الله ورسوله وأولي الأمر” تعني الدولة الإسلامية على نموذجهم، والإسلام حل لكل معضلة إقتصادية أو إجتماعية أو نفسية إذ يكفي أن يؤمن الناس ويطيعوا الشريعة (بقوة الدولة لا بإرادتهم وخيارهم) حتى يفتح الله علينا ابواب الإزدهار والسعادة والتمكين، وأشد التناقض هو رفض الغرب والتبعية له ومع ذلك الدعاء بالتمكين للمسلمين في الأرض كما في الأيام الخوالي حين “كنا سادة العالم نسوسهم بكلمة الله وسنة نبيه.”
هذا نقد غاضب لكنه يجانب الصواب في كثير من النقاط التي أثارها. ولا نريد بذلك أن نذم التجارب الماضية لغرض إبراز النفس وتبييض الوجه بتسويد الوجوه الأخرى، فهذه التجارب هي مدرستنا من خلال نقدها والبناء على ما تعلمناها منها، من نجاحاتها وفشلها. وإنما الغرض هو استخلاص بعض النتائج التي نعتبرها أساساً صالحاً لبرنامج سياسي جديد قد يكون بذرة لأيديولوجيا جديدة. ونجمع هذه النتائج في الوثيقة التالية التي نسميها “وثيقة المبادئ” والتي هي منطلقات عامة ثابتة يمشي الحزب على ضوئها وتكون بمثابة الأساس الذي يقود الأهداف المرحلية والبرنامج العام وأيديولوجية الحزب.
تابعونا على صفحات وسائط التواصل الإجتماعي: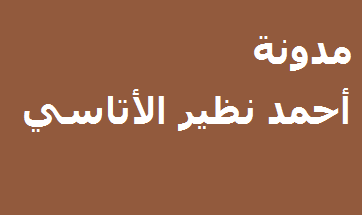




 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات