في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر ودوره في الثورة السورية

ظهر المقال على موقع المجلة الدولية لدراسات الثورة السورية في 13 أكتوبر، 2012
للمصطلحات قوة تشبه قوة الأفكار أحياناً لأن الناس في الغالب لا تتخطى معنى التسمية في سعيها لمعرفة المسميات التي وراء الكلمة سواءاً كانت أفكاراً أم أفعالاً. اليوم أصبح تداول مصطلح العلمانية بمعنى الإلحاد أو رفض الدين شائعاً. وقد كان منذ عشرة سنوات خار ج الساحة اللغوية للعمل السياسي أو الأيديولوجي في سوريا أو حتى في الوطن العربي. واليوم أيضاً، وبعد سنوات االقاعدة ومابعد الحادي عشر من أيلول، أصبح مصطلح الإسلامي أو الإسلاموي مرادفاً للإرهاب والتطرف. لذلك لا بد في البداية من توطيد تعريف لمصطلحاتنا التي سنستخدمها. أولاً، هل هناك فكر إسلامي سياسي؟ نعم وهو غالباً ما كان يدور حول مفهوم الخلافة ودور الخليفة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للدين. ولاحقاً دخلت الشريعة كبديل عن الخلافة وأصبحت شرعية الحاكم تنبع من إستخدامه لفقهاء في القضاء بغرض تطبيق هذه الشريعة وجعلها قانوناً للدولة. التطور الأخير بدأ في عهد حكم المماليك وتوطد في عهد العثمانيين. ثانياً، هل هناك فكر إسلامي سياسي معاصر؟ نعم، وهو غالباً ما يدور حول كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسات الدولة الحديثة التي أنتجتها أوروبا وفرضتها على العالم أجمع. اليوم يعود مفهوم الخلافة ليحتل الصدارة في هذا الفكر بالإضافة إلى مفهوم الجهاد كوسيلة لإقامة الخلافة. هل وصف إسلامي يجعل هذا الفكر جزءاً من الدين نفسه؟ في الحقيقة، الدين ينبع من النصوص وتفاسيرها ويتطور باستمرار وفق العلاقة الديناميكية بين الإثنين. فالتفاسير تخلق نصوصاً جديدة تحتاج لاحقاً إلى تفاسير وشروحات وتعود الحلقة للعمل من جديد. هذه التفاسيرالتي تتحول إلى نصوص شبه مقدسة تحوي على صياغة جديدة للدين. هذه الصياغة، إن نجحت في توطيد وجودها، تتحول إلى الدين نفسه وتتطابق معه. الدين سيرورة متغيرة كأي شيء في المجتمع البشري.
إذن باعتقادي أن الفكر السياسي الحديث الذي يعتمد على نصوص إسلامية أقدم سواءاً كانت نصوصاً أولية أم لاحقة اكتسبت مع الزمن صفة القداسة أو شبه القداسة هو فكر إسلامي ويكوّن جزءاً من الدين الإسلامي في سيرورة تطوره. طبعاً قد تكون هناك صياغات متعددة تتعايش أو تتصارع مع بعضها البعض في فترة زمنية واحدة. فمثلاً الصياغات الشيعية والسنية والصوفية تتعايش وتتصارع منذ القرن الثالث الهجري/العاشر الميلادي. والصياغة الشيعية تحوي عدة صياغات جزئية وكذلك الصياغتان الأخريان. الصياغة الحنفية تعايشت لزمن طويل مع الصياغات الحنبلية والشافعية والمالكية. وحدث أن وجد بعضها أرضاً حكراً عليه كالصياغة المالكية في المغرب، كما حدث أن تعايشت صياغات كالشافعية والحنفية في الدول العثمانية بعد أن طغت الحنفية على الأولى مع مجيء العثمانيين باعتبار ان العثمانيين فضلوا المذهب الحنفي. كما كان للصياغات الصوفية المتعددة وجود هام، خاصة عندما اعترفت الصوفية بدور الشريعة الإسلامية في تنظيم المجتمع. ما يهمنا في هذه المقالة هو الصياغات الحديثة للدين الإسلامي التي تتمسك بمقولة “الإسلام دين ودولة” وتعتقد أحياناً ان لا وجود للإسلام دون الدولة الإسلامية، أو هو على الأقل وجود منقوص. سنفصل أدناه هذه الصياغات، وسنبحث أيضاً عن دورها الحالي والمستقبلي في الثورة السورية. هذه الصياغات المعاصرة للإسلام تحتوي على ثلاثة مكونات تجتمع في أية صياغة على الساحة بنسب مختلفة: أولاً هناك المكون السلفي، وثانياً هناك مكون الدولة الإسلامية، وثالثاً هناك مكون الجهاد.
مكون السلفية
السلفية باختصار وكما أفهمها هي إتّباع منهج “السلف الصالح” في الحياة بشكل عام. و”السلف الصالح” يشمل النبي وأصحابه وبعضاً من التابعين. ويزيد عليهم آخرون بعض من يعتبرونهم “مجددين للدين” كإبن حنبل وإبن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. لا تقتصر السلفية على المذاهب السنية بل تشمل مذاهب فكرية متعددة تعتقد كلها بان الماضي يحمل في طياته عصراً ذهبياً تجب العودة إليه. شهدت أوروبا في العصور الوسطى المتأخرة سلفية تمثلت باتباع المنهاج الرسولي في الحياة والقائم على الفقر والعزوبة وتكريس الحياة لعبادة الرب، وكانت الرهبنة الظاهرة الإجتماعية المعبرة عن هذه السلفية. وكذلك شهدت أوروبا في عصر النهضة سلفية من نوع آخر هي السلفية الكلاسيكية التي اعتبرت العصرين الإغريقي الأول والروماني الأول عصوراً ذهبية يجب الإقتداء بها. وبعد عصر النهضة بقليل جاءت الحركات البروتستانتية بسلفية دينية تعتمد على كتب العهد القديم أكثر من اعتمادها على كتب العهد الجديد. السلفية الأوروبية الكلاسيكية طوّرت النظام الجمهوري الروماني في الحكم بدمجه مع البرلمانية التي هي وليدة العصور الوسطى. أما السلفية البروتستانتية فلم تتمخض إلا عن بعض الأنظمة الثيوقراطية. السلفية تعريفاً حركة فكرية تنظر إلى الوراء بدل المستقبل وتعتمد على النص التاريخي بدل الإعتماد على الإبداع العقلي. بالطبع لا تستطيع أية سلفية إعادة الماضي كما كان عليه وكل ما يمكنها هو إعادة إختراعه بناءاً على تفسيرات معاصرة للنصوص المقدسة والتاريخية. إن مرونة السلفية وإبداعها يتوقفان على الصياغة التي تعطيها للرواية التاريخية وعلى العوامل الأخرى المعاصرة التي تخلطها مع الرواية التاريخية. السلفية الإسلامية الحالية في إعادة اختراعها للباس “السلف الصالح” ولهيئتهم (الثوب القصير واللحية الشعثاء والشارب المحفوف) لا تبدو شديدة الإبداع من الناحية الفنية على الأقل. أما من ناحية الفكر الإجتماعي فليست بأحسن حالاً من السلفية البروتستانتية التي ظهرت مع حركة الإصلاح اللوثرية في ألمانيا وامتدت إلى بقية أوروبا. إنه فكر محافظ أبوي يضع الكتب المقدسة في مصافي القوانين الكونية ويقوم على ضبط المعاملات الإجتماعية داخل الأسرة وفي الفضاء العام ضبطاً محكماً يستعين بسلطة الدولة حيناً كما في ثيوقراطية مدينة جنيفا الكالفينية أو في ثيوقراطية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية. الملاحظ ان المذهب الشيعي لم يُطوّر صياغة سلفية في العصر الحديث وذلك بسبب غلبة “الأصوليين” على “الإخباريين” في القرن السابع عشر. “الأصوليون” اعتقدوا بان من الواجب على المؤمنين اتباع تعاليم المعلم (أو المرجع) الحي بدل استرجاع وتأبيد تعاليم المعلمين السابقين كما كان موقف “الإخباريين”. في الحالتين، التشيع يركز على اتباع تعاليم المؤسسة الدينية كوسيلة للخلاص لكن كان الخلاف على التركيز على الحاضر والمستقبل بدل التركيز على الماضي. لكن دخول المرجعيات الدينية في العراك السياسي أدى إلى نشوء فلسفة “ولاية الفقيه” والتي هي تطوير “للأصولية” السابقة الذكر بحيث تصبح نظاماً سياسياً يستلم فيه الفقهاء الأحياء الحكم كما هو الحال في إيران اليوم. الإتجاه الأخلاقي للسلفية المعاصرة قد يكون من عوامل جاذبيتها لانها لا تهادن في المبادئ الأخلاقية. لكن فلسفتها الأخلاقية كما أسلفت تركز على ضبط العلاقات الإجتماعية عن طريق تدعيم قوامة الرجل، والتاكيد على الإلتزام الشديد بالمبادئ، والطهرانية (أي نبذ بعض “مغريات الحياة الحديثة” مثل التدخين والغناء)، والفصل بين الجنسين، وتقييد جسد المرأة وحركتها في الفضاء الخارجي، وأخيراً جعل “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” واجباً قد يُحشَر أحياناً في مؤسسات تتقوى بسلطة الدولة. بالنسبة للنموذج الغربي السائد حول العالم والذي نشره الغرب إما عن طريق التوسع الإستعماري أو عن طريق التوسع الإقتصادي، فإن السلفية كفلسفة أخلاقية تبدو “رجعية ومتخلفة وظلامية”. هذه الصفات لا يمكن تعريفها وتحديدها إلا باستجلاب الصياغة الأوروبية للعلاقات الإجتماعية التي أنتجها عصر التنوير في القرن الثامن عشر وطورها في القرن التاسع عشر والقائمة على الليبرالية الإجتماعية، ومفهوم التغيير بالتقدم ونبذ العادات والتقاليد بما فيها الدين والمؤسسة الدينية، ومفهوم الحداثة بالتنوير النقدي الفكري والتطور الإقتصادي الرأسمالي.
أولاً وبغض النظر عن آرائي الشخصية عن السلفية فإني أتخوّف
من أية أيديولوجيا يتبناها مسلحون. وينطبق هذا على مكون الدولة الإسلامية أيضاً،
وكذلك على أية أيديولوجيا دينية أو علمانية (شيوعية أو ليبرالية مثلاً) تتبنى
العنف أو يتبناها الممارسون للعنف. إن من مخلفات اليسار الثوري من أواسط القرن
التاسع عشر إلى ستينات القرن العشرين إلحاق التغيير بالعنف، بحيث أصبح مفهوم
الثورة لا ينفصل عن مفهوم كسر قبضة الأيديولوجيا القديمة وفرض الأيديولوجيا
الجديدة بالعنف. هذا العنف كمحرك ثوري للتغيير تبنته بعض الصياغات الفكرية
الإسلامية، خاصة في فكر السيد قطب والجماعات الإسلامية، وحالياً الجهاديين
المحليين والعالميين. الثورة السورية لجأت إلى العنف مكرهة لكن العنف يبقى هو نفسه،
وهو يسيطر دائماً على عقل ممارسيه مهما أسبغنا عليهم من أخلاق مثالية بدعوى
إيمانهم بأيديولوجيا سامية تعينهم على ضبط تصرفاتهم وأهوائهم وتطلعاتهم. عنف
الثورة السورية في بدايته لم يكن مقترناً بأية أيديولوجية جامعة، وإنما اعتمد على
ردود أفعال أهلية على القتل العشوائي والعنف الهمجي الذي اتبعه النظام كوسيلة للرد
على الثورة السلمية. لكن اليوم، من الواضح أن كثيراً من فصائل الثورة المقاتلة قد
تبنت أيديولوجيا ثورية، سلفية في تصورها للتغيير الإجتماعي، وثيوقراطية (أو على
الأقل تعتمد على ولاية رجال الدين أو وصايتهم) في تصورها للدولة القادمة. هذا
المنحى مقلق وأحيان مخيف. وليس هذا ردة فعل علمانية “غريزية” وإنما
إقتناع بان ما ياتي بالعنف لن يكون إلا إقصائياً يستخدم “الشرعية
الثورية” (أي أحقية وأولوية المقاتلين) لاصطفاء الأعوان ووضعهم في مراكز
القوة. وسأقول الشيء نفسه لو اختار المقاتلون الشيوعية أو الليبرالية الاوروبية أو
القومية العربية. أتمنى لو يبقى الفضاء المسلح خالياً إلا من أيديولوجية الدفاع عن
الوطن والأهل والممتلكات وإقامة السلام الذي في ربوعه يمكن لكل الأيديولوجيات أن
تتنافس وان تحصل على تكافؤ في الفرص بدل ان تكون الفرص السياسية كلها للايديولوجيا
التي جاءت على أفواه البنادق. إني أتمنى لو تتجمع الفصائل المقاتلة تحت قيادة
واحدة سياسية وعسكرية تجعل منها جيشاً وطنياً لجميع السوريين حتى الذين لم يشتركوا
بالثورة أو الذين والوا النظام، إذ ليس من المعقول تصفيتهم جسدياً عن بكرة أبيهم.
الصفة الوحيدة التي يجب أن تُطلق على الفصائل المقاتلة هي صفة الوطنية وليس
السلفية أو الجهادية أو الإسلامية أو الليبرالية او القومية أو أية صفة أخرى تتأتى
من تبني أيديولوجيا معينة. تعلمنا من تجربتنا المريرة مع نظام البعث بصيغه
المختلفة أن الجيش العقائدي لا يمكن أن يكون إلا جيش النظام وليس جيش الوطن، وحامي
النظام وليس حامي الوطن. وأعتقد أن تبني المسلحين لأية ايديولوجيا سيجعلهم مستقبلاً
شبيهين بالجيش العقائدي الذي يناضلون ضده الآن. على الأقل على الفصائل المقاتلة أن
تنشئ في أية منطقة محررة إدارة مدنية لا تاتمر بأوامر المسلحين وان تسمح بنشوء
مجموعات سياسية تضع تصوراتها للمرحلة المقبلة ضمن نظام تعددي يقبل بالإختلاف.
لست في معرض كيل النقد والتجريح للسلفية وإنما أريد تقييم جدواها كأيديولوجيا
ثورية تغييرية صالحة لمرحلة الثورة السورية. بالنسبة لي السلفية كأيديولوجيا
إجتماعية تفرضها فصائل مسلحة مرفوضة. وعلى معتنقي هذه الأيدولوجيا أن ينتظروا كما
ينتظر الآخرون حتى يحل السلام وتبدأ المعارك السياسية التي نحن بأحوج ما نكون
إليها. نحتاج في هذه الثورة السورية إلى “ميثاق إرجاء” يتعهد فيه الجميع
1) بوضع الأيديولوجيات والدعوة لها بين المسلحين جانباً إلى ما بعد إحلال السلام،
2) بالإنخراط بالعمل الوطني السياسي وغيره بالتعاون مع أتباع ايديولوجيات أخرى من
أجل الوصول لوقف القمع وإحلال السلام المنشود، 3) بإرجاء التصويت على أية تعديلات
دستورية تتعلق بالامور الخلافية، سواءاً كانت مختصة بدور الدين في القانون أو
السياسة أو كانت مختصة بفرض نظام إقتصادي معين ليبرالي رأسمالي أو نظام سوق
إجتماعية مثلاً، إلى ما بعد ثلاث سنوات من إحلال السلام حتى يتسني للجميع عرض
مشاريعهم وأفكارهم والدعوة لها في جو سلمي لا يستقوي بسلطة السلاح أو بسلطة
الدولة. هل تمثل السلفية نظاماً إجتماعياً ثورياً؟ بالنسبة للمؤمنين بها طبعاً هي
أيديولوجية ثورية. لكني لا اعتقد أنها جذرية فهي لا تدعو إلى تغيير التركيبة
الإجتماعية وإنما إلى ضخ نوع من الأخلاقيات بالإعتماد على المؤسسة الدينية أو
مؤسسات المجتمع المدني. قد لا تناسبني هذه الأخلاقيات لكني أعترف بحقها بالوجود
والدعوة والتوسع بالطرق السلمية. وأتمنى لو يطور السلفيون 1) موقفهم من لباس
المرأة والقيود المفروضة على وجودها في الفضاء العام (تعليم، شغل، تنقل)، 2)
موقفهم من التكافل الإجتماعي بحيث يعتمد أكثر على تدخل الدولة بدل الإستناد كلياً
وحصرياً إلى مؤسسة الزكاة والصدقة في الإسلام، 3) موقفهم من “الأمر بالمعروف
والنهي على المنكر” بحيث تعتمد على مؤسسات المجتمع المدني، الدينية منها
خاصة، بدل الإعتماد على سلطة القانون والدولة. إني من أنصار تحويل الثورة السورية
إلى ثورة شاملة إجتماعية وإقتصادية وسياسية. واعتقد أن هذا سيكون من عوامل نجاحها
وتفوقها وجعلها مثالاً يحتذى. لكني أفضّل إقتصار العمل في هذه المجالات على
المدنيين وغير المسلحين.
مكون الدولة الإسلامية
كما أسلفت فإن إهتمام الإسلام بالسياسة يعود إلى عصر التأسيس، أي إلى عصر التجربة المحمدية. يختلف الناس والباحثون في إعطاء صفة الدولة على الجماعة الإسلامية الأولى. بالتأكد هي لم تكن دولة معقدة وهرمية ومؤسساتية على غرار الإمبرطوريتين المعاصرتين الفارسية والبيزنطية، لكن لا أعتقد أن الخلاف هو على تعقيد هذه الدولة وإنما على صفتها كدولة. فإذا كانت الدولة إحدى أهداف الدعوة المحمدية فإن الدولة الإسلامية موجودة مفاهيمياً وواقعياً لا بل هي واجب إسلامي لا يصح الدين دون وجودها. وإذا نفينا صفة الدولة عن الجماعة الأولى وتنظيمها فإن مفهوم الدولة الإسلامية يعتبر مفهوماً متأخراً ظهر بعد المرحلة المحمدية ويمكن بالتالي المجادلة في أهميته للرسالة المحمدية أو عدمها. إن انخراط أول الخلفاء في حروب الردة والتي هي فعلاً حروب سياسية اكثر منها دينية، وموت إثنين من الاربعة الأوائل في معارك سياسية أيضاً يدل على أهمية موقع الدولة بالنسبة للجماعة الإسلامية الناشئة. وما الفتنة الكبرى وما تلاها من الفتن إلا معارك سياسية غرضها فرض رؤية معينة لقيادة الجماعة الإسلامية فكانت هناك رؤية الأحقية بالسابقة وكانت هناك رؤية الأحقية بالإنتماء العائلي. ثم فرضت الرؤية الملكية الوراثية نفسها على الجميع فنشات الخلافة الإسلامية من خلال صراع لم يُحسم في تلك الايام ولا يزال بعيداً عن أن يُحسم الآن.
من السهل إقناع أي مجادل بأن الخلافات الراشدية والأموية والعباسية وحتى العثمانية قائمة على مبادئ مشتركة وُضعت أسسها في المرحلة المحمدية. لكن يبقى للتجربة الراشدية بريقها الخاص، وهي موضوع الجدال الذي استمر لعدة قرون وساعد في بلورة الصياغتين الإسلاميتين الرئيسيتين في العالم، وأعني الصياغة السنية والصياغة الشيعية. في العصر الحديث لم يجد المسلمون في تاريخهم الطويل أية مرحلة يمكن أن تكتسب شرعية دينية وأخلاقية أكثر من مرحلة الراشدين. ولذلك أضفيت صفات مثالية على هذه المرحلة جعلت من الصحابة أصحاب سنن تحتذى، ونقلة ثقات للتراث النبوي، وشارحين حتى للرسالة المحمدية وكتابها الإلهي وشريعتها. وقد برز التركيز على هذه المرحلة منذ القرن الثاني الميلادي بسبب حركة تدوين الحديث ونشوء المذاهب الفقهية التي انتهت باعتبار الحديث مصدرها التشريعي الثاني بعد القرآن. وهذه الصياغة هي ما نسميها بالصياغة السنية للدين الإسلامي. في العصر الحالي ومع ظهور السلفية كمشروع إصلاحي أخلاقي وكردة فعل أيضاً على اتهامات الغرب الأقوى للمسلمين الاضعف بقصور دينهم عن اللحاق بركب الحضارة الغربية القلب والقالب، لكن العالمية الإنتشار، عادت الحاجة إلى عصر الراشدين ببريقه الأخلاقي وإبداعه الإداري وثقته بنفسه ورسالته وقربه من الرسالة الاصلية وحتى تكملته لها أو اعتباره استمراراً صحيحاً لها. ونرى ذلك واضحاً في مراسلات الفيلسوف الفرنسي رينان مع المصلح جمال الدين الأفغاني كما نراه في كتابات العديد من المصلحين في تلك الفترة. إن اعتبار المرحلة الراشدية تكملة للمرحلة المحمدية جعل الدولة الراشدية الأعقد بمؤسساتها تطويراً لدولة محمدية أصبح وجودها مثبتاً بإسقاط رجعي من المرحلة الراشدية وخيار ذهبيتها. وبذلك أصبحت الدولة الإسلامية التي يرأسها خليفة، سُمي أحياناً خليفة رسول الله وأحياناً خليفة الله، شرطاً من شروط وجود الدين الإسلامي. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن دين المسلم لا يصح إلا في دولة تخضع للشريعة ويقودها خليفة (ويسمى أيضاً إماماً أو أمير المؤمنين). وليس الامر مجادلة فكرية فقط بل تم طرح الفكرة على أرض الواقع خلال ولاية السلطان عبد الحميد الثاني الذي نادى بخلافته على جميع المسلمين كوسيلة لجمع المسلمين في كل أنحاء الأرض حول قيادته (الجامعة الإسلامية) في مواجهة الضغوطات الغربية الدائمة التي كان يتعرض لها، وأيضاً في مواجهة التيار العلماني في إدارة الإمبراطورية الذي بدأ مع القضاء على الإنكشارية وتأسيس قوات “النظام الجديد” على الطريقة الأوروبية وفرض فرمانات “التنظيمات” الشهيرة التي أبعدت عن البيروقراطية العثمانية رجال الدين وخريجي المدارس الإسلامية المعروفة. طبعاً حزب الإتحاد والترقي وليس الغرب هو الذي قضى على حكم عبد الحميد ومن بعده على الخلافة العثمانية. هذا الحزب ومنهجه كان استمراراً لفترة التنظيمات في لباس برلماني دستوري وتطرف إداري علماني وشوفينية طورانية مقرونة مع ديكتاتورية عسكرية. لم يمض وقت طويل على إلغاء الخلافة العثمانية عام 1923 حتى برز إلى الوجود تيار الإخوان المسلمين الذي أعاد إلى الساحة السياسية مبدأ السلطان عبد الحميد القاضي بان “الإسلام دين ودولة”.
إن مفهوم الدولة الإسلامية كان يعتمل في أذهان الكثيرين. فالصياغة التي قدمها الفقهاء للخلافة في العصور الوسطى كانت تقوم على تعاون بين الخليفة كقائد للأمة ومدافع عنها ومدير لشؤونها وبين المؤسسة الدينية كحاملة للشرع الإسلامي وعاملة به عن طريق قضاتها ومفتيها ومحاكمها الشرعية. تابع العثمانيون هذه التوليفة فقدموا أنفسهم كغزاة ومجاهدين في سبيل الإسلام (وفي أحيان أقل كخلفاء) ومطبقين لشريعة الإسلام وعدالته عن طريق ضم المؤسسة الدينية المؤلفة من مجموعة مترابطة من العلماء إلى كيان الدولة، فاعطيت لهذه المؤسسة هرمية أشبه بالهرمية الكنسية وتم الإعتماد عليها في كل أنحاء البيروقراطية العثمانية. إن الصياغة التي قدمها الإخوان المسلمون مشابهة للصياغة الأخيرة التي قدمها السلطان عبد الحميد، لكن مع قبول بالواقع المصري. لقد قبل مؤسس الإخوان المسلمين بالملكية البرلمانية التي فرضها الإنكليز على مصر وقبلوا بالإعتراف بالخديوي كقائد وبالعملية السياسية البرلمانية كوسيلة للوصول إلى الحكم (أي البرلمان على الطريقة الإنكليزية). وإن الطروحات المعاصرة للدولة الإسلامية تتراوح بين هاتين الصياغتين: 1) العمل ضمن دولة برلمانية غربية الشكل مع وصاية العلماء على القضاء والسلطة التشريعية، 2) وجود ملك-خليفة يستلم السلطة التنفيذية بينما يضطلع العلماء بالسلطيتن التشريعية والقضائية وبمهمة إستشارية تجاه الخليفة. دعونا نسمي الصياغة الأولى بالنظام البرلماني الإسلامي والثانية بالنظام الخلافتلي. لكن كلتا الصياغتين تفترض القبول بمجتمع يخضع لمؤسسات بيروقراطية إدارية غربية المنشا ويستهلك كل المنتجات الغربية الحديثة الفكرية والصناعية ويعالج المفاهيم الغربية عن الحرية والمواطنة وحقوق الإنسان والتي أصبحت مفاهيم عالمية الآن. الإخوان المسلمون يؤمنون بان البرلمانية ليست إلا وسيلة للوصول إلى المجتمع الإسلامي الفاضل. وأعتقد أن هناك إفتراض مبطن بأن هذا المجتمع الفاضل سيتحول بشكل تلقائي إلى النظام الخلافتلي فبذلك يلتقي النظامان. بعض الإخوان المسلمين وخاصة في سوريا تحولوا إلى العنف الثوري. لكن العنف كوسيلة للتغيير والإتجاه نحو الدولة الإسلامية أصبح الوسيلة المفضلة للعديد من الجماعات الجهادية التي تعتقد أن الإخوان المسلمين مجرد ممالئين للواقع المفروض وقابلين بالجاهلية الحديثة التي أصبح وجودها والعداء لها من أسس تفكير المجموعات الجهادية.
في الحقيقة فإن كلتا الصياغتين للدولة الإسلامية لا يمكن اعتبارهما صياغات ثورية تجديدية فهي إما تعتمد على مؤسسات الدولة الغربية الحديثة التي لم تخترعها، أو تعتمد على صياغة قروسطية-عثمانية لعلاقة الملك بالشريعة الإسلامية. أي أن هذه الدولة الإسلامية هي إما دولة قروسطية ملكية مع وصاية لرجال الدين على التشريع والقضاء، أو دولة برلمانية على النمط الغربي لا تختلف عن مثيلاتها في الدول الأخرى إلا ببعض التسميات “الإسلامية” لبعض المؤسسات حيث يصبح الرئيس إماماً أو أميراً، ووزارة الداخلية إدارة العسس، ووزارة الحربية ديوان الجند، ووزارة المالية بيت مال المسلمين، ووزارة العدلية ديوام المظالم، ومصلحة الضرائب ديوان الزكاة والصدقات. ومع إحترام العديد من الدول الحديثة للشريعة الإسلامية في قانون الاحوال الشخصية (رغم أنه لا توجد صبغة يمكن نعتها بالإسلامية في القانون الجنائي أو التجاري أو الإداري). ولذلك فإن هذه الدول، إذا كان رئيسها مسلماً، تُعتبر إسلامية حسب النظام البرلماني الإسلامي. في هذا النظام بشكله المثالي يكون لرجال الدين وصاية على جميع مفاصل الدولة والإقتصاد والتعليم كمراقبين لإسلامية القوانين والمعاملات ومستشارين للرئيس-الإمام، مما يجعل الدولة بهذه الصياغة “وصاية للفقيه” قد تتحول مع الزمن إلى “ولاية للفقيه”. وقد تدخل بعض الطهرانية السلفية في أي من هاتين الصياغتين لتُناقِضَ بين مايسمونه بالقانون الوضعي المتمثل بقانون الدولة الحديثة وبين القانون الإلهي للدولة الإسلامية لتصبح بذلك هذه الدولة مجرد ثيوقراطية للنص المقدس باعتباره كلام الرب تشرحه وتطبقه وتكون وصية عليه مؤسسة من المفتين والقضاة، مما يجعل الدولة أيضاً ولاية للفقيه باعتباره ممثل الإله على الأرض.
إن تبني الثورة السورية، وخاصة فصائلها المسلحة، لمفهوم الدولة الإسلامية لا يعِد بتغيير جذري في نظم الإدارة وهيكلية الدولة وهو أقرب إلى النظام الإسلامي البرلماني منه إلى النظام الخلافتلي الذي تنادي به أقلية من الفصائل. فالدولة الإسلامية بصياغتيها هي إما مجرد ملكية قروسطية أو مجرد دولة حديثة يسيطر فيها متدينون وفقهاء على مقاليد الحكم. يبدو لي أن مفهوم الدولة الإسلامية ليس تجديداً إدارياً (الليبرالية السياسية كانت تجديداً على الملكية الاوروبية، الشيوعية كانت تغييراً للديمقراطية الليبرالية) ولا تجديداً في نظام الحكم ولا تجديداً في السياسة الإقتصادية للدولة، وإنما إشتراطاً لإسلامية الإداريين والسياسيين بحيث تنبع شرعيتهم ليس من خدمتهم للشعب من خلال الدولة وإنما من إلتزامهم بمظهر إسلامي للدولة (لباس، فصل بين الجنسين، تطبيق لحدود شرعية غير ذات أهمية بالغة في إدارة أية دولة مثل حد السرقة وحد شرب الخمر وحد الزنى). الدولة الإسلامية بصياغتها الحالية مجرد سياسة إنتخابية لبناء شرعية للمرشحين وضمان إنتخابهم. ولذلك فإني أدعو مفكري التيارات الإسلامية المؤمنين بأن الثورة السورية إسلامية أو يجب عليها ان تكون إسلامية إلى تطوير مفهوم هذه الدولة البرلمانية والقبول بأن بيروقراطية هذه الدولة ستكون على النمط الغربي الذي اثبت جدواه. كما أدعوهم لتطوير وتفصيل العملية السياسية (تعيين الإداريين والقادة) بحيث تصبح أكثر من مجرد إنتخاب الإمام من قبل مجلس شورى واستغلال للمناصب لتعيين موالين في مواقع القيادة.
وهناك مكونان آخران هامان في الأيديولوجيات السياسية المسماة بالإسلامية وهما شعبويتها وعداؤها للنخب الإدارية العلمانية التي أدارت مؤسسات الدولة خاصة في سوريا منذ العهد الفيصلي لا بل منذ نهايات القرن التاسع عشر. هذه الشعبوية تحققها عن طريق ربط السياسة بمؤسسات المجتمع المدني فتتحول الجمعيات الخيرية إلى حملات إنتخابية وتتحول المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات دعوة سياسية وتتحول المؤسسات الدينية إلى منابر للمرشحين الإسلاميين. أما العداء للعلمانية وتحويل العلماني إلى عدو ديني مرادف للإلحاد فهو أولاً نتيجة لتهميش المؤسسة الدينية العثمانية في إدارة الدولة، وثانياً نتيجة للصراع على الحكم الذي دار منذ الخمسينات والذي انتهى لصالح فئات عسكرية تبنت واجهة سياسية قومية أو يسارية وأرسلت كل معارضيها إلى المعتقلات والمنافي بمافيهم اليساريين والإسلاميين على حد سواء. إن “مظلموية الإسلاميين” في ظل ما يعتبرونه حكومات “علمانية يسارية ملحدة” على حد تعبيرهم ليس إلا وسيلة أخرى لإضفاء الشرعية على الأحزاب الإسلامية وإبرازها بمظهر المستضعف صاحب الحق بالحكم والذي تم حرمانه منه غصباً.
إن تهميش المؤسسة الدينية العثمانية في إدارة الدولة ومن ثم في النخبة السياسية للدولة أدّى إلى عداوة مستحكمة بين الحداثيين العلمانيين (البيروقراطيين الجدد، القوميين، والمتعلمين في الغرب والمبهورين به) وبين بقايا محلية للمؤسسة الدينية متمثلة بخطباء وأئمة الجوامع وخريجي المدارس الدينية التي لم تعد النخب الإقتصادية والإجتماعية ترتادها فاقتصرت على أبناء الطبقات المتوسطة. لقد بدا هذا التناقض بين النخبة العلمانية والنخبة الدينية واضحاً في العهد الفيصلي وحتى في فترة الإنتداب الفرنسي. فحين سيطرت النخبة العلمانية على مفاصل النظام السياسي البرلماني الذي جلبه الغرب معه أو الذي جلبه حزب الإتحاد والترقي من قبله، تحولت النخب الدينية إلى الطبقات الشعبية واعتمدت خطاباً جمع بين العداء للغرب و”أعوانه العلمانيين” وبين التركيز على المؤسسات التعليمية والمساجد كمهن ومنابر للراغبين في لبس العمامة. إن الإتجاه الشعبي أوالشعبوي أحياناً للنخب الدينية في سوريا مثلاً واهتمامهم بالتعليم لا يزال واضحاً إلى الآن. ولذلك فعلى العلمانيين ان يتخلوا عن “تعاليهم” على النخب الدينية وحلفائها السياسيين من الأحزاب الإسلامية واعتبارهم بقايا “متخلفة من عهد بائد” أو “غوغاء جاهلة”. كما على النخب الدينية وحلفائها السياسيين أن يتخلوا عن الشعبوية التي تجعل منهم “متحديثين باسم الإله ومطبقين لشرعه” في أذهان العوام، مع استواء أحياناً بسلطة الغوغاء كقوة ضاربة موازية لقوة الدولة. إن عليهم إذا أرادوا استخدام الأدوات الغربية مثل البرلمان والبيروقراطية أن يعترفوا بأن هذا الشرع في اغلبه هو إجتهاد بشري وإن إبتدأ من نصوص مقدسة.
مكون الجهاد
في اعتقادي ليس هناك من أيديولوجيا إسلامية بحاجة لمراجعة وتجديد أكثر من أيديولوجيا الجهاد. كيف يمكن لمجتمع مسلم أن يتعايش مع مجتمعات أخرى أومكونات وطنية من أديان اخرى إذا كان الجهاد لنشر الإسلام فريضة، هذه الفريضة التي تذكرنا بها الجماعات الجهادية ليل نهار على أنها “الفريضة المنسية” التي لا يكتمل الإسلام إلا بها. تتعدد صياغات أيديولوجيا الجهاد فهناك صياغة سلمية تتمثيل بمجاهدة النفس في مواجهة الرذيلة والمغريات ومجاهدة النفس على عمل الخير. وهناك صياغة دفاعية تجعل من الجهاد فرض كفاية في حالة السلم وفرض عين في حالة تعرض المجتمع المسلم للإعتداء الخارجي. وهناك صياغة إمبراطورية توسعية تجعل من الجهاد فريضة على الدولة المسلمة وتجعل هدفها “إعلاء كلمة الله” بإخضاع الشعوب الأخرى لسلطة الإمام المسلم والشريعة الإسلامية. لقد سادت الصياغة الأولى في أوقات السلم ومع انتشار الطرق الصوفية. ثم استغلت حركات التحرير القومية الصياغة الثانية لتجييش الشعوب من أجل دحر المستعمر إذ لم تكن الايديولوجيات القومية كافية لذلك أو لان المكون الإسلامي أصبح بالنسبة لهم أحد أهم مكونات القومية. أما الصياغة الثالثة فهي للاسف صياغة الجهاديين، المحليين منهم والعالميين. وهذه الصياغة تقوم على استمراء القتل بدعوى إنتشار “الجاهلية الحديثة” بين المسلمين أو بدعوى “إخضاع المشركين الغربيين لشريعة الإسلام”. هذه الصياغة الثالثة تجد ما يدعمها في أدبيات الفتوحات سواءاً كانت الفتوحات الأولى أو الحروب ضد البيزنطيين او توسع العثمانيين في أوروبا او توسع قبائل الحوسة الإفريقية في بلدان ما دون الصحراء الكبرى. ولذلك أسميتها بالصياغة الإمبراطورية لأن هدفها هو بناء إمبراطورية يكون المسلمون فيها هم الطبقة العسكرية الحاكمة.
هذه الصياغة الثالثة شرّعت قتل المسلمين في عمليات تفجير غير مركزة بدعو كفرهم وجاهليتهم، كما شرّعت قتل غير المسلمين خاصة من الغربيين بدعوى شركهم و”صليبيتهم”، وجعلت من الشهادة غاية الجهاد بعد أن كانت نتيجة محتملة من نتائجه، ولذلك أسميتها بالصياغة الإستشهادية لفصلها عن الجهاد كمفهوم أعم وأعقد. لقد تحول الجهاد مع هذه الصياغة الثالثة إلى إرهاب عالمي قوامه مهاجرون مسلمون لم يستطيعوا التأقلم مع مجتمعاتهم الجديدة، وهدفه مهاجمة المواطنين الغربيين والسفارات الغربية أو مهاجمة التجمعات الشيعية. كما تحول هذا الجهاد الإستشهادي إلى عملية عشوائية تبدأ مع حمل السلاح “طلباً للشهادة” تحت أية إمرة ودون أي تخطيط مركزي، وتستمر بإطلاق النار على اي هدف يُعتبر “كافراً”، وتنتهي حتماً “بنيل الشهادة” دون تحقيق أي هدف استراتيجي ترسمه قيادة موحدة حكيمة هدفها البناء وليس الهدم والحياة وليس الموت.
وفي حالة الثورة السورية توجد الصياغات الثلاثة السالفة الذكر للجهاد. لكن تمكن ملاحظة بعض الدعوات لدفع الصياغة الثالثة إلى الواجهة. أدعو الكتاب والفقهاء، الإسلاميين منهم وغير الإسلاميين، إلى تطوير مفهوم الجهاد في الثورة السورية بحيث يقترن مع النضال من أجل الحرية من عبودية القمع والمخابرات، ومع النضال من أجل دولة لجميع المواطنين على اختلاف إنتماءاتهم الطائفية والسياسية، ومع النضال من أجل نظام سياسي يعطي فرصة التمثيل لجميع مكونات الشعب وفرصة المشاركة في الحكم لجميع المجموعات السياسية، ومن أجل نظام إقتصادي يؤمن تكافلاً إجتماعياً يضمن حياة كريمة للمعوقين والمرضى والمتقاعدين ويساعد العاطلين على إيجاد عمل أو خلق عمل. ولو انتصرت الثورة السورية بمفهوم الجهاد اتوسع الذي هو أيضاً قتال طائفي فإنها لن تنجح في تحقيق السلام المجتمعي ولن تفرز أكثر من دولة ديكتاتورية تدعي تمثيل الاغلبية وتحتقر الاقلية.
من خلال ما عرضناه من تصورنا للتاريخ الحديث للفكر السياسي الإسلامي فإننا ندعو إلى مراقبة وجوده في الثورة السورية حتى لا يتحول إلى عقيدة مقاتلين يفرضونه بقوة السلاح على الآخرين مدّعين الشرعية الثورية. كما ندعو لتطوير مفهوم السلفية لتقوية الوجه الأخلاقي له دون تحوله إلى مؤسسة طهرانية لضبط العلاقات الإجتماعية. كما ندعو لتطوير علاقة الدولة بالدين بحيث لا يتحول الدين إلى مجرد أداة لإضفاء الشرعية الدينية على مرشحين حزبيين، ولا تتحول الدولة إلى وصاية الفقيه أو ولاية الفقيه أو ثيقراطية النص. وندعو إلى تطوير المشروع الإداري والإقتصادي للأحزاب الإسلامية إذ لا نجد أية آثار له حالياً. واخيراً ندعو إلى تحويل الجهاد إلى أيديولوجية وطنية تناضل من أجل دولة الحرية والقانون والمساواة بدل ان تكون أيديولوجية تدميرية تسعى إلى الموت باساليب عشوائية ودون أهداف محددة. وسنسعى في مقالة قادمة للحديث عن الفكر العلماني المعاصر ودوره في الثورة السورية آملين بذلك إنصاف الجميع فوحدة الوطن وحريته هي القصد.
تابعونا على صفحات وسائط التواصل الإجتماعي: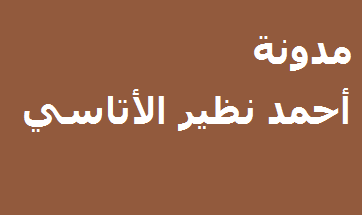




 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات