رصاصة الرحمة

ظهر المقال على موقع المجلة الدولية لدراسات الثورة السورية في 1 أكتوبر، 2012
هناك كلمات يصعب على الإنسان قولها حتى لو كلفته حياته لأنها تعني موت نمط من الثقافة والحياة. فالإنسان ليس جسداً فقط بل ثقافة وإذا ماتت هذه الثقافة في داخله تموت الروح وقد يموت الجسد بعدها أحياناً. لكن حتى تولد ثقافة جديدة قادرة على الحياة لا بد من قول الكلمات الصعبة وإطلاق رصاصة الرحمة على الثقافة القديمة التي تعيق الميلاد الجديد. لقد وصلت الثورة السورية إلى هذه المرحلة الصعبة، مرحلة الولادة الجديدة التي لا تكون إلا بموت الثقافة القديمة.
لما قامت الثورة السورية لم يكن في حسبان أحد أنها ستكون ثورة شاملة: لا في حسبان النظام ولا في حسبان الشباب المتظاهر ولا في حسبان الدول المجاورة أو الدول العظمى. ولا يزال الكثيرون من جميع الأطراف يعتقدون أنها مجرد تمرد مسلح أو ثورة دينية أو حرب طائفية. في الحقيقة، إن الثورة السورية على مفترق طرق فهي إما أن تكون تمرداً مسلحاً يموت خلاله ناس كثيرون دون تغيير واضح سياسي أو اجتماعي أو ثقافي، وإما ان تكون ولادة جديدة تعرّف القرن الواحد والعشرين كما عرّفت الثورة الفرنسية القرن التاسع عشر. إن الخط الفاصل بين هاتين الشعبتين في الطريق هو رصاصة الرحمة التي أتكلم عنها والتي لا بد من إطلاقها على ثقافة قديمة تحتضر من أجل أن تولد ثقافة جديدة أزهى وأقدر على الحياة.
هناك نواح كثيرة لابد من الحديث عنها. وكل ما كتبته وساكتبه لاحقاً يسعى في ذات المنحى ويقود إلى ذات النتيجة. لا بد من ولادة ثقافة جديد وموت ثقافة قديمة. عندما أتكلم عن أزمات الثورة أو عن انتصاراتها، عندما أتكلم عن سلمية الثورة أو عن تسليحها، عندما أتكلم عن أيديولوجية ثورية لاهوتية أو عن أيديولوجية مدنية، وعندما أتكلم عن مؤسسات الثورة أو انعدام وجود هذه المؤسسات، مهما قلت فالنتيجة واحدة: إذا أردنا حياة جديدة وإذا أردنا ثورة حقيقية فإنه يجب علينا أن نطلق رصاصة الرحمة على ثقافة أصبحت تكلفنا مئات لا بل آلاف القتلى كل يوم. في هذه المقالة ساتكلم عن بعض نواحي الثقافة القديمة التي أريد أن أطلق عليها رصاصة الرحمة وسأعود مرات في المستقبل لأتكلم عن نواح أخرى لا تقل أهمية.
استجداء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: لقد عرّت الثورة السورية النظام السياسي العالمي الذي تحركه الدول الكبرى من خلال مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة. لقد عرّت الثورة السورية النظام الأخلاقي العالمي المرتبط بهذه السياسة والمتبجح بحقوق الإنسان بينما هو لا يعرف عن هذه الحقوق إلا تقارير منظمات بائسة تعتبر الآن مقابر مؤسساتية لقوى التغيير وايديولوجيات التحرر ونصرة المستضعفين. لم أشجع يوماً تدخل الغرب من أجل إنقاذ الشعب في سوريا من قبضة نظام مجرم لا يختلف عن النازية إلا بغبائه بينما أظهرت النازية قدراً لا يستهان به من الذكاء. لا أريد للغرب أن يتدخل كما فعل في ليبيا أو في العراق، لكن كنت أتوقع من الأمم المتحدة التي تمثل الضمير العالمي موقفاً أكثر وضوحاً أمام نظام لا يخفى إجرامه على أحد. لكن الأمم المتحدة التي أنشأها الغرب بعد الحرب العالمية الثانية لمنع قيام حروب دمار شامل وقتل شعوب بأكملها لم تكن ولا تزال إلا وسيلة في يد الغرب والدول العظمى الجديدة لتحقيق نوع من التوازن في السياسة العالمية والإقتصاد العالمي قائم على تقاسم مناطق النفوذ. وكما كانت سوريا ملعباً للقوى العظمى في الأربعينات والخمسينات فهي الآن ومرة ثانية في نصف قرن ملعب لقوى مختلفة لكن تسعى لتقسيم مماثل لمناطق النفوذ. هذه الدعم الدولي المأمول لن يأتي ولا بد من الإعتماد الكامل على الذات. هذا الإعتماد هو عقلية قبل أن يكون فعلاً وحتى تولد هذه العقلية لابد من إطلاق رصاصة الرحمة على عقلية الإستجداء.
القوقعة الكولونيالية للسياسة العربية: ولا أغضب لأن هذه الدولة أو تلك لا تريد دعم الثورة بالمال أو السلاح أو حتى التصويت في مجلس الأمن وإنما أغضب لأني أرى أن كثيراً من السوريين لايزالون يتعاطون السياسة بنفس الطريقة التي اعتادوا عليها منذ الخمسينات والتي تقوم على شيء من تأليه التوازنات الدولية واعتبارها قدراً لا يمكن الإفلات منه. هؤلاء لا يفقهون من السياسة إلا تخمين ما يدور في أذهان صنّاع السياسة في واشنطن وباريس وموسكو وبكين والإسراع في الإصطفاف وراء هذا اللاعب أو ذاك أو تنفيذ رغباتهم كما خمنوها اعتقاداً منهم أنهم يجرون مع مجرى الريح ويسيرون مع التيار. هؤلاء لا يمارسون السياسة بقدر ما يمارسون إلتقاط الفتات. يعتقدون أنهم فهموا اللعبة العالمية كما اعتقدوا أنهم فهموها من قبل. إنهم لا يؤمنون بأيديولوجية معينة قدر إيمانهم بعجزهم المطلق على الفعل وبقدرة الغرب أو القوى العظمى المطلقة على تسيير السياسات المحلية لدول العالم الضعيف المسمى بالثالث. ومع ذلك فهم لا يملّون من التململ والتذمر من أن السياسة في العالم العربي مثلاً يتم رسمها وتقريرها في أروقة البنتاغون والبيت الابيض وقصر الإيليزيه. إنهم لا يعرفون أن مخططات البيت الابيض وغيره ما كان لها أن تنجح دون مساعدتهم وإيمانهم بعجزهم وانصياعهم لرغبات يخمنونها تخميناً ثم يسارعون إلى تنفيذها.
حافظ الأسد كان أحد هؤلاء، لكنه كان أذكاهم لأنه نجح في البقاء أو كان آخر من بقي حياً من جوقة المتصارعين على الحكم في سوريا الخمسينات والستينات. حافظ الأسد لم يكن يخاف من قتل شعبه لكنه كان يخاف من غضب أمريكا. لم يؤمن بأن إنشاء دولة قوية عادلة يمكن أن يقيه من أي تلاعب دولي لكنه آمن بان التلاعب الدولي ضروري لبقائه في الحكم. والإبن لم يكن بأحسن حال من أبيه، إلا أنه كان أغبى بمراحل. بشار الأسد لا يخاف أيضاً من قتل شعبه لكنه يصاب بانهيار عصبي لو صرّح أصغر موظف في الخارجية الأمريكية بان امريكا قلقة على مصير الأسلحة الكيماوية السورية. الديكتاتوريا العربية تصرفت بنفس الطريقة ولم تستطع أمريكا أو أوروبا أو روسيا حمايتها وإبقاء أنظمتها وإنما سارعت إلى تدبير إنقلابات عسكرية بدل أن تحل الطامة الكبرى وتنتصر الثورات المحلية. لو إلتفت مبارك أو بن علي أو القذافي إلى بناء بلدان مزدهرة لما استطاعت أية دولة في العالم أن تؤثر في سياسة بلدانهم كما تفعل الآن.
وللأسف فقد ارتكب الثائرون في سوريا نفس الخطأ واعتقدوا أن قوة دولية ستنصرهم بعد أسبوعين أو أكثر من ثورتهم ضد نظام الأسد. إن النقاشات العقيمة التي كانت تدور بين لافتات المظاهرات وتصريحات المجلس الوطني كانت مشاهد سوريالية لمجتمع لم يخرج بعد من قوقعة الكولونيالية أو من طفولية الكولونيالية التي فرضها على نفسه كما فرضها الغرب عليه. وكيف له أن يخرج وقد كرس حزب البعث والأسد هذه العقلية المقيتة بقتلهم شعبهم ولعبهم على حبال التوازنات العالمية سعياً وراء دعم هذا وتمويل ذاك. هذا المرض القديم لا يزال موجوداً وحياً يرزق. لا يزال حياً في عقلية بشار الاسد التي تفهم من تصريح أوباما أن “الكيماوي خط أحمر” كرخصة لقتل المدنيين قتلاً بطيئاً بالأسلحة التقليدية. ولا يزال حياً في عقلية كثير من السوريين الصامتين الذين ينتظرون أن ترجح كفة النظام أو كفة الثورة بقدرة قادر أمريكي أو فرنسي أو روسي حتى يتخذوا قرارهم بدعم المنتصر وتحويل بعض من دولاراتهم إلى الليرة السورية. ولا يزال حياً في عقلية الثائرين الذين لا يزالون يرفضون إنشاء قيادة موحدة بينما ينتظرون دعم هذه الدولة أو تلك. ولا يزال حياً في المجلس الوطني الذي يسارع إلى عقد مؤتمر لتوحيد المعارضة أو إلى إنشاء حكومة مؤقتة عندما تصرح هيلاري كلينتون تصريحاً غائماً عن أمنيتها أن تتوحد المعارضة أو أن أن تشكل حكومة إئتلافية. إن قوقعة العجز أمام قوة غربية أو عظمى نعتقد أنها قدرنا لن تقودنا إلا إلى مزيد من التبعية. وكثيرون في الثورة أو من المتسلقين عليها يبحثون عن إله غربي ليقدموا له الولاء مقابل وصول إلى الحكم على رافعة التوازنات الدولية. لن تنجح الثورة السورية في أن تكون ثورة حقيقية إلا باستقلالية قرارها وإيمانها المطلق بقدرتها على التغيير. التبعية عقلية قبل أن تكون فعلاً ومن أجل ولادو سوريا مستقلة بقرارها ونمصيرها لا بد من إطلاق رصاصة الرحمة على قوقعة التبعية الكولونيالية.
المجلس الوطني السوري: المجلس الوطني الذي ألفته تكتلات سياسية قديمة باهتة أو جديدة غائمة ودعمته تشكيلات ثورية داخلية أو خارجية أشد غموضاً من حليفاتها السياسية، هذا المجلس رفض أن يكون قائداً للثورة يدعمها ويطورها وإكتفى بأن يكون “واجهتها السياسية” كما كان يحلو لبرهان غليون أن يقول. هذا الخيار القائم على العقلية المشار إليها أعلاه ترك الثورة وحيدة في حين كانت بأمس الحاجة إلى قيادة مما أدى إلى تفتتها الحالي. وإني أحملهم مسؤولية تشتت الثورة، والمنافسة العقيمة العمياء القاتلة التي تنهش جسدها، والتدخلات الدولية في تقرير مصير السوريين، وتبذير الآمال والوقت وحتى الأموال التي كان من الواجب توظيفها لتنظيم الثورة وتقوية زخمها. هؤلاء السياسيون القدماء، أو هكذا سموا أنفسهم، اجتمعوا كما كانوا يفعلون في الخمسينات وألفوا جبهة تقاسموا فيها المقاعد بمباركة من الشباب الثائر في الداخل الذي لم يكن يعرف من السياسة أكثر من اسمها. وكيف لهم أن يعرفوا أي شيء عن السياسة وقد عاشوا تحت حكم البعث خمسين عاماً، ولم يسمعوا إلا قصص آبائهم أو أجدادهم عن الثمانينات التي لم تكن إلا مجزرة للسياسة والعمل السياسي كما كانت مجزرة لآلاف الأرواح. وحتى آباؤهم وأجدادهم لم يعرفوا عن السياسة أكثر من الإنتماء لحزب معارض أو جماعة معارضة، أي لم يكونوا إلا هواة سياسة يحلمون بتقلد منصب سياسي إلا أن الاسد أفسد عليهم أحلامهم. هذا المجلس هو عنوان تلك الثقافة القديمة التي لا بد من إطلاق رصاصة الرحمة عليها حتى نستطيع تجاوزها. المجلس الوطني لم يتالف لأن الثوار طلبوا واجهة سياسية كما اعتقدوا وإنما لان هواة السياسة المحنكين في فهم التوازنات الدولية فهموا تلميحات كلينتون وغيرها أن “توحيد المعارضة” سيجلب التدخل الغربي الذي يؤمنون أنه الطريق الوحيد لخلع النظام القائم واستبداله بآخر أكثر عدلاً. توحيد المعارضة لم يكن لإنشاء قيادة موحدة تقود الثورة إلى بر الأمنا بل صورة لتكتل يتوزع فيه اللاعبون المقاعد حتى يحين موعد اقتسام الكعكة الأكبر، سوريا ما بعد الأسد. المجلس الوطني هو التمثيل الأوضح وأتمنى أن يكون الأخير لعقلية التبعية الكولونيالية وقدرية التوازنات الدولة. ومن أجل أن تولد سوريا جديدة بقيادة تنبع من تحت ولا يفرضها الغرب أو انقلاب عسكري من فوق لا بد من تخلي السوريين جميعاً عن هذه المسرحية المقيتة بإطلاق رصاصة الرحمة على هذا المجلس ومن إيجاد قيادة سياسية وعسكرية حقيقية للثورة السورية تنبع من الشوارع والحارات والقرى الثائرة وليس من الفنادق والسفارات.
الفكر الإستشهادي الخلافتلي: الفكر السياسي الإسلامي بتمظهره الجهادي المهووس بالشهادة والخلافة هو شكل آخر من أشكار القوقعة الكولونيالية التي تعيق ولادة الثورة السورية الحقيقية. ولا أتكلم هنا عن المقاتلين الأفراد ولا عن الكتائب التي تحمل اسماء الصحابة ولا عن التكبير ولا عن الأغلبية السنية في الثورة ولا عن التدين الشعبي أمام آلة الموت الأسدية ولا عن المقاتلين المجاهدين في سبيل حريتهم وحرية أهلهم، وإنما أتكلم عن فكر برز في الثورة أو تم ضخه فيها خلال الاشهر الستة الاخيرة. هذا الفكر جعل من ثورة الحرية و الخلاص من الطغيان حرباً ضد الشيعة، ومن التكبير النابع من القلب المقهور صراخاً قتالياً مبتذلاً، ومن دولة القانون عودة إلى الخلافة، ومن الجهاد طريقاً إلى “الشهادة” السريعة وكأن الشهادة هي أساس الجهاد في حين أنها كانت دائماً أحد نتائجه، ومن إعلاء كلمة الله شعاراً لا معنى له منفصل عن حياة الناس لا بل وسيلة للموت. هذا الفكر جعل من الإسلام دولة قبل أن يكون ديناً أي سبيلاً للحياة الصالحة، وجعل منه قانوناً قبل ان يكون إيماناً، وجعل منه قتالاً أزلياً قبل أن يكون صلاة وزكاة، وجعل منه حجاباً قبل أن يكون عفة، وجعل منه “من بدل دينه فاقتلوه” قبل أن يكون “إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق”، وجعل منه كرهاً للآخر المختلف قبل أن يكون دعوة للناس كافة. هذا الفكر كان وليد عصر ضعف الإمبراطورية العثمانية وخلافة السلطان عبد الحميد الفاشلة التي خلقت شعار “الإسلام دين ودولة” لتدفع عن نفسها شبح تدخل الغرب في شؤونها بتجييش الإنتماء الديني وتحويله إلى إنتماء سياسي. لم يكن هذا الضعف من صنع الغرب كما كان يحلو للسلطان عبد الحميد أن يزعم بل كان نتيجة حتمية لسوء فظيع في إدارة إمبراطورية مترامية الأطراف. إمبراطورية وصلت إلى القرن التاسع عشر وهي لا تزال تعيش بعقلية وتنظيم وإدارة وتكنولوجيا القرن الرابع عشر. هذه الإمبراطورية التي حولت الجهاد إلى حملات سنوية لكسر الممالك المسلمة والمسيحية على حد سواء واستعباد مسيحيي البلقان، والتي حولت علماء الدين إلى موظفين في دولتها، والتي حولت الشريعة إلى قانون الدولة الذي تطبقه بسلطة العسكر، والتي حولت إيران الصفوية إلى الشيطان الشيعي، والتي حولت ملاكي الأراضي المحليين إلى إقطاعيين، والأقليات الدينية والقومية إلى مواطنين من الدرجة العاشرة.
هذا الفكر السياسي اللاهوتي يأخذ مؤسسات الدولة الأوروبية الحديثة ويعطيها أسماء قديمة كالشورى والزكاة والمظالم ويعتقد بذلك أنه يحيي عصر الخلفاء الأربعة الأوائل الذي تم تحويله إلى أسطورة لا تمت إلى الواقع بصلة. هذا الواقع الذي شهد مقتل ثلاثة من الأربعة الراشدين. هذا الفكر الذي يعتقد أن الحاكم المطلق الصالح المسمى بالخليفة هو الطريق إلى العدالة الإجتماعية التي يحلمون بها، وهو مفهوم للعدالة كان اليسار الأوروبي اول من طرحه. هذا الخليفة الذي يحلمون به ليس إلا ملكاً متسلطاً بثوب حديث. وهو في الحقيقة لم يكن يوماً إلى ملكاً متسلطاً. هذا الفكر يحوّل الإنتماء الديني والإنتماء الطائفي إلى تعريف للمواطنة مكرساً بذلك دونية الأقليات الدينية. هذا الفكر لا يقدم أي تنظيم للمجتمعات العربية الحديثة التي تشهد إنفجاراً سكانياً هائلاً إلا تسلطاً رجولياً وتسطيحاً للأخلاق والعفة باختزالهما بالحجاب او النقاب. هذا الفكر الذي يبدأ بفكر الإخوان المسلمين وينتهي بفكر الوهابيين وفكر التكفيريين هو عقبة في وجه ثورة سورية شاملة، لأن الثورة الشاملة تؤمن بالمواطنة ولاترى أقليات أو أكثرية، وتجمع الناس جميعاً حولها وليس طائفة معينة تعتقد بأحقيتها بالحكم لمجرد أنها أكثرية مزعومة، وتؤمن بالقانون الحاصل على إجماع الناس وليس على إجماع حفنة من الفقهاء المزعومين، وتؤمن بالحرية والحياة الكريمة وليس بالموت دون هدف واضح بدعوى الشهادة. الثورة الشاملة الحقيقية لها أهداف تنبع من حياة الناس وليس من شعارات عامة مغلفة بخطابات محفوظة من العصور الوسطى. الثورة الشاملة تريد للناس أن يقاتلوا من أجل أن يحيوا وليس من أجل أن يموتوا، وتريد للشعب الذي ثار من أجل الحرية أن يبقى هدفه واضحاً نصب أعينه لا أن يحوله إلى كلمات عمومية ليس لها من تطبيق على الأرض إلى ولاية الفقيه على الطريقة الإيرانية أو السعودية وكلاهما واحد. إن الجهاد الحقيقي هو جهاد من أجل المضي على الطريق القويم الذي هو طريق الأخلاق الحميدة، ولا يكون هذا إلا بحرية الخيار وحرية العقيدة وحرية العمل وحرية الإعتقاد. من أجل أن نصل إلى هذا الجهاد الحقيقي فلا بد من إطلاق رصاصة الرحمة على أي شعارات فارغة المحتوى لا تقول بوضوح أن الشعب ثار من أجل الحرية وستبقى الحرية هدف.
الأحزاب السياسية التقليدية: الأحزاب السورية السياسية القديمة منها والحديثة تعاني من عدة نقاط ضعف قاتلة. النقطة الأولى هي أن بنيتها المؤسساتية ليست إلا تنويعاً على نغمة الديكتاتورية العربية العصبوية (عصبية القبيلة أو المنطقة أو الطائفة أو القومية). إن قراءة النظام الداخلي لأي من هذه الأحزاب يؤكد ضعف فكرها المؤسساتي، وبعدها عن أية ممارسة ديمقراطية (أي تبادل السلطة وتكافؤ الفرص)، وحرصها على إنتاج نخبة حزبية أبدية وصورة الأب القائد الأبدي، وتكريسها للتبعية الفردية والفكر الإقصائي. النقطة الثانية هي أن أيديولوجياتها لم تتخط يوماً مستوى خطابات الأب القائد وتعليماته. فهي إما ايديولوجيا قومية شوفينية تمجد الماضي وتتقوقع في نظرية مؤامرة غربية مع أنها تقتات على لعبة التوازنات الدولية، أو أيديولوجية إشتراكية سيئة الترجمة ومعدومة التطبيق وتفتقد إلى الفكر المحلي الخلاق والإستقالية في الفكر والقرار حتى، أو أيديولوجيا إسلاموية سبق تفصيلها، أو أيديولوجية ليبرالية لا تعرف من الليبرالية إلا فتح الاسواق للإستيراد والتصدير، أو يسارية عديمة اللون لا تعرف من اليسار إلا معاداة الدين والطائفية المبطنة.
نعم إن وظيفة الأحزاب في أي نظام يحقق تكافؤ الفرص (وهذا تعريف موسع للديمقراطية دون حذلقات لغوية) هي أن تصل إلى الحكم دون أن تتشبث به بأسنانها من أجل إدارة الدولة وليس من أجل توزيعها على الأعوان. لكن وظيفتها حين يتعرض البلد لخطر محدق هو ان تكون أحزاباً وطنية تضع الوطن قبل المصلحة الحزبية والصيد في الماء العكر من أجل الوصول إلى السلطة أو الحصول على مقاعد. للأسف لا أرى من هذه الأحزاب في هذه الأزمة العسيرة التي تمر بها سوريا والتي فتت الدولة والمجتمع وهدمت البنية التحتية وشردت الاهالي وقتلت البشر، لا أرى منها إلا ولاءات حزبية ضيقة تطغى على الولاء الوطني الجامع. وخير مثال على هذه العصبية الحزبية الضيقة الأحزاب والجماعات المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني. إن هدفها يبقى الوصول إلى الحكم مع نية مبيتة مع سبق الإصرار والترصد بالإستئثار بالحكم وزج المعارضين في السجون أو إبعادهم إلى المنافي. إن الثورة السورية الشاملة تدعو إلى إنشاء الأحزاب والعمل من خلالها من أجل مصلحة وطنية عامة وليس مصلحة حزبية في الوصول إلى السلطة قبل الآخرين والإستئثار بها. من أجل أن تنشأ هذه الأحزاب الجديدة التي تمارس الديمقاراطية كما تدعو إليه والتي تعمل من أجل المصلحة العامة حين يكون الوطن في خطر والتي لا ترى في الحكم جائزة تحصل عليها مرة واحجة وإنما مسؤولية إدارية خطيرة الأهمية، من أجل ذلك لا بد من إطلاق رصاصة الرحمة على الأحزاب القديمة بفضحها وفضح ممارساتها والكف عن دعوتها لتكون واجهة سياسية للثورةا.
قوقعة الملة العثمانية: لقد كان هناك زمن كانت فيه الأقليات مجموعة مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، وهو ما كان يسمى نظام الملة في العهد العثماني، أي أن تعريف المواطنة هو الإنتماء الديني والطائفي قبل الغنتماء للوطن والقانون. لكن هذا بدأ يتغير حتى خلال حكم الإمبراطورية العثمانية على سوئه، وذلك لأن التنظيمات العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر أدخلت نظام التمثيل المحلي والوطني للأقليات حسب نسب توازي نسبهم في مجموع السكان. طبعاً العداوات الإجتماعية بقيت لكن هذه العداوات موجودة في أي مجتمع. المسيحيون لم يكونوا يخدمون في الجيش العثماني لانهم كانوا يُعتبرون تحت حماية دول أوروبية مختلفة. وعندما أجبرهم العثمانيون على الخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية اعتبر كثيرون هذا اضطهاداً ونسوا أن مواطنيهم المسلمين كان يخدمون في الجيش العثماني لعشرين سنة خلت. وللأسف لا ازال أقابل في أمريكا أبناء وأحفاد هؤلاء المسيحيين السوريين الذي يحقدون على المسلمين بسبب الخدمة الإلزامية العثمانية ويزعمون أنها اضطهاد متعمد. وحتى المجاعة التي سببها الحصار البحري الفرنسي-الإنكليزي أيام الحرب الأولى ألقي اللوم فيها على المواطنين مسلمين الإمبراطورية العثمانية التي سقطت بعد الحرب وتقاسم الغرب أراضيها. وإن قصص إضطهاد العلويين وبيعهم لبناتهم كخادمات في بيوت المدينة السنية ليست من صنع الإضطهاد السني الأزلي وإنما من صنع الحرب والمجاعة التي رافقته والتفتت الهائل الذي سببته لنسيج المجتمع السوري بشكل عام. لكن هذا المجتمع لم يكن مجتمعاً موحداً وإنما كان مدناً وقرى وطوائف ألقى كل منها اللوم على الآخر. إن قصة طرد العلويين إلى الجبال من أسخف القصص التي سمعتها لأن الجبال كانت مسكونة منذ قديم الزمان وتم تحويلها للديانة العلوية بجهود مبشرين انطلقوا من مدينة حلب، المركز الأساسي للدعوة العلوية في العصور الوسطى. وتاريخهم ليس مختلفاً عن تاريخ الدروز الذين كانوا أيضاً سكان جبل لبنان قبل تلقيهم للدعوة الدرزية الفاطمية.
لكن للأسف لا تزال الأقليات في سوريا تعيش في فقاعة الإضطهاد العثماني الذي تم نسبه إلى المسلمين السنة بشكل عام. هذا الإضطهاد الذي كان موجوداً يوماً ما لكنه لم يعد موجوداً منذ لا يقل عن مائة عام. إن قانون سوريا منذ إستقلالها عن العثمانيين قانون يراعي حقوق الأقليات باعطاء زعمائها الدينية سلطة على الأحوال الشخصية، لا بل هو قانون ديني يعطي للسلطة الدينية الطائفية في الشؤون الشخصية سلطة مطلقة دون أي اعتبار للمواطنة المنفصلة عن الإنتماء الطائفي. لكنه لا يفرض قانون فئة على فئة أخرى. وأذا أراد أي كان في سوريا أن يتعرف على الإضطهاد الإجتماعي العرقي أو الديني أو الإقتصادي فما عليه إلا أن يقرأ تاريخ الولايات المتحدة ليعرف الفرق الهائل بين التقوقع الطائفي وعقدة الإضطهاد وبين الإضطهاد الحقيقي القائم على القانون وسلطة الدولة. إن من المخجل أن نرى معظم الأقليات الدينية في سوريا تصطف وراء حكم الأسد الإجرامي والطائفي بدعوى العلمانية وبدعوى الخوف من الإضطهاد الإسلامي السني الذي لم يكن يوماً موجوداً في القانون السوري الحديث منذ نشوء الدولة السورية في عام 1918. وللأسف فإن الفكر الإستشهادي الخلافتلي يدعو بالتحديد إلى ديكتاتورية الأغلبية السنية وفرض قانونها الذي يزعمون بانه الشريعة وكأنهم يعرفون رغبات جميع السوريين. عندما تتحول الطائفة السنية إلى تعريف للمواطنة يصبح المسيحيون من خلاله أهل ذمة والعلويون ملة كفر فإن سورية تتحول إلى إمبراطورية عثمانية أخرى وليس إلى دولة حديثة تؤمن بالحرية وتكافؤ الفرص والمواطنة الواحدة. أن تكون الثورة السورية ثورة حقيقة شاملة لا بد لها من أن تكون ثورة جميع السوريية، ولذلك لا بد من إطلاق رصاصة الرحمة على العقلية الطائفية التي أسميتها بقوقعة الملة العثمانية الموجودة في أذهان العديد من أفراد الأقليات في سوريا وما يقابلها من عقلية ديكتاتورية الأغلبية الموجودة عند كثيرين من السنيين أيضاً فهما وجهان لعملة واحدة.
العصبيات دون الوطنية: في سوريا كالعادة يكون الإنتماء الوطني أو الحزبي الأيديولوجي ثانوياً وتابعاً للإنتماء المناطقي أو العشائري أو الطائفي، التي أسميها هنا بالعصبيات دون الوطنية، لأنها لا تبني وطناً متماسكاً وأمة واحدة ذات عقد إجتماعي. في سبعينات والثمانينات عندما ثارت بعض الجماعات على نظام الأسد الأب فإنها ثارت بتجمعاتها المناطقية المعهودة فكانت هناك ثورة حلب وثورة حماة وثورة دمشق وكانت هناك خلافات كبيرة بين الجماعات الثائرة في كل منطقة. ثم قتل النظام من قتل وسجن من سجن وشرد من شرد. هؤلاء المتمردون الذين لم يستطيعوا أن يتوحدوا لا في تمردهم ولا في سقوطهم، وأدى تفرقهم إلى سقوطهم، أنجبوا ابناءاً عاشوا حياتهم خارج سوريا. عشرات الآلاف من الأبناء الذي يحلمون بسوريا ولا ينتمون إليها ولا حتى لمجتمعاتهم المضيفة (أو هي تنبذهم) ما كان آباؤهم ليتخلوا عن عصبيتهم المناطقية حتى عندما ادت لهزيمتهم. كثير من هؤلاء الأبناء يريدون الدخول إلى سوريا للمشاركة فيما يسمونه الجهاد، يريدون أن يموتوا في سبيل وطن يحلمون به لكنهم لا يعرفونه ولا أقول هذا انتقاصاً. لكن الملاحظة هنا أن هؤلاء المجاهدين هم المجموعات المقاتلة الوحيدة التي استطاعت كسر العصبيات المناطقية والعشائرية التي لا تزال تعيق مسيرة تطور الثورة السورية. هؤلاء المجاهدون هم المقاتلون الوحيدون الذين لا يتمترسون في منطقة واحدة ويتنقلون وراء أهدافهم النوعية، عكس ما يسمى الجيش الحر. هؤلاء المجاهدون يعرفون التدريب والإنضباط والقيادة الموحدة. هذه العقلية لم تكن لتوجد لولا غربة الأهل وعذاباتهم. لكن للاسف فإن مقاتلي الداخل لا يزالون على عقلية الثمانينات يكررون أخطاءها بتشتتهم وولاءاتهم المناطقية وتمترسهم في الأحياء السكنية وانعدام التخطيط عنهم والأهداف البعيدة المدى وحتى أحياناص القصيرة المدى. إن الثورة بحاجة إلى جيش وطني أو جيش من مواطنين يتنقلون حسب المهمة الموكلة إليهم وليس حسب إنتماءاتهم المناطقية. المسلحون في الثورة السورية ليسوا جيشاً وإنما مجموعات من أهالي الاحياء والقرى الذين يحملون رشاشات خفيفة ويقاتلون في أحيائهم وقراهم دون قيادة مشتركة ودون مخطط ودون بعد نظر. هذه القيادة وهذا المخطط لا يوجدان إلا بوجود الجيش الوطني الذي ينتمي إلى هدفه ومهمته ووطنه وليس إلى قريته فهو لن يستطيع حراستها حتى لو أراد. وانا أقترح ان سبب هذا التوازن القاتل الموجود اليوم بين المقاتلين والنظام الاسدي هو أن النظام لديه جيش بينما المقاتلون مجرد أفراد وليسوا جيشاً. وتسمية الجيش الحر تسمية خادعة لهم ولنا ولجميع من يراقب الثورة السورية. إن الثورة الشاملة بحاجة إلى جيش من المواطنين وليس إلى كتائب من أهالي الحارات والقرى، وهذا لن يكون إلا بإطلاق رصاصة الرحمة على العصبية القديمة دون الوطنية التي تنهش في لحمنا يوماً بعد يوم وتشتت جهودنا، وصراحة تدمر سوريا بيد النظام المجرم الذي فهم عقلية الكتائب ونجح في خلق توازن معها حيث تبقى في الأحياء والقرى بين هو يقصفها عن بعد. إن الثورة السورية ستكون إن أرادت المعيار الأخلاقي الذي سيحكم القرن الواحد والعشرين. إنها ثورة ستنتصر رغم كل العثرات وستنتصر بجهود أهلها وستكون أول ثورة شعبية في القرن الواحد والعشرين وهو بالتحديد ما يخاف منه الغرب والدول العظمى وقبلها دول الجوار العربي والتركي. هذا النصر المنتظر وهذه الثورة الشاملة التي نريدها والتي لا تزال في مرحلة المخاض بحاجة إلى أن تتخلص من عقليات قديمة لم تعد تنفع. هذه العقليات التي عاشت معنا لأزمان طويلة لابد لها من رصاصة الرحمة التي تعلن الميلاد الجديد.
تابعونا على صفحات وسائط التواصل الإجتماعي: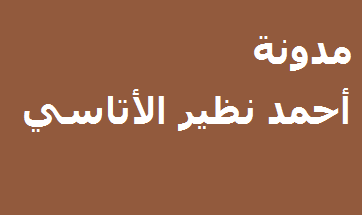




 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات