ما بعد “موت الأيديولوجيات”

ظهر المقال على موقع الأوان في أوائل 2011. لكن بعد تجديد الموقع، أعطيت كل المقالات تاريخ التجديد، أي 8 ديسمبر، 2013.
لاحظ عدد من المراقبين للحدث التونسي الجلل غياب الشعارات الأيديولوجية الطنانة ومزاعمها في امتلاك حلول شاملة تصلح لكل زمان ومكان مثل “الإشتراكية هي الحل” أو “الليبرالية هي الحل” أو “الإسلام هو الحل”. وهذه ملاحظة صحيحة وتدل على تغيرات عميقة في تصور الناس لمفهوم السياسة والدولة وعلاقة المواطنين بها. لكني لا أجزم بموت الأيديولوجيات بمعنى المنظومات النظرية التي تشرح وتخطط وتحرّض الناس على الحلم والفعل أيضاً. لكني قد أقول بموت الأيديولوجيات الشمولية صاحبة الحل الواحد الغائم والتفصيل على مقاس واحد. الناس دائما بحاجة إلى مشروع مستقبلي يشرح لهم بكلمات بسيطة حالتهم الآنية ويقترح عليهم طريقاً للخلاص والانتقال إلى مرحلة أفضل (باعتبار أن مفهوم التقدم أصبح مستبطَناً وأساساً منطقياً حتى، لكن هذا موضوع آخر). لكن المشاريع المعروفة، والتي طلبت من المتعلقين بها إيماناً أعمى يشبه التدين، قد تكون وصلت إلى طريق مسدود. وأقول “قد” لأنّ التجربة الإسلاموية لم تُحسم بعد، ولأن الليبرالية الغربية على طريقة القرن التاسع عشر في صعود مستمر على الساحة العربية رغم وصولها إلى الشيخوخة في موطنها الأصلي. على العموم، نحن في مرحلة انتقالية ولا نعرف عن ماذا ستتمخّض، وذلك لأن الأدوات التقنية الحديثة قد خلقت فضاءً جديداً للتواصل وتبادل المعرفة والفعل السياسي والاجتماعي لا نعرف شكله وحدوده بعد، وهو باعتقادي مختلف عن الفضاء العام الذي خلقته الطباعة وصعود المدن الأوروبية خلال القرون الثلاثة الماضية. هذه المقالة هي إضافة إلى البلبلة الفكرية الخلاقة التي نمرّ بها ومحاولة لتحليل أثر الحدث التونسي الذي أصبح إرثاً عالمياً باعتبار أن الناس خارج تونس تصرخ وكأنها في مبارة كرة قدم توجّه تونس إلى هذا الطريق أو ذاك. وليس هذا التحليل تأطيراً للحدث التونسي فالثورات عادة تفوق في غناها أي إطار نظري، لكنه محاولة بسيطة ومبكرة للخروج بدروس ومساهمة في النقاش الجاري حول أسباب ما حدث ونتائجه.
يتصارع المحللون والسياسيون الآن لتسمية الحراك التونسي الذي فاجأ العالم أجمع لأن التسمية جزء أساسي من إنتاج المعرفة بما قد يعنيه هذا من محاولة التأثير في مجرى الاحداث ومن إعادة قولبة الحدث التاريخي حتى تستوعبه أدواتنا التحليلية وتوجهاتنا السياسية الحالية. أي أن التسمية محاولة لإعادة الحدث التونسي إلى قوالب الأيديولوجيات الكبرى وحصرها فيها. فمنهم من اعتمد تسمية “ثورة الياسمين” أسوة بثورات الألوان والورود، وآخرون تحدثوا عن “ثورة الجياع” وتحوّلها إلى “ثورة العاطلين المثقفين”، وهناك من أعلنها “ثورة لكرامة الإنسان” على طريقة الحمية العربية التي تفهم العالم من خلال الشرف والعرض والكرامة، وهناك في أمريكا من يسوّق لتسمية “ثورة الإنترنت” أو “ثورة الويكيليكس” جاعلين مبدأ أي تغيير في العالم النموذج الأمريكي، وهناك من يريدها “ثورة ضد العلمانية” ويقابلهم من يريدها مكسباً من “مكاسب العلمانية” ونتيجة لها. طبعاً هناك من رأى في الحراك التونسي غياباً لعناصر طغت على الساحة العالمية مثل “غياب الإسلاميين أو الملتحين” و”غياب الاشتراكيين” و”غياب الليبراليين”. وأخيراً هناك من يجادل في كلمة “ثورة” بحد ذاتها باعتبارها “إرثاً مقصوراً” على مرجعيات قديمة أرست مرتكزاتها وجذّرت خطاباتها الأيديولوجيا في الواقع المعرفي والعملي مثل “الثورة الفرنسية الليبرالية” و”الثورة الروسية الشيوعية” و”الثورة الإيرانية الإسلامية”.
لقد حيّرَنا أهل تونس فنحن لا نزال في الحقيقة نعيش في عالم الأيديولوجيات الشاملة وإن كنا نراهن على موتها ونعلن هذا الموت وكأنه حصل وانتهى. طبعاً أهل تونس لم يسمّوا ثورتهم بعد لأنهم في خضم التغيير، ولأن التسمية في الحقيقة تعني الوصاية والتأطير الكامل والقدرة على التحكم بمجريات الأمور، أي تعني في الحقيقة نهاية مرحلة الانتقال الثورية. التسمية في النهاية يطلقها “المنتصر” الذي يعيد كتابة التاريخ العشوائي للثورات ليُظهرها بمظهر الحدث الحتمي ذي البدايات السببية والسيرورة الغائية والنهاية المتوقعة الحتمية. وقبل أن يظهر “المنتصر أو المنتصرون” وتنتهي المرحلة الإنتقالية الغنية بالاحتمالات والإمكانات أودّ أن أدلي بدلوي في النقاش الدائر اعتقاداً مني بأن المعرفة النافعة البعيدة عن إعادة كتابة التاريخ تنبع من بلبلة المرحلة الإنتقالية وأثناءها. وقبل البدء لا يجب أن ننسى المسلّمة الأساسية لفهم أي حدث تاريخي وهي أن الحدث هو ابن السياق، والسياق هو الجوّ العامّ المحيط بالحدث والفاعلين ضمنه والذي يحمل في طياته العديد من الاحتمالات يكون الحدث الواقع أحدها وليس بالضرورة أكثرها احتمالاً. بناء على هذا يجب أن نبدأ ببناء تصوّر ما للسياق التاريخي الحالي بكل مستوياته لنرى كيف يكون الحدث التونسي وليداً له مما يمكننا من الإجابة على سؤال المقالة الكبير “هل ماتت الأيديولوجيات؟”.
فعلى المستوى الإنساني العالمي أصبحت الحريات المعروفة الآن بحقوق الإنسان أساساً تنطلق منه أية محاولة للتغيير. وهي بهذا حلت محل الأيديولوجيات الشاملة في شقها الهدفي أي أنها أصبحت هدفاً لغالبية حركات التغيير حول العالم. وحتى الحركات الإسلاموية تتحرك ضمن هذا السياق وإن وضعت حدوداً “إسلامية” لهذه الحريات والحقوق. ولا بدّ من التنويه هنا إلى أن حقوق الإنسان ليست نتاجاً لليبرالية الأوروبية وحدها وإن كانت البادئة بطرح صياغات واضحة لها. إذ لا يجب أن نهمل هنا التجارب الإشتراكية في العالم والتي أضافت مفهوم الضمان الإجتماعي إلى قائمة هذه الحقوق وهي في أساسها حقوق فردية؛ وكذلك تجارب التحرر الوطني من الاستعمار التي وضحت معنى السيادة الوطنية وحق تقرير المصير وأظهرت مساوئ التبعية بكل أشكالها؛ وتجارب الانعتاق من الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية المتطفلة على الدولة والمجتمع التي أعادت الحريات الفردية إلى الواجهة وأظهرت أهمية تداول السلطة وتطور مؤسسات المجتمع المدني. ولا ننسى تجارب الحربين العالميتين ومجازر التطهير العرقي والديني والفكري، التي أعادت مركزية الإنسان الفرد مقابل الآلة والجماعة، ومركزية حق الحياة والوجود والاختلاف أمام نزعات الإقصاء والقتل. ولا أعتقد أن أية أيديولوجيا شاملة تجمع في طياتها نتائج كل هذه التجارب.
أما على مستوى الجماعة السياسية (أي المجتمع بكونه جماعة المواطنين المشاركين في الهم العام) فإن تقنيات الإتصال الحديثة قد كثفت من تلاحمها وزادت في سرعة تواصلها وسهلت انتقال المعلومة السياسية بين أفرادها وسرّعت عملية الوصول إلى إجماع (أو إجماعات). كان للطباعة أثر مشابه ابتداءً من القرن السادس عشر في أوروبا ومن القرن التاسع عشر في العالم العربي. لقد جذبت تقنية الطباعة أعداداً متزايدة من الناس إلى الفضاء العام الذي هو فضاء سياسي بامتياز، وخلقت ما نسميه اليوم بالرأي العام. وبالتوازي مع آثار الطباعة ظهرت التجمعات السياسية مثل النوادي والمقاهي ومن ثم الأحزاب والمنظمات وأصبح بالإمكان إحداث تغيير سياسي جذري عن طريق حراك جماعي عام كان أول مثال بارز له الثورة الفرنسية. أما آثار تقنيات الاتصال الحديثة فهي في بداية ظهورها وقد تأخذنا على حين غرّة بسبب السرعة العجيبة في تبادل المعلومات. القنوات الفضائية والتليفونات الجوالة والإنترنيت كلها خلقت فضاءً عاماً جديداً وإن كان افتراضياً لا تحصل فيه لقاءات للأجساد الفيزيائية وإنما لقاءات للأصوات والكلمات السابحة في الفضاء الإلكتروني. لا أقول إن الحدث التونسي نتيجة مباشرة لهذه التقنيات، لكن لولاها لما عرفنا بهبة سيدي بوزيد يوم حصلت، ولما انتشرت أخبار الهبة وبالتالي الهبة ذاتها في أرجاء تونس بهذه السرعة. وإن المُشاهد لمقاطع الفيديو الموجودة على يوتوب للأحداث يرى بوضوح أن الشبان الغاضبين المتظاهرين ينقسمون إلى قسمين: القسم الأكبر يرمي بالحجارة والكلمات والقسم الأصغر يصور الحدث بكاميرات التليفونات الجوالة أو الكاميرات الرقمية التي لا يتعدى حجمها حجم صفحة الكف. والقسمان كلاهما يركضان كراً وفراً حسب تحرك قوات الأمن. إن قدرة الكاميرات الرقمية الصغيرة على التقاط صورة واضحة وفيديو واضح رغم تحرك حاملها جعل بإمكان مراقب الأحداث أن يتحرك مع الجموع لا أن يقف في مكانه مع كاميرته الثابتة. طبعاً الفيديو يزيد في حدة الدراما لأنه يعطينا الحركة والأصوات والانفعالات المرافقة لها فكأننا نعيش الحدث، مما يزيد شدة تفاعلنا معه. وكذلك فإن التليفونات الجوالة تسمح أيضاً لناقل الخبر بأن يكون في خضم المعمعة وأن ينقل معلومات هامة وآنية عن تحركات الشرطة وقوات الأمن وأعدادها ووسائلها في قمع المتظاهرين. لن تستطيع قوى الأمن الحديثة أن تباغت أي متظاهرين حتى وإن حامت فوقهم بالمروحيات. ولن تستطيع أية حكومة بعد الآن أن تمارس العنف العشوائي ضد معارضيها دون أن يراها العالم بأسره تفعل ذلك وخلال ساعات قليلة، تماماً كما حدث في تونس. إن التكنولوجيا تمنح قدرة هائلة على المناورة للطرف المفاوِض الأضعف. إن التنسيق والوصول إلى الإجماع الذي يقوّي بُنية الجماعة المطالبة بالتغيير أصبح مسألة آنية ليست بحاجة إلى سفر واجتماعات وكتابة رسائل خطية وإرسال مندوبين، كل ما الأمر رسالة نصية على الهاتف أو رسالة سريعة على الإيميل أو مقابلة بالصوت والصورة على الإنترنيت. لم يعد بإمكان الطرف القوي استغلال هذا الوقت الضائع لتفتيت المعارضة أو لمنع وصول شرارة الإحتجاج إلى المناطق المجاورة. ولم تعد كذلك أية دولة أو جماعة بمنأى عن الضغط الخارجي أو العالمي، الفردي أو الجماعي أو المؤسساتي، الذي يحاول تغيير منحى الحدث، وهو ما نراه الآن في صراع التسميات والتعليقات والتحليلات والمدونات وصفحات الحوار التي يشارك فيها مئات آلاف الناس حول الكرة الأرضية. ما يحصل في تونس لم يعد ملكاً لتونس وحدها لأنه يؤثر على جميع سكان العالم وبالتالي فإن للجميع مصلحة في دفع الحدث في هذا الاتجاه أو ذاك، لا بل هم قادرون على ممارسة هذا الدفع. فكيف تستطيع الأيديولوجيات الكبرى الشاملة بحتمياتها وتحليلاتها المبسطة الوجود في هذا الجو الذي يستطيع كل فرد فيه أن يكون فاعلاً والذي تضخم عدد الفاعلين فيه بحيث يصعب على الأحزاب والجماعات الأيديولوجية احتواءهم؟
وعلى مستوى أنظمة الحكم فإن نظرية العقد الإجتماعي تلاقي رواجاً كبيراً وتظهر جلياً في المطالبة بالديمقراطية، وإحلال مفهوم المواطنة محل مفهوم الرعية، وتوسيع قاعدة المشاركين في الحكم والإمتناع عن الإقصاء، وإقامة المؤسسات التمثيلية مثل البرلمانات، وتحديد قواعد اللعبة السياسية بدساتير تضمن الحريات الاساسية وتفصّل الحقوق والواجبات. وحتى دون أن نقرأ أية لائحة مطالب للمتظاهرين في تونس أو أن نسمع شعاراتهم فإننا نفترض مباشرة (اللهم إلا إذا رُفع القرآن) أن المطالب السابقة الذكر ستكون على رأس القائمة وإن بأشكال مختلفة حسب الحالة المحلية. إن احترام الفرقاء لسلطة الدستور وإحساس المتظاهرين بالعسف الشديد عندما استخدمت الشرطة الذخيرة الحية ضدهم يشير إلى استبطان لفكرة سيادة الشعب ولفكرة الدولة كخادمة للشعب ولفكرة سيادة الدستور والقانون. لم أعتقد للحظة أن المتظاهرين يطالبون بإلغاء الدولة أو إلغاء الملكية الخاصة وإقامة مجتمع شيوعي أو إلغاء الدستور والبرلمان وإقامة يوتوبيا ثيوقراطية يرأسها مجلس شورى لا يستشير أحداً إلا أعضاءه ويحكمها كتاب الرب. فهل هذا يعني أننا نعيش في عالم تعلو فيه الليبرالية فوق كل الأيديولوجيات حتى أننا لا نراها؟ هل أصبح المشروع الحداثي الليبرالي الأوروبي كونياً لدرجة أننا لسنا بحاجة لرفع شعارات أية أيديولوجيا أخرى فالكل يفهم ما يريده المتظاهرون؟ جوابي على هذين السؤالين هو نعم متحفظة ولا مترددة. حتى الأيديولوجيات الإسلاموية (ولا أعتبر النظام السعودي جزءاً منها فهو نظام ملكي) لا تخرج عن الإطار العام الذي رسمته الليبرالية الأوروبية وأضافت إليه التجارب الأخرى المذكورة أعلاه. فهي تدعو إلى برلمان ودستور وبيروقراطية تكنوقراطية ولن تعيّن إماماً خليفة على رأسها حتى لو أتيح لها هذا (وتقتصر على المرشد الديني الأعلى مما يفصل بعض الشيء بين المرجعية الدينية والمرجعية البيروقراطية). وهي تدعو إلى نظام رأسمالي تتحكم به الدولة وإلى شبكة واسعة من برامج الضمان الإجتماعي تضمن من خلالها إمتنان الناس لها وبالتالي ولاءهم.
وهذا يحيلنا إلى المستوى الإقتصادي. إذ حتى الأنظمة الدكتاتورية الفردية بدأت تتحرك في اتجاه دولة التنمية والخدمات وإن ربطت كل مؤسسات الدولة بالأسر الحاكمة حتى تضمن البقاء. طبعاً شبكات الولاء والمحسوبية على طريقة المافيا ليست دولاً ليبرالية وإنما استفادت من النموذج الليبرالي كما استفادت سابقاً من النموذج الإشتراكي لتوسيع قاعدة الدعم الشعبي لها. وكما نوه بعض المعلقين فقد تكون المكاسب البسيطة التي بدأ بها حكم بن علي قد ساهمت أيضاً في سقوطه لأنها زادت عدد المتعلمين وزادت توقعات الشباب دون أن تعطي فرصة لهم لتحقيق هذه التوقعات. كما أنها زادت من الهوة الباينة للعيان بين الطبقة العليا المنتفعة بإقتصاد الريع والإستهلاك وبين الطبقات الأخرى التي تحاول جاهدة الوصول إلى والبقاء في الشرائح الوسطى. التحليلات الحديثة للثورة الفرنسية تركز على أصولها ومطالبها البرجوازية التي أقصت الأرستقراطية الإقطاعية من مركز القيادة لتحل محلها عبر وسائلها وأيديولوجيتها الجديدة المسماة الآن بالليبرالية. فهل سيطلع علينا بعد قرن مثلاً من يقول بأن ثورة تونس كانت ثورة الطبقات الوسطى التي سئمت من مشاهدة قطار الثورة التكنولوجية والصعود الاجتماعي والاقتصادي يمر بها دون أن تتمكن من القفز عليه؟ هذا ممكن، وفي الحقيقة فإني أعتبر كل الثورات في العالم الحديث مهما كانت أيديولوجيتها ثورات طبقات وسطى وإن قامت على أكتاف من يسمون بالطبقات الكادحة. وليس هذا بالشيء السيء لأن الطبقات الوسطى هي غالباً المتعلمة والمتحمسة للمشاركة في العملية السياسية، وهي التي تنتج القيادات والأيديولوجيات والمعلمين والتكنوقراطيين. وهذا سببه التكنولوجيا الحديثة ابتداءً بالطباعة ومروراً بالآلة وانتهاءً بتكنولوجيا المعلوميات. لم تعد الثورات حروباً بين الأمير فلان والأمير علتان وجيوشهما الخاصة وأيديولوجيتهما الدينية التي تحصر القيادة بالأسرة المقدسة، كما يرى كل مطّلع على التاريخ الإسلامي الوسيط.
وفي الحقيقة فإن من الإجحاف الاعتقاد بأن شعارات التنمية الإقتصادية والسياسة التمثيلية والحداثة الإجتماعية والعقلانية الأداتية التي نسمعها الآن هي ذاتها الشعارات التي طرحتها الليبرالية الأوروبية في القرن التاسع عشر. فحتى وإن كانت ليبرالية القرن التاسع عشر وخاصة الإقتصادية منها لا تزال عاملة في أمريكا مثلاً وتحاول الولايات المتحدة فرضها على شعوب العالم، فإني أعتقد أنها في طريقها إلى الزوال. لأنها وبكل بساطة غير مستدامة إلا بطريقة الدولة-القارة الغنية بمواردها والإمبريالية في توجهاتها، وهذه حالة لا توجد إلا في أمريكا. أما بقية شعوب العالم فتسعى إلى نظام يجمع بين التنمية الاقتصادية وإعادة توزيع الثروة ضمن برامج الضمان الاجتماعي مثل الضمان الصحي العام والتعليم المجاني أو المدعوم وضمان التقاعد واقتصاد السوق الذي تراقبه الدولة بحذر وتوقفه عند حدوده التي تأكدنا أنه سيتجاوزها لا محالة. وقد أوضحت الأزمة المالية العالمية الحالية أن اقتصاد السوق الحرة ليست إلا شبحاً لا وجود له فالدولة هي الكفيل الأول والأخير لهذا الاقتصاد الطمّاع بطبعه وهي التي توفر له السيولة النقدية وتحمى مصالحه وتراقب تصرفاته وتحمي أسواقه الوطنية بحواجز جمركية وتدعم قطاعاته الأساسية -لكن غير المربحة- بالدعم المالي المستمر والحوافز التي لا تهدأ وإن مرت تحت الطاولة وفي الخفاء. إذن وإن بدت الليبرالية الأوروبية طاغية فإنها في الحقيقة ليست الأيديولوجيا التي كانت، وليست أوروبية حتى بل نتاج تجارب عالمية، وهي أقرب إلى مبدأ التأقلم مع الواقع منها إلى مبدأ الفرض الأيديولوجي الجامد للواقع.
وإذا حاولت التبنؤ بالمستقبل فإني أتنبأ بانحسار مفهوم العقد الإجتماعي لتحل محله دولة الخدمات التكنوقراطية. أعتقد شخصياً أن أيديولوجيا العقد الاجتماعي لا وجود لها على أرض الواقع. تلك الأيديولوجية التي تقول بتخلي المجتمع عن السلطة لأجهزة الدولة مقابل القيادة الحكيمة التي تتيح لكل إنسان حرية السعي وراء سعادته ومصلحته الخاصة، هذا مع بقاء السيادة النظرية بيد الشعب منبع السلطات ومصدر القرار. والتي تقول أيضاً بأن السلطة التشريعية في الدولة تقوم بها جماعة ينتخبها الشعب فهي لذلك تمثله خير تمثيل وتعبر عن همومه وحاجاته. وأقول بعدم وجود هذا العقد لأن السلطة الحاكمة دائماً تفرض نفسها على الناس بمنطق القوة وهي في النهاية لا تمثل إلا نفسها. ولو تم تعيين السياسيين بالقرعة بدل الانتخاب لجاءت النتائج مماثلة. وفي الحقيقة أنا أفضّل القرعة بدل مهازل الانتخابات، فالقرعة توفر تكافؤاً أفضل للفرص لا توفره الانتخابات التي تعتمد على المال ودعم أصحابه. وأقول هذا ليس لثني عزيمة الشعب التونسي أو عزيمة أي من يحاول التغيير وإنما للفت الانتباه إلى أن لعبة الليبرالية السياسية تؤبّد وجود نخبة سياسية تزعم الكفاءة وتمثيل الشعب لكنها في الواقع تمثل المصالح الاقتصادية الكبرى. باعتقادي أن الأساس في إنشاء أية دولة لا تتحول إلى ديكتاتورية أو إلى حكم النخبة هو تداول السلطة بين تكنوقراطيين يعملون على استدامة دولة خدمات (وليس دولة تمثيل) ويتوزعون على سلطات منفصلة لا تطغى إحداها على الأخريات. وهذا التداول لا يستمر إلا بوجود توازنات بين القوى السياسية والقوى الإقتصادية والقوى الإجتماعية وبوجود عوائق دستورية أمام كل من يحاول الإستفراد بالسلطة وإلغاء تداولها. وأعتقد أن هذه الدولة الخدمية يمكن أن توجد ضمن أي نظام إقتصادي لأن هدفها هو إعادة توزيع الثروة من خلال إقامة شبكة ضمانات مثل الضمان الصحي والتعليم والتقاعد وتعويض البطالة والإعانات في أوقات الأزمات.
وأرى الآن في المشهد التونسي جنوحاً نحو الاعتماد على الأحزاب السياسية كمؤسسات تمثل الشعب وتستأثر بالساحة السياسية وكأنها جماعة الفاعلين الوحيدة. إن الأحزاب في العالم المعاصر لا تمثل إلا أعضاءها، وهي بهذا تشبه أية مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، ولا يجب أن تقتصر اللعبة السياسية عليها فقط. لا بد من إشراك النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، هذا المجتمع الذي أحدث الإنقلاب وقام بالتغيير دون أي تأطير من نخبة قائدة أو أيديولوجيا حادية. إن الأحزاب الآن إن عجزت عن تقديم نفسها كحاملة أيديولوجيا خلاصية أو ممثلة لشرائح مجتمعية فإنها لا تعدو كونها جماعات من الباحثين عن السلطة يتكتلون من أجل حماية مصالحهم، ولهذا فإني أفضّل التكنوقراطيين المستقلين عليهم. وبما أن التكتل سنّة الاجتماع الإنساني فلا بد أن تكون التكتلات
مرنة متغيرة حتى لا تكون عائقاً أمام تداول السلطة وتوزيع الفرص بأسلوب الاحتكار. التكتلات القائمة على النسب أو الطائفة أو القومية هي أسوأ
التكتلات لأن أيديولوجيتها جامدة وأساس العضوية فيها بيولوجي أو شبه بيولوجي، فهي لذلك عقبات كأداء أمام التدوال المشار إليه. والأفضل برأيي هي التكتلات المتأقلمة التي تقوم على أساس تشابه الرأي والمصلحة الآنيين وتنتهي بانتهائهما. وأرى أن شرط غياب الأيديولوجيات الشاملة هو ظهور مثل هذه التكتلات وتفوقها على التكتلات التقليدية الحزبية وغيرها.
وأقول ختاماً إنّنا لا نزال نعيش في زمن الأيديولوجيات الشاملة لكنه عالم آيل إلى الزوال غير مأسوف عليه. ولا أرى أن الإحساس باليتم أو الفراغ الفكري هو النتيجة الحتمية لأفول هذه الأيديولوجيات، إنما الإحتمالات مفتوحة والبشرية قد دخلت مرحلة أصبحت فيها الذاكرة البشرية تراكمية بعد أن كانت كالماء في الكف.
وأسجل هنا امتناني الشديد لشعب تونس الذي أذكى شعلة الفكر والأمل بتضحياته. وأقول للرئيس القذافي “لا تلم الضحية، فمن مات من الشباب مات بقرار من أطلق النار وليس بقرار من بدأ الاحتجاج”.
تابعونا على صفحات وسائط التواصل الإجتماعي: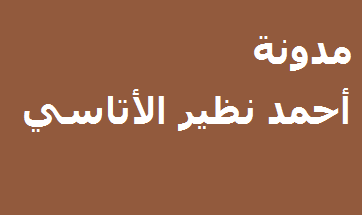




 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات