امرأة الظلّ التي لا ظلّ لها

ظهر المقال على موقع الأوان في 15 أبريل، 2010. لكن بعد تجديد الموقع، أعطيت كل المقالات تاريخ التجديد، أي 8 ديسمبر، 2013.
أنظر أيضاً نسخة من المقالة على الفيس بوك
أجرى عبده وزان مقابلة طويلة مع الشاعر أدونيس بدأت الحياة نشرها في 20 مارس (آذار) 2010. المقابلة أثارت فيّ مشاعر وأفكاراً كثيرة تتراوح بين الإعجاب والتعجّب والحنق والسخط. لكنّني سأقتطف هنا بعض الجمل، المتعلّقة بأمّ الشاعر وأبيه وعلاقته بهما، من الجزء الأوّل من المقابلة، لأبني عليها نظرة متفحّصة، ولا أسمّيها محلّلة، لوضع المرأة كأمّ في المجتمع العربيّ عموماً والسوري خصوصاً. ولست هنا بصدد انتقاد الشاعر أو ما قاله، أو تحليل تجربته الخاصة، وإنّما أريد أن أنطلق من كلماته المعبّرة لأرسم صورة لحال الأمّ تنضوي تحتها أمّهات كثيرات في المجتمع السوري والعربي. وكما استقى أدونيس كلماته وتصوّراته من تجربته الخاصة، سأستقي بدوري تصوّرات أخرى من تجربتي الخاصة. لا توجد هنا مرجعيات فلسفية أو مدارس فكرية في التحليل، وإنما مشاعر وتجربة معاشة وذكريات مسترجَعة ومصاغة وفق أنساق تعكس التجربة الوجودية الشخصية، وتحاول استخلاص فهم أعمق للأمّ كجزء منّا، وللأمّ كإنسانة منفصلة عنّا. أرى أنّ البدء بالذاتيّ حين الكلام عن الأمّ، وحتى عن الأسرة والمجتمع، ضروريّ، إذ لا أعتقد بوجود المراقب(ة) المنفصل عن موضوع اهتمامه(ها)؛ ولا بوجود ما يسمّيه البعض الموضوعية العلمية المتجرّدة من العواطف والدوافع الشخصية الخاصة. معرفة الإنسان لنفسه وجماعته تبدأ دائماً من ذاته، حيث تختلط الفلسفة الحياتية الشخصية بالنظرية العلمية التي تحاول جاهدة أن تضع نفسها خارج الخاص.
على عكس تجربة أدونيس الحياتية في شقّها الأمومي كانت تجربتي أنا. فقد توفّي والده وهو في العشرين من عمره، وتوفيت والدتي وأنا في حوالي العشرين من عمري. هو فقد الأب وأنا فقدت الأمّ وإلى هذا أعزو اختلاف تعاملنا مع الأمّ كفكرة وكشخص. ولذلك فإنّي سأقابل بين ذكرياتي وذكرياته، فلسفتي وفلسفته، للوصول إلى رؤية مبسّطة للأمّ كمفهوم وإنسانة وفرد، عسى أن يتابع كتّاب آخرون تطوير هذه الموضوع مستخدمين تجاربهم الخاصة، إضافة إلى أدوات تنظير أقدر على فصل الشرائح المتعدّدة المركِّبة للأمّ بكلّ أبعادها. واعتقادي هو أنّ تحليل المرأة وحالها في المجتمعات العربية لا بدّ أن يبدأ بفهم الأمّ، أي الحالة الأولى للمرأة التي يتعرّف عليها أيٌ منّا في حياته. وهنا يجب أن أنوّه إلى أن الفروق الطائفية أو الطبقية أو العمرية أو المهنية التي قد تميّز بيني وبين أدونيس لا أهمية لتأثيرها في عمومية ما سأقوله في هذه السطور.
بعد أن تحدّث أدونيس عن أبيه مطوّلاً في بداية الحوار، بطلب من المحاور، اتّجه إلى الحديث عن أمّه، بطلب من المحاور أيضاً، فقال: “الأمّ في المجتمع العربي هي في مرتبة «الظلّ»، بالنسبة إلى الأب الذي هو دائماً في مرتبة “الضوء””. هذا قول صائب ومكثف، لكني أراه خجولاً بعض الشيء، مرتبكاً وموارباً، يواري ارتباكه بلغة متفلسفة لاشخصية تتحصّن وراء عموميات وتشبيه لم يقنعني كمقولة معرفية. المحاور يسأل عن أمّ الشاعر، أي عن إنسانة محدّدة، والشاعر يجيب متحدّثاً عن الأمّ العربية عامّة. هذا يذكّرني بأحد لقاءاتي مع ما يمكن تسميته بالعقلية السورية أو العربية. كمساعد عديم الخبرة، أو بالأحرى متفرج، لوالدي الصيدليّ كنت أسمع شكاوي الناس الذين يرون في الصيدلي طبيباً رخيصاً، وكذلك طبيباً لا يطلب كشف ستر الخباء والتمعّن بسكانه المخبوئين. الصيدلية تقع في وسط مدينة حمص السورية الذي يمثل سوقاً صاخبةً لأهل المدينة من متوسطي الدخل ولسكان وادي نهر العاصي وسهول الوسط وأطراف بادية الشام. خليط من الثقافات الحضرية، المدينية والقروية، والثقافات البدوية. طبعاً الأب في كثير من الحالات ينوب عن مرضى أسرته في وصف أعراض أمراضهم وطلب العلاج لهم. وتبدأ المحاورة كالتالي: “العيلة مريضة، عندها كحة صار لها شهر، دخيلك يادكتور شي دوا يريحها.” وبعد عدة أسئلة وأجوبة عن طبيعة الأعراض بغرض حصر المرض في مجموعة متجانسة من الاحتمالات، يعطي الصيدليّ دواءً مؤكّداً ضرورة استخدامه ثلاث مرّات صبحاً وظهراً وعشاءً (ويعني هنا الصلوات). كيف يمكن أن يعطي والدي دواءً لعائلة بأكملها، بذكورها وإناثها وكبارها وصغارها. والدواء واحد والجرعات متساوية دون اعتبار للعمر والحالة المرضية؟ لم يكن ردّ فعلي سخطاً أو ثورةً حين علمت أنّ “العيلة” تعني الزوجة، بل انبهاراً بهذه اللغة المرمّزة التي يتحدّثها الناس ويتقنها والدي، مع عشرات من اللهجات المحلية والكلمات الغريبة والأساليب المختلفة في التعبير عن الغرض ذاته. وفي بعض الحالات، إذا تبسّط الرجل في الحديث لمعرفة سابقة بالصيدلي فقد يدلّ على زوجته بعبارة “أمّ الأولاد” أو “أمّ فلان” حيث فلان هو الابن البكر. أما الأمّ فهي إمّا “الحجّة” أو “الوالدة” دون استخدام ضمير الملكية للمتحدّث المفرد (أي بدلاً عن حجّتي أو والدتي). وقلّ أن يستخدم السائل كلمة “أمّي”. المرأة (زوجة كانت أم أمّاً) تُخبّأ خلف حجاب من العموميات يطمس شخصها لتصبح فكرة مجرّدة دون ملامح ودون خصوصية، فهي العائلة للزوجة والوالدة للأم. حتّى ضمير المتكلم الذي يربط المتكلم بالمرأة-الزوجة يضنّون به، وكأنّ التخصيص يقترب من تحديد الملامح وبالتالي يجعل الحجاب أكثر شفافية. ولن أتوسّع هنا في عبارة “أمّ الأولاد” التي تختزل المرأة إلى أمّ (:وظيفة) لأولاد غير محدّدي الجنس؛ أو في عبارة “أمّ فلان” التي تربط المرأة بالابن البكر، أي بالذكر الذي سيكون خليفة الأب في الأسرة. المرأة دائماً زائدة، تابعة، وليست في صلب شبكة العلاقات التي يسكنها ذكور الأسرة.
نعود إلى تشبيه أدونيس. ما أثار فضولي هو أنّ الشاعر يريد أن يتكلّم عن طرفي نقيض وعن علاقة تراتبية تربطهما. لكنّ الظلّ ليس من الضوء بموقع الضدّ والنقيض، وإنما نتاج له وتابع. فليس هناك ظلّ دون ضوء. ولا بدّ كذلك من حاجز يحجب الضوء مكوّناً بذلك ظلّ هذا الحاجز. ليس للضوء ظلّ وإنما الظلّ للحاجب. فإذا أراد الشاعر الضديّة كان أحرى به أن يقابل الضوء بالظلمة. لكنّ تشبيه الأمّ بالظلمة قاس إلى حدّ بعيد فاستعاض عنه الشاعر بظلمة من نوع آخر، ظلمة مخفّفة ليست نقيض الضوء (أي انعدامه) ولكنها ظلمة تابعة للضوء وناتجة عنه. ويظلّ التشبيه مختلاً لغياب الحاجز المكوّن للظلّ بحجبه الضوء عن مساحة محدّدة من الأرض. وليس اهتمامي هنا بدقّة التشبيه، فالشاعر أعلم منّي بهذا المجال، وإنما اهتمامي منصبّ على اختياره لفكرة التراتب بدل فكرة التبعية. فليست هناك مرتبة أعلى للنور على الظلّ إلا إذا كان الضوء، والظل كذلك، مجازاً لمفهوم مقرون بنوع من التقييم الإيجابيّ أو السلبيّ وبنوع من قياس الكمية والمحتوى. فالضوء قد يكون مجازاً للمعرفة، العقلانية، الحضور، الفعل، النفع، الخير، الانبهار، أو الانكشاف والوضوح؛ والظلّ قد يكون مجازاً للجهل، العاطفية، الغياب، الانفعال، العطالة، الشرّ، الاستخفاف، أو التستّر والغموض. والخجل الذي ألمسه هنا هو في تمييع الضدّية (النور والظلّ بدلاً من النور والظلام)، وإغفال علاقة التبعية بين النور والظلّ واستبدالها بعلاقة التراتب الذي لا نفهم كنهه. هل كان أدونيس يحمي العِرض من السفور والانكشاف؟ أم أنه لا يحتمل وصف واقع أمّه كامرأة مغيّبة ومهمّشة وكأنها السرّ القاتل للرجل بانكشافه؟ قد لا يستسيغ الشاعر مفهومَي الضدية والتبعية اللذين أقترحهما لوصف العلاقة بين المرأة والرجل كما يحققها المجتمع العربي بأشكال مختلفة في الحياة اليومية. ولست هنا لإلقاء اللائمة أو التقريع المتعالي. لكنّني أقول، باندفاع شبابي، إنّ تمييع الواقع لا يخدم إلا استمراره. هذا الواقع الذي تعوّدنا عليه كذكور وحتى كإناث وقبلناه دون وعي، رغم كرهنا للعديد من ممارساته. وانتفعنا منه بامتيازات قد تكبر أو تصغر؛ مثل البيت النظيف والغداء الجاهز، أو كوب الشاي الذي لا نردّ عليه بمثله بل بكلمات مثل “سلمت يداك” التي توهِمنا بأننا نردّ الجميل بالاعتراف به. لكننا حقيقة قد كرّسنا الامتياز بموازاته بأجر زهيد هو بضع كلمات تتحوّل بعد زمن إلى عبارات آلية ننطقها كما نتنفّس.
ثم يتابع أدونيس واصفاً علاقته بأمّه دون الرجوع إلى معيار الأب فيقول : “كانت أمّي، بالنسبة إليّ، كمثل الطبيعة، أرتبط بها لا بالولادة وحدها، بل بالهواء والفضاء. هي نفسها طبيعة، خصوصاً أنها لا تقرأ ولا تكتب. مظهر ناطق من الطبيعة. شجرةٌ من نوع آخر. أو نبعٌ يتكلم”. بالطبع لا يمكن للشاعر إلا أن يتكلّم بالمجاز الذي قد نراه شاعرياً من منطلق أنه وصف فريد ودقيق، بالمجاز الذي قد يضرب وتراً حقيقياً في نفوسنا. هذا الوتر الذي ضربته الصورة في نفسي كان مزيجاً من الرجّة واللحظة العرفانية، ليس بسبب عمق الصورة وبلاغتها بل بسبب حقيقتها. إنها حقيقة وليست مجازاً. الأمّ في مجتمعنا هي الطبيعة والهواء والفضاء والشجرة والنبع، أي هي خلفية الصورة التي لا نعيرها أيّ اهتمام. مركز الصورة هو الذكر وهامشها هو الأنثى، ولا يمكن أن يكون للذكر أيّ موقع محدّد أو معنى إلا بالخلفية التي تحدّد موقعه وتعطيه لوناً وأطياف ألوان لم نكن لنراها لولا المقارنة بين المركز والهامش. لكننا أبداً لا نعير الهامش أيّ اهتمام، فهو موجود دائماً، ولا نوجد دونه، لكنه غير ذي قيمة سلعية، تماماً كالهواء والماء والطبيعة. الأمّ والمرأة عموماً كخلفية لصورة الرجل، وككلّ الخلفيات، غائمة المعالم، بعيدة عن التحديد والتعريف، لا شخص لها ولا هوية. ويزداد ارتباط الأمّ بالطبيعة في ذهن الشاعر بجهلها الكتابة والقراءة. الكتابة والقراءة هما اللغة والتعبير، يصبح الإنسان إنساناً معبّراً وعاقلاً بمعرفتهما. ودونهما تعود الأمّ إلى حالة من الوجود الأوّلي، أي الطبيعة والشجرة والنبع. ليست للأمّ لغة فلغتها هي وجودها. هي مادّة الوجود التي لا تحتاج لوعي ذاتها، هذا الوعي الحاصل حصراً باستخدام أداة اللغة.
أثناء مراهقتي وعندما كان الناس يسألونني عن هويتي، والناس في العالم العربي سيسألون حتماً، كان الجواب الدائم العفويّ هو “أنا فلان بن فلان من عائلة كذا ومدينة كذا،” طبقات متراكبة من هويات ذوات مدلولات كبيرة. اسمي، وهو أنا، لا يكفي. الجملة المفيدة هنا كجواب للسؤال، وهي أصغر جملة مفيدة يمكن أن تعطيها في حوار تحديد الهوية هذا، هي “أنا فلان بن فلان” أو “أنا فلان من عائلة كذا”. وهذا يتبع عُرف المنطقة والبلد الذي نعيش فيه. هويّتي هي سلسلة طويلة من الذكور تبدأ بأبي ويختزل بقيّتها اسم عائلته. هذا السؤال لا يزال يستفزّني ولا أزال أفكّر في جوابه كلّ مرة يُطرح فيها عليّ. وقد قرّرت أخيراً أنّي أنا وفقط أنا، وقد أضيف مدينتي لأنّي أحبّها ولأنّي لا أعرف ما معني سوريّ أو عربيّ أو شرقيّ أو مسلم أو حتى حمصيّ (فأنا من مدينة حمص). لكنّ السائل سيلحّ بالسؤال ليعرف الأب والعائلة فهما بالنسبة له أو لها هويتي. وما لم أعطه مكوّنات هويتي كاملة فإنّي أظلّ بالنسبة له غامضاً أجنبياً غريباً مجهول الأصل والنسب، أي أقلّ من عضو كامل في المجتمع. كان العرب الفاتحون القدماء يعتقدون أنّ من لا نسب له لا وجود له، وكانوا يحتقرون الفلاحين وأهل البلدات لأنهم ينتسبون إلى قريتهم أو بلدتهم (مصدري: قراءات متفرقة في طبقات ابن سعد). هذا النسب القصير (أي القرية) الذي لا يختزل أية سلسلة من الذكور تعود إلى الجدّ العاشر أو العشرين أو عدنان وقحطان أو حتى آدم. هذا النسب يتساوى فيه كلّ أهل القرية. النسب الذي يتّسع لعدة أشخاص ليس بنسب ولا يحدّد الإنسان، فهو إذن دون قيمة تذكر في مجتمع أبويّ عشائري. ومرّة قدّمت نفسي كما تقتضي العادة لكنّ السائلين، وبينهم رجال ونساء، صرخوا وكأنهم يكتشفون ذهباً: “أنت ابن فلانة” فقد عرفوها كصديقة وزميلة عمل. ضعت ساعتها بين شعور بالسعادة وشعور بالحياء، فالأمّ جزء من شرف الرجل وحتى الولد المراهق، ولا يمكن المساس بها حتى بذكر اسمها، لا سيما في مكان عمومي كالشارع مثلاً. وأن تُعرف بأمّك يحوّلك إلى يتيم غريب لا أب لك ولا نسب، ولا يمكن فهمه إلا كشتيمة.
خلال العشرين سنة الماضية عدت بالفكر إلى هذه اللحظة السريعة التي أصبحت محور بحثي عن الجزء المظلم، الغائب، المغيّب، المخبوء، المحجوب، المنسيّ، الذاتيّ كالسرّ في حياتي، والذي هو أمّي؛ وعن كلّ النساء اللواتي ضعن في خلفية صورة الذكر الذي هو أنا. فضائلي ومثالبي تُشرح بكوني ابن فلان. أنا صورة عن أبي، هو خلقني على صورته وربّاني على صورته. يكفي أن يُعرف أبي حتى أُعرف أنا. فأين هي أمّي؟ هذا سؤال صار أشد إلحاحاً حين توفّيت. السؤال الكونيّ “أين يذهب الميّت؟” أصبح بذهاب الجسد السؤال النرجسيّ “أين هذا الجزء منّي التي مات جسدها؟” البحث عن الأمّ المفقودة أصبح بحثاً عن الذات العميقة المنسية اللاواعية المرتبطة بالطفولة والتي غيّبها الانتقال إلى الرجولة. غريب هذا الإنسان. يعيش طفولته ليكبر وينساها (أي الطفولة والأمّ) ويصبح رجلاً (غاية المنى!!) ثم يمضي شبابه وكهولته ليستردّ طفولته. الجزء المظلم والغامض في حياتي هو بين ولادتي ومراهقتي وهو أمّي. عندما يكبر الذكر العربيّ ينسى أو يتناسى هذه السنين ويردّ كلّ صفاته حسنها قبيحها إلى أبيه، فهو ابن لأبيه ولا يكون ابناً لأمّه إلى وراء الأبواب المغلقة. أنبش في ذاتي لأستردّ أمّي ولأستردّ جزءاً من ذاتي. الأمّ هي الداخل والأب هو الخارج، الأم هي الحقيقة الخفية والأب هو القناع، الأم هي لغة اللاوعي والأحلام والشعور والأب هو لغة الكلمات والوعي والعقل.
يتابع أدونيس شارحاً بعفويةٍ وصدقِ أحاسيسه وتصوّراته حول دور أمه في حياته فيقول: “كنت في الثالثة عشرة من عمري عندما تركت البيت وانفصلت عنها. لم أعد أراها إلا قليلاً في العُطَل المدرسية. حتى في طفولتي كان أبي هو الذي يدير شؤون «ثقافتي» أو «تربيتي العقلية»، وكانت أمي هي التي تدير شؤون الحياة اليومية. هي في حياتي، منذ البداية، جزءٌ من «الطبيعة»، لا من «الثقافة». تصبح جزءاً من «الثقافة» عندما تبلغ مرحلة الشيخوخة، وهذا ما أكتشفه اليوم”. لا أعتقد أنّ الشاعر انفصل عن أمّه بسبب ذهابه إلى مدرسة المدينة وإنما زمن الانفصال كان قد حان كما يحين في حياة كل صبيّ عربيّ. والذكرى الباقية هي ذكرى الانطلاق إلى عالم الرجل الفسيح وليست ذكرى هجر عالم الأم الذاتي الخصوصي. على الأقل هذه هي الذكرى التي أفصح عنها الشاعر-الذكر أمام محاوريه ومستمعيه من الذكور أيضاً. ما الذي فرض تقسيم العمل هذا: الأب يدير شؤون العقل والثقافة والأم تدير شؤون البيت والحياة اليومية؟ بالطبع أمّ الشاعر لا تقرأ ولا تكتب، وبالتالي فهي لا تتدخل في “شؤون الثقافة”. وقد تردّد هي ذلك على أسماع الجميع من الذكور خاصة. وليس هذا من باب اعتراف المرأة بضيق المعرفة، وإنما خضوعا للأمر الواقع الذي أنتج هذا الاختلاف بين الأب المتعلّم والأمّ الأمّية، الواقع الذي فصل مجال المعرفة (ولنقل اللغة والثقافة) ومجال الحياة اليومية (ولنقل العمل الآلي والطبيعة والوجود) فأعطى الأوّل للرجل وحصر المرأة في الثاني. قد تكون الأم لعبت دوراً حقيقياً في تثقيف الشاعر من خلال مراقبة دراسته، وتشجيعه حين تملّكه الشك، وشدّ عزيمته حينما وهنت، وتذكيره بما ينتظره من أبواب الفرص (كرجل طبعاً) إن هو تعلّم، وتجديد قواه بكوب من الشاي في الوقت المناسب وعشاء دسم في اليوم المناسب. ألم تكن الأمّ تعرف أهميّة كلّ موضوع وكلّ امتحان حتى توقّت كلمات التشجيع وأكواب الشاي والوجبات المغذيّة. الأم دفعته ليكون رجلاً ومن ثم تراجعت إلى الخلفية ليزداد تألّقه. وأعتقد أنّ محبّي فلسفة لاكان ودريدا سيجدون متعة استثنائية في تحليل المعارضة بين الطبيعة كرمز ومجال للأم والثقافة كرمز ومجال للأب.
وردّاً على تساؤل المحاور عمّا إذا كانت الأمّ بالنسبة للشاعر مجرّد فكرة، وعمّا إذا كان قد كتب قصيدة عنها، يقول أدونيس: “الأم مبثوثة في الكتابة، بالنسبة إليّ، كمثل الهواء والشمس والماء. ذائبة في حياتي وفكري. ليست كائناً مفرداً، مستقلاً، منفصلاً، كأنّه شيء أو موضوعٌ خارجي. هكذا لم أكتب عنها بالاسم، وإنما أشرت إليها. لا أقدر أن أحوّلها إلى موضوع «إنشاء» مدرسيّ، كالربيع والخريف، أو الوطن، أو غيرها. ولا أعرف كيف يمكن لشاعر أن يكتب عن الأمّ، بوصفها «موضوعاً» أو «شيئاً»، يُناجيه، ويصفه، ويمتدحه، أو يعدّد مآثره وعلاقاته بها.” لكنّ المحاور الذكيّ عاجله بمثال قصيدة محمود درويش عن أمّه (أحنّ إلى خبز أمي) فأجاب الشاعر باقتضاب: “هذا البكاء الشعري، بالأحرى يضحكني”. “الأم مبثوثة” لا كينونة لها ولا شكل “مثل الهواء”. هي “ذائبة” لا قوام لها ولا حدود. “ليست كائناً منفرداً مستقلاً” كأيّ شيء خارجيّ. لم لا؟ لماذا لا تكون الأمّ منفردة بذاتها مستقلة بكيانها؟ هل الانفصال والاستقلال خارج ذات الرجل يعني مباشرة تحوّلها إلى “شيء” أو “موضوع”؟ لماذا لا تكون موضوع إنشاء مدرسي نناجيه ونصفه ونمدحه ونعدّد مآثره؟ أيجب أن نعيد الكلام عن الأمّ إلى عالم الأطفال والمدرسة؟ أليس الإنشاء المدرسي أكثر عفوية من شعر الحداثة؟ لماذا نكمّم فم الطفل فينا لأنه سيتحدث عن أمه، ألسنا نكمّم بهذا فم الأمّ نفسها؟ ألسنا نعيدها إلى ظلام النسيان، ظلام الطفولة ومرحلة ما قبل تحقيق الرجولة؟ هل تجُبّ الرجولة كل ما قبلها كما يجُبّ الإسلام ما قبله من ظلام الجاهلية؟ التبعية والضدية، هذا ما طرحته في البداية كوصف لحالة الأم والمرأة عموماً. هي تابعة لأنها لا يمكن أن تكون مستقلة، في ذهن الرجل. هي صنو الطفولة وضد الرجولة، تعيش في الظلام (أي ظل الرجل) بينما يعيش الرجل في الضوء، تعيش في اللاوعي المغيّب، بينما يعيش الأب في الوعي والعقل. هي العاطفة المبثوثة الغائمة التي يصعب التعبير عنها، بينما الرجل والأب هما اللغة والفصاحة ودقة التعبير. لا توجد الأم إلا في عالم الأطفال. لغة المدح والوصف وتعداد المآثر وحتى المناجاة الموجهة إلى الأم هي بكاء شعري مضحك. البكاء صنو العاطفة والبكاء الشعري صنو الموسيقى وكلاهما مضحكان في عالم الشعر النثري الحديث، الذي هو وعاء العقل والثقافة والفلسفة حيث لا مكان للأطفال والأمهات. من يتحدث عن أمه يصبح طفلاً يبكي وهو في نظر الرجل الكبير مضحك، لا عقلاني، مفرط العاطفة، مؤنّث. الصبيّ مؤنّث إلى أن يترك عالم الأمّ ويهجره وينبذه وينساه (في وعيه) فيصبح عندها رجلاً مذكّراً، متّزناً، عقلانياً، متحكّماً بمشاعره أو بعبارة أخرى غير مضحك. والمرأة خارج تبعيتها للرجل شيء وموضوع، أي دون روح، مكشوف لكلّ من يريد النظر والفحص. المرأة تصبح عندها شيئاً معروضاً وعرضة للنهب. واسمحوا لي باللعب على الألفاظ: العِرض، وهو المرأة، لا يُعرَض حتى لا يصبح عُرضة للنهب. كلّ هذه الكلمات من جذر واحد أساسه جانب الحيوان. فعَرض الحيوان هو كلّ جسده وإذا لم يواجه الحيوانُ الصيادَ وجهاً لوجه فقد أعطاه عرضه أي جانبه. عندها يستطيع الصياد بسهولة أن يصيبه بمقتل. فالعَرض هو كشف الجسد كله (معروض، معترِض) وهو ما يجعل الحيوان فريسة سهلة (أي عرضة للنهب). والمرأة هي عَرض الرجل وعِرضه وحيث يصاب بمقتل إذا انكشف هذا العَرض (أي أصبح معروضاً).
تصبح الأمّ “جزءاً من «الثقافة» [أي الوعي ومحل الاهتمام] عندما تبلغ مرحلة الشيخوخة” لأنها فجأة تتحوّل إلى إنسانة لها حاجات وتحتاج إلى إعالة، ولأنّ الطفل ليس بحاجة إليها فقد أصبح رجلاً. فهي الآن منفصلة (دون أن تكون مستقلّة) دون اختيار منها، فيمكن أن تصبح حسب المنطق السالف الذكر “موضوع إنشاء”، أي يمكن أن تصبح موضوع حديث ونقاش، حديث “أين نذهب بها؟” و”كيف نعيلها؟”. الحديث عنها لا يأخذها بكليتها كإنسانة كاملة، لكن فقط كجسد، أي “كشيء”. “في شيخوختها” تصبح الأمّ جزءاً من الوعي والمفكَّر فيه لأنّها بجسدها الواهن لم تعد تستطيع أن تتراجع إلى الخلفية. هي الآن عالة وليست فرداً مستقلاً. وهي حين تحصل على الانفصال عن الذكر تفقد استقلالها. لا ألوم الشاعر فيما قاله بأيّ شكل من الأشكال، فهو قد عبّر عن نفسه بصدق وشفافية. ولا أشك في حبّه لأمّه وحرصه على رعايتها في شيخوختها بما يحافظ على كرامتها كإنسانة. لكنه في شفافيته وصدقه عبّر عن مجتمع كامل وثقافة كاملة لا ترى في المرأة إلا تابعاً لا هوية له، لا بل ضداً لكل ما يكوّن الرجل ويعرّفه.
اعتقد المصريون القدماء أن الإنسان روح وجسد، وأنّ الروح مكوّنة من خمسة عناصر أساسية: الاسم (وبنسيانه لا تمكن الحياة الأبدية)، الظل، القلب (مركز النوايا والأفكار، أي العقل)، القوة الفاعلة (وقوامها بالغذاء)، والشخصية (أي ما يميز الفرد عن الآخر، والجزء الوحيد الذي يترك الجسد بالموت). فهل الأمّ العربية إنسانة؟ اسمها غائب مغيّب، ولا ظل لها فهي تعيش في ظلّ الرجل، لا لغة لها فهي وجود مطلق دون كلمات، ولا فعل لها إلا في الطفولة المنسية وداخل خباء البيت، أما شخصيتها فهي مميّعة في شخصية الجماعة أو مضافة إلى شخصية الرجل. أما جسدها فلا يصبح شيئاً إلا حين تشيخ وتفقد استقلالها وإن حصلت (دون خيار) على انفصالها. إذا أردنا أن تعود الأم إلى الحياة وأن تحيا أبداً فلا بدّ من ذكر اسمها وتكرار ذكره، لا بدّ من إخراجها إلى النور حتى يكون لها ظلّ. هي ليست “طبيعة أو هواء أو شجرة”، ليست عنصراً أساسياً بدائياً كالعناصر الأربعة. هي امرأة ولها اسم وشخص وفكر وعمل ورأي وأحاسيس (قلب وقوة فاعلة وشخصية). هي إنسانة بمحاسن ومثالب، تغضب وتحنو، تصيب وتخطئ، تحبّ وتكره، تقسو وتعطف. هي ليست صورة مثالية للحنان والعطف والحب والأمومة والأنوثة مهما كانت معاني هذه الكلمات.
تابعونا على صفحات وسائط التواصل الإجتماعي: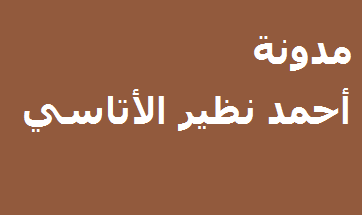

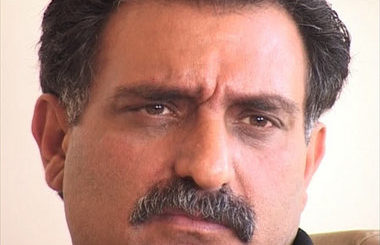


 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات