اليسار الجديد 1 – أسس نظرية

ظهر المقال على موقع الرأي الذي يشرف عليه حزب الشعب الديمقراطي السوري في 1- ديسمبر، 2011
ظهر المقال على موقع المجلة الدولية لدراسات الثورة السورية (مغلق، الرابط يشير إلى كاش غوغل) في 10 ديسمبر، 2011
حال اليسار الآن: لا يمكن إنكار يُتم اليسار العالمي بعد سقوط الإتحاد السوفياتي والنظرية الشيوعية معه، أو على الأقل إحساسه باليتم. لا بل كثيرين أصيبوا بدوار أيديولوجي فإما انقلبوا من اليسار إلى اليمين في ليلة غير مقمرة أو تمسكوا بالمبادئ الشيوعية أو الإشتراكية من باب أن المبادئ أزلية لا تتغير وإلا فإنها ليست مبادئ ومن باب أن تغيير المبادئ ليس إلا إنتهازية فكرية. لكن هناك من حاول مراجعة تاريخه النضالي علّه يستشف مكامن الخطأ أو مكامن الضعف التي أدت إلى السقوط والإنحسار. واليوم لانجد في الميدان إلا اليمين الديني أو اليمين الرأسمالي يمجدان انتصارهما في تلك المعركة الأزلية بين الخير والشر، أو هكذا يرونها. أما فلول اليسار فتراوح بين العداء الغريزي للرأسمالية الأمريكية، خاصة بصيغتها المعولمة، وبين عبادة الديمقراطية التي أنتجتها الليبرالية الغربية معتبرينها نمطاً كونياً وجادة الصواب التي عادوا إليها بعد مغامرتهم الإشتراكية الشبابية. وقد ينأى البعض عن قطبي المراوحة هذين فيخرج من الإطار الأيديولوجي تماماً متجهاً إلى صوفية الدفاع عن حقوق الإنسان، إذ لا يُلدغ المؤمن من جحره مرتين، أو هكذا يهيؤ لهم. لكن وبعد الأزمة الإقتصادية الحادة التي ضربت، وأعني ضربت، كل صقع من أصقاع البسيطة بدءاً من فضيحة القروض المصرفية الأمريكية عام 2008، نجد أن حراكاً يسارياً بدأ يعود بخجل إلى الظهور (كحركة “إحتل ______” حيث يُملأ الفراغ بإسم المدينة “الثائرة” أو “المستعادة المحررة”). لكن هذا الحراك له صيغ محلية تختلف عن معاداة العولمة التي ظهرت في التسعينات والتي أرادت لنفسها أن تكون حركة عالمية تعيد اليسار إلى مسرح الأحداث لكن تحولت إلى نزعات وطنية تحلم بأصالة مزعومة تناضل ضد ثقافة اللون الواحد لأمريكية المكدونالد وبنطلونات الجينز ومولات التسوق.
الربيع العربي واليسار الجديد: قبل البدء في التأسيس لليسار الجديد المعلَن عنه في العنوان، لا بد أن نسال السؤال الآني الملح: هل تحيلنا هذه المقدمة عن اليسار العالمي إلى الربيع العربي؟ وهل هذا الربيع ميلاد لليسار الجديد الذي أتكلم عنه؟ لا، لا أعتقد أن الربيع العربي ميلاد ليسار جديد، لكن المؤرخين بعد مئة سنة من الآن قد يخالفونني الرأي، وهذا ما أتمناه، بأن يصنفوا الربيع العربي ضمن الأسباب غير المباشرة لظهور اليسار الجديد الذي أعتقد أنه سيظهر بعد عقد أو عقدين من الزمن. وكحال الحراك الجديد الذي تكلمت عنه (والذي يبدو أن الربيع العربي كان أحد ملهِميه) فإن اهتماماتي محلية. فأنا أريد لليسار العربي الجديد أن يحتل مكانه المناسب في مرحلة مابعد سقوط الديكتاتوريات حيث تسرح تيارات التدين السياسي وتمرح لانعدام البديل أو حتى لانعدام المُناظِر أو المُعارِض أو المُحاوِر. ولا أريد أن يتحول اليسار العربي إلى مجرد استماتة في سبيل العلمانية التي لم ينجح هو ولم تنجح قبله الليبرالية الغربية التي أنتجتها في تعريفها أو في تحويلها إلى أيديولوجيا متكاملة فتوقفت عند مستوى الهوية. وكيف لفصل الدين عن الدولة، هذه الفكرة الإدارية القانونية، أن تتحول إلى مخطط عمل؟ لقد تحول اليسار العالمي والعربي ضمنه بعد سقوط الشيوعية، نعم لقد سقطت، إلى حالة أدنى من حالة الشرنقة التي تتطور باتجاه إنتاج فراشة زاهية الألوان. لقد تقلبت هذه الشرنقة بين حالات “شرنقية”، إذا صح القول، عديدة كما بينت سالفاً ولم تنجح في إنتاج ولو فراشة مهيضة الجناح أو باهتة الألوان. ولا ضير أن أحاول إنعاش اليسار لاعتراضي على مشاريع التدين السياسي فالأفكار دائماً تُعرّف نفسها بالتضاد مع أفكار أخرى. والضد يُظهر حسنه الضد، ونعود إلى جدلية شيخنا ماركس، أليس كذلك؟ هذه المقالة هي الأولى في سلسلة مقالات تحاول وضع الملامح الأولى لإطار نظري لهذا اليسار الجديد الذي أتكلم عنه. كما تحاول تحديد الإطار التنظيمي والمطلبي العملي لهذا اليسار ضمن السياق التاريخي الذي نعيشه مع الإحتفاظ بمرونة كافية لتغيير الأفكار بالتوازي مع تغير السياق التارخي المحيط. وهذه المقالة الأولى مخصصة لتوضيح بعض المفاهيم ولتحديد بعض الأسس النظرية التي سأستعملها في المقالات المقبلة.
الأيديولوجيا: أولاً لا بد من تعريف الأيديولوجيا. زعم ماركس بأن الأيديولوجيا هي بنية فوقية، أي فكرية (قانونية ودينية وسياسية)، تبرر للطبقة المسيطِرة على وسائل الإنتاج، أي على البنية التحتية المادية الملموسة، سيطرتها هذه. وقد تعمم هذا الفهم للأيديولوجيا في الأوساط الأكاديمية والمثقفة والشعبية، خاصة في الغرب، وصار مرادفاً لمفهوم الرياء والكذب السياسي والفكري. لن أستخدم مفهوم الأيديولوجيا بهذا المعنى ولا بالمعنى الماركسي. الأيديولوجيا كما أعرّفها هي مجموعة من الأفكار التي تشرح حالة إجتماعية ما، وتعطي رؤية مستقبلية لهذه الحالة، وتحدد طريقاً لتحقيق هذه الرؤية. حسب هذا التعريف يبقى الدين أيديولوجيا كما وصفه ماركس لكن تصبح الشيوعية أيضاً مجرد أيديولوجيا وكذلك الليبرالية. نعم يمكن أن نرى الأيديولوجيا كبنية فوقية لحالة واقعية قائمة، لكن لا تقتصر على الحكم أو السيطرة على وسائل الإنتاج بل تشمل الحلول الإنسانية لأية مشكلة إجتماعية، تلك الحلول التي لا تقوم على أساس البحث المنهجي المتواصل باتباع الطريقة العلمية من ملاحظة وفرضية وجمع معلومات معبرة عن الواقع وفحص للفرضية على ضوء هذه المعلومات. فمثلاً إذا اعتقدنا بوجود تعدّ للغة المحكية على العربية الفصحى ورأينا ان الحل هو في تمكين الفصحى وحمايتها بقوة الدولة ونظامها التعليمي فنحن أمام أيديولوجيا. فالحالة اللغوية في أي مجتمع أعقد بكثير من مجر تعدّ للغة الكلام المنبوذة نخبوياً على لغة الكتابة الرسمية، خاصة إذا كانت لغة دينية مقدسة كالعربية. كما لا توجد أية دراسات أو إحصائيات ترسم صورة متكاملة ومحايدة للحالة اللغوية. والحل بالطبع هو مجرد تجميل وتعظيم للفصحى وفرض لها بسلطة الدولة تقوم به نخبة تعتبر نفسها طليعية وأعلَم بما يصلح للناس أكثر من أنفسهم. وفي الحقيقة، خارج مخابر البحث العلمي، فإن الأيديولوجيا هي الطريقة السائدة في شرح أية مشكلة إجتماعية وفي حلها. وهي المرتع الأمثل للسياسيين الذين يعِدون مريديهم بالخلاص وإحلال العدل. أي أن الأيديولوجيا تحتوي في بنيتها على فكرة مهدوية حيث يتحقق الخلاص بتطبيق الحلول التي تقدمها الأيديولوجيا. لكن لماذا بدأت بتعريف الأيديولوجيا؟ أولاً لأصف أكبر خطر يهدد أي مشروع فكري يعمل على صياغة المستقبل. المستقبل في عالم الغيب ومن الصعب صياغته صياغة كاملة، لكن لا بد من المحاولة. لذلك وجب التنويه إلى أن أية إعادة لصياغة الفكر اليساري ستحمل بذور الأيديولوجيا فيها. لا بل إن بعض المقترحات المطلبية التي سأقدمها في مقالاتي اللاحقة ستكون أيديولوجية صرفة، بمعنى أنها تقوم على حدس واستقراء غير منهجي للمعطيات التاريخية. وحتى الإستقراء المنهجي لا يحمينا تماماً من الأيديولوجيا لأن العلوم الإجتماعية ليس فيها تجارب مخبرية يتحكم الباحث بكل مكوناتها؛ كما أنه ليس من المؤكد حتى الآن أن الظواهر الإجتماعية محكومة بقوانين حتمية كما هي ظواهر الفيزياء النيوتوني مثلاً.
نبذ الحقيقة المطلقة: هذا يعني أنني لا أدّعي العلمية كما ادّعاها ماركس ولا أعمل على بناء نظرية متكاملة تقدم الحلول لكل مشاكل المجتمع، ولن أحاول بناءها حتى. وأتمنى أن يبتعد الفكر اليساري الجديد عن هكذا محاولات. وأعتقد أن الجهد النظري يجب أن يكون مستمراً دائم التغير ودائم التشكيك بنتائجه وأن لا يصل أبداً إلى درجة الإيمان المطلق. إن أية رؤية للمستقبل هي تصور للواقع كما يجب أن يكون، وباعتبار أن هذا الواقع ليس كائناً بعد، فإن هذه الرؤى المستقبلية هي مجرد أحلام ووعود وردية، وبالتالي فإن كل رؤية للمستقبل هي أيديولوجيا أو فيها الكثير من الأيديولوجيا. لكن كما ذكرت، لا يستطيع الإنسان الإفلات من الأيديولوجيا إفلاتاً كاملاً وإنما يستطيع أن يحافظ على مرونة فكرية تقبل التغيير وإعادة النظر وتحويل المسار. إن الإيمان المطلق برؤية معينة للمستقبل هو إيمان أيديولوجي، وأرى أن اليسار الجديد يستطيع أن يحافظ على حد أدنى من المرونة حتى لا يقع في مستنقعات الجمود العقائدي. هذا الجمود الذي كان سمة للشيوعية كما هو أيضاً سمة للتدين السياسي. وليس هذا ضعفاً تكتيكياً أو تخبطاً في النسبية الفكرية، إذ يمكن للإنسان أن يثق برؤيته إلى حد كبير وأن يثق بصلاحيتها كتحليل للمجتمع وكمشروع لمستقبل هذا المجتمع، لكن الطامة الكبرى تحدث حين يؤمن الإنسان بأن رؤيته هي الصحيحة وبانها الوحيدة التي تصلح حلاً للمشكلة وبانها صالحة لكل زمان ومكان.
مسمى اليسار الجديد: ثانياً، لماذا هذا التعلق باليسار، أو على الأقل الكلمة؟ ولماذا هذا الأمل المهدوي الذي ينتظر عودة المخلص ليملاً الأرض عدلاً؟ في الحقيقة، أنا أكثر ارتياباً وتشكيكاً من أن أؤمن بأي مهدي مخلص؛ ولا يهمني في حال من الأحوال أن أحتفظ بتسمية اليسار، ذلك الخير المطلق الذي لا يموت والذي يتكسر على صخرته الشر المطلق الذي يمثله اليمين بأشكاله. خرّق خرّق، كما قال الجاحظ. اللغة أداة تعبير محدودة بطبيعتها وتعيد إستهلاك الكلمات التي فقدت معانيها، مثل اليسار. ولو عدنا إلى أصل التسمية وهي مكان جلوس اليعاقبة في المجلس الوطني أثناء الثورة الفرنسية، أي يسار المجلس، لوجدنا أن الكلمة بدأت بداية ثورجية مخزية باعتبار أن اليعاقبة لم يكونوا أقل من البرجوازية والملكية تطرفاً وعنفاً، لا بل إن البرجوازية أبدت مرونة أكبر قد تشرح سبب انتصارها وتحويلها للثورة الفرنسية من ثورة شعبية شعبوية إلى ثورة ليبرالية نخبوية. والإسم في الحقيقة يعبر عن الحالة الفكرية التي سادت من أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف العشرين. هذه الحالة التي تمجد الثورة كوسيلة وحيدة لإحداث التغيير في المجتمع، وترى الثورة تغييراً جذرياً وعنفياً في أغلب الأحيان. ولا نزال نرى من يعتقد أن الثورة السورية مثلاً ليست ثورة حقيقية لأنها لا تطلب بالتغيير الجذري للمجتمع ولنمط الإنتاج ولا تستخدم العنف الثوري ولا فكرة الحزب الطليعي القائد ولا الشرعية الثورية، بل ترى الشرعية في صناديق الإقتراع. وهذه الحالة الفكرية ليست سائدة عامة الآن. لكن ما يبرر تعلقي بالإسم، اليسار، هو تاريخه الطويل في المطالبة بالتغيير وفي مجابهة العقليات المحافظة بكل أنماطها. لكن لن أدخل في معركة لغوية تاريخية لأنسُب تاريخ الكلمة بأكمله لفكرتي التي سأطرحها هنا، وسأترك هذه المناظرات الأيديولوجية لغيري إن قيّض لفكرتي أن تحظى ببعض الشعبية. اليسار الجديد إذاً.
ثنائية المحافظة والتغيير: ثالثاً، وباعتبار أني عارضت اليمين المحافظ باليسار المطالب بالتغيير، دعوني أبدأ بثنوية تبسيطية هي الأساس النظري الذي تكلمت عنه في البداية. أنا، ولا ضير من الأنا هنا فلا أزعم الكونية أوالعمومية، أعتقد أن أغلب الناس محافظون مقلدون وأقليتهم مجددون مغيّرون. الطبيعة نفسها تميل إلى المحافظة فهي لا تثور أبداً على تاريخها وما راكمته خلاله وإنما تبني عليه. ولمن يعتقد بكمال الإنسان كمنظومة طبيعية، أعتذر عن إزعاجك إذ ليس الإنسان إلا تراكما بطيئاً لتغيرات طفيفة وحلول جزئية لمشكلة صراع البقاء بين الكائن والوسط المحيط. الطفرات ثورية، وإن كانت عشوائية إلى حد ما، لكنها تراكمات على أرضية الموجود تؤدي مع الزمن إلى نقلة نوعية. ونعود إلى شيخنا ماركس مرة ثانية. الطبيعة لا تُعيد تصميم الكائن الحي ليتلائم مع الوسط فهذا يقلل من مرونته وقدرته على التلاؤم وإنما تضيف إليه حلولاً مؤقتة تُراكمها فوق حلول مؤقتة سابقة فاعلة أو معطّلَة. فالتصميم الذي يناسب وسطاً معيناً فقط سيموت حتماً إذا تغير هذا الوسط. والتغير سنة الكون. إذاً، وهذا ليس إثباتاً علمياً، يجب الجمع في اعتقادي بين المحافظة والتغيير وبين الثوري والتقليدي. وهنا أنفصل تماماً عن ماركس الذي كان يحلم بنظام ينتهي معه التاريخ أو يصبح التاريخ به روتيناً يعيد نفسه كما يعتقد فوكوياما بانتهاء التاريخ مع النظام الأمريكي وكأنه يقول “ما في أحسن من هيك”. التاريخ لن ينتهي إلا بانطفاء الشمس، ولا يوجد نظام للمجتمعات البشرية لا تتغير بعده أبداً معتبِرة أنها وصلت إلى الكمال أو إلى الخير المطلق أو إلى السعادة المطلقة التي حلم بها فلاسفة العصور الوسطى. إذاً باعتقادي لا توجد نهاية للتاريخ، ويجوز أيضاً أن البداية غير واضحة الملامح، وإنما توجد نزعة للإستمرار والمحافظة وأخرى للتغيير، نزعة للبناء ونزعة للتهديم. أليست هذه هي التهم التي نكيلها الواحد منا للآخر. اليمين بعتقد بأن اليسار ثورجي محترف للهدم، وهو محق في هذا، لكن لا تغيير دون هدم. واليسار يعتقد بان اليمين محافظ لا يبني ولا يغيّر ويقود حتماً إلى تهديم الذات بتصلبه وتعنته. في الحقيقة، وهذه كلمة لعمري أثقل مما أقدر على حمله، فإن اجتماع الإثنين هو ما يجعل المجتمعات الإنسانية مرنة قادرة على التأقلم تارة بالتقليد وتارة بالتغيير الثوري وتارة بالإثنين معاً في وقت واحد. باعتقادي لا يوجد نظام إجتماعي مثالي، فكما قلت لا توجد بداية ولا نهاية وأشكك كثيراً في مفهومي التقدم والتطور اللذين طلع بهما علينا التنوير الأوروبي واستعارهما ماركس دون كلمة شكر، لا بل بكل جحود ونكران للجميل. قد تتراكم المعارف لكني لا أعرف كيف أحدد التقدم وأعرّفه، ولذلك سأستغني عنه كمفهوم.
نقد اليسار القديم: وكيف لي أن أزعم إنتاج يسار جديد دون نقد اليسار القديم. وهنا يجدر بي القول بان الشيوعية كفكرة (إذ لم يتجاوز أي مجتمع مرحلة الإشتراكية حسب مقياس ماركس للتقدم) كانت مع التغيير لكن التغيير لمرة واحدة، يتحول بعدها المجتمع إلى قيود لا تحصى من الواجبات والتضحية بالفرد وحرياته في سبيل الجماعة. ولم ينتقل أي مجتمع من مرحلة الإشتراكية إلى مرحلة الشيوعية، ليس لخطأ في التنفيذ أو تقاعس في العمل، وإنما لاستحالة تجميد المجتمع وإيقاف تغيّره. لقد تحولت الإشتراكية إلى نتيجتها الطبيعية التي هي ديكتاتورية النخبة المتمثلة بالدولة التي يتحكم بها الحزب الطليعي. ورغم كل الأحلام الوردية التي أنتجتها الشيوعية الماركسية في مخيلات أجيال من الشباب المتوقد للتغير، إلا أنها لم تفعل أكثر من إعادة إنتاج النظام الأبوي الذي انتقدته انتقاداً لاذعاً على مقاس كبير، إنها أنتجت أبوية الدولة على المجتمع ووصاية النخبة الأقلية على الأكثرية الغارقة في بحر الواجبات. لقد كانت ديكتاتورية البروليتاريا وطليعتها المنظمة مجرد ديكتاتورية، والأنكى من هذا أن الديكتاتورية كانت في إسمها قبل أن تكون في بنيتها. ونحن الآن إذ نناضل من أجل نزع نير الديكتاتورية العسكرية التي جاءت تاريخياً في قطار ثورة النخبة الطليعية التي تبناها حزب البعث متأثراً ببعض الأفكار الماركسية، حري بنا أن نتعلق بالحرية، بحرية الفرد، تعلقنا بالحياة نفسها لأنها حياتنا وحياة أولادنا وأحفادنا من بعدنا وضمانة ديناميكية المجتمع ومرونته وبقاء طاقتة الخلاقة القادرة على حل مشاكله مهما كانت طبيعتها.
الحرية كمحرك للتغيير هي أساس اليسار الجديد: طيب، الحرية، وماذا بعد؟ هل نعود إلى الشعارات الطنانة الخاوية من المعنى؟ لا، هذه ليست حرية التحرر من الإستعمار أو حرية التحرر من إستعباد الديكتاتورية فقط، بل هي في جوهرها حرية الفرد في أن يكون ما يشاء وأن يفعل ما يشاء، حتى وإن شاء أن يكون يمينياً محافظاً!! إنها حرية وجود وكون قبل أن تكون حرية فعل. لكن أليست هذه هي الفردانية الليبرالية الكلاسيكية التي تتخذ من الفرد مركزاً للكون وتطالب بكسر كل القيود، خاصة الإقتصادية منها لتتبعها الحرية السياسية والفكرية؟ حرية الكون والفعل بمعناها الليبرالي هي أوجه من الحرية التي أتكلم عنها هنا، لكن هناك أوجه أخرى. ومن يريد أن يتابع النقاشات التي بدات في القرن التاسع عشر عن حدود حرية الفرد وتحجيمها حين تبدأ حرية الآخرين فإني أحيل القارئ إلى كتابات جون ستيوارت ميل المتاحة حالياً بترجمات عربية وتلاقي رواجاً كبيراً. لكن حتى ننتقل إلى أوجه أخرى للحرية فإني أني أزعم وأقبل دون برهان بأن تحجر المجتمع وانعدام فرص التغيير النابعة من حرية التفكير والكون والفعل تهدد المجتمع بأن ينفرط عقده وتنحل عراه أو بان يقضي على أبنائه في حرب على الذات تأكل الأخضر واليابس. وهذا يعطي معنى آخر للحرية، غير معناها الليبرالي الفرداني، وأعني المعنى الجمعي حيث تصبح الحرية القدرة على تحقيق التغيير (أي وجود إمكانية التغيير دون عائق ومن ثم نقل هذه الإمكانية إلى التحقيق بالفعل الجماعي). أنا لست ضد الحرية الفردانية وأتمنى أن يدعني الناس وشأني لأفعل ما أريد، لكن الفلسفة التي أطرحها هنا تهتم أيضاً بالحرية الجمعية، أي بإمكانية إزالة العوائق أمام التأقلم والتغيير وبإمكانية تحقيق هذا التغيير. وهذه الحرية الجمعية لها تطبيقها على المستوى الفردي، فالمحرك الاساسي للتغيير في المجتمع البشري هو الفكرة والقدرة على جعلها حقيقة، وهذا يتأتى من حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التصرف وحرية الإختيار. ونرمز لهذه الحرية بمفهوم حقوق الإنسان التي هي حقوقه كفرد. ثم هناك حرية التجمع وحرية المشاركة السياسية التي نرمز لها بحقوق المواطنة التي هي حقوق الإنسان كجزء من جماعة وهي بالتالي حقوق جمعية. وإني أرى أن حق المأوى والعمل والتعليم وحق المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وحق التكافل الإجتماعي جزء من هذه الحرية الجمعية التي هي أساس التغيير وأحياناً أهدافه. بينما نرمز للتقليد والإستمرار بمفهوم الواجبات. الواجبات هي الصمغ الذي يجمع المجتمع ويضمن استمراره وعدم وقوعه في الفوضى التي هي التغير المستمر غير المستقر على حال. أما الحرية فهي الجالبة لطفرات التغيير والميسّرة لعملها. بالنتيجة، أرى أن اليسار الجديد يجب أن ان يكون مع الحرية والحقوق، دون أن يرفض الواجبات.
الحرية والنسبية، الصراع والتغيير: إن كان كل فرد حراً أو كل جماعة حرة في وجودها وفعلها فإن هذه الحرية لا تعني أن نوافق على أفكار الجميع ونسبَح في نسبية لا معالم لها ولا حدود، وإنما تعني قبول الآخر كما هو وكما يحلو له أن يكون دون أن نرفض حقه في الوجود أو أن نقضي عليه أو يقضي علينا. لكن أليست هذه سفسطة تجعل كل شيء يشبه كل شيء آخر وتجعل قيمة أي شيء كقيمة أي شيء آخر؟ وكأننا نقرأ مقالة الجاحظ في الذبابة حيث حاجج ببراعة نفغ الذبابة وضررها في الوقت ذاته. إذا لم يكن هناك لا خير مطلق ولا شر مطلق فلم نُتعب أنفسنا بمحاولة التغيير؟ وما هذا الكلام عن الحرية إن كنا جميعاً، على اي طرف وقفنا، حبيسي نظرة ثنائية قيمية ضيقة (خير- شر مثلاً)؟ كيف نقبل وجود الآخر وفي الوقت نفسه نصفه بنعوت سلبية تعبر عن رفضنا له؟ وكيف نقبل حرية الآخر إذا كان فعله يهدد وجودنا وحريتنا وفعلنا يهدد حريته ووجوده؟ ألا نسعى جميعاً لمناغمة المجتمع حولنا وتحويله إلى نسق واحد متشابه ونمط واحد متجانس؟ كيف نترك مجالاً للتغيير ولدينا كبشر توق للمطلق وسعي لفرضه؟ في الحقيقة، فإن النظرة الثنائية القيمية للأشياء نظرة إنسانية لا فكاك منها، أساسها غريزة البقاء بإطلاق الأحكام على كل شيء حولنا، فالخير هو ما يدعم بقاءنا وبقاء أفكارنا والشر ما يهدده بالقضاء عليه. وإن قبولنا بالآخر المخالف المناقض لنا لا يعري الأشياء والأفعال من قيمتها التي نسبغها عليها والتي نعبر عنها بنعوت تفضيلية تفاضلية من نمط جيد-سيء، جميل-قبيح، خير-شر، نافع-ضار. هذا التناقض هو أساس التغيير، أي أن قبولنا بالآخر رغم رفضه قيمياً ومحاولتنا تغييره دون القضاء عليه قضاءاً مبرماً هو محرك التغيير. أي هو ما يجعل التغيير ممكناً والإستمرار المحافِظ ممكناً في الوقت ذاته. وما دام الضد في صراع مع ضده دون أن يقصيه تماماً، وماداما يتعاركان ويختلفان ويتفقان ليعودا فيختلفان بأشكال أخرى فإن سنة الحياة في التغيير والمحافظة تستمر. ما أعتقده جيداً الآن هو جيد وما أعتبره سيئاً هو سيء، لكن ضمن صراعي غير الإقصائي مع من يخالفني الرأي أصوغ تعايشاً مستداماً قادراً على إعادة إنتاج نفسه.ما هو اليسار الجديد إذاً؟ ويسأل سائل يتوق لاتباع هذا اليسار الجديد، وأين هي حلول المعضلات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية؟ وأين هي أدوية التعصب القومي والعرقي والطائفي والديني وما تؤدي إليه من تفرقة واحتكار للإمتيازات؟ وأين هو علاج أزمات الرأسمالية المتكررة دورياً وكأني أسمع ماركس من قبره يضحك ويقول ألم أقل لكم هذا؟ وأين هو علاج الحروب والنزاعات بين الدول والجماعات؟ وأين الإزدهار الإقتصادي والتعايش السلمي ووبناء المجتمع المتعاضد المتكافل والدولة التي تمثل شعبها وتعمل لخدمته؟ وماذا نفعل بمريدي الخلافة الناطقين باسم الإله المفسرين لكتابه وشريعته؟ وماذا نفعل بالإمبريالية الإقتصادية الأمريكية والإستعمار الإسرائيلي وتعصب الغرب له؟ وماذا نفعل بالقومية العربية والوحدة العربية؟ وهل نحن مع تضخم الدولة وسيطرتها على الإقتصاد وضمانها للرعاية الصحية والتقاعد، أم مع الرأسمالية على الطريقة الأمريكية التي تؤمن بإله السوق العادل الوازن بالقسط المجزي للمنتصر في المنافسة والمعاقب للمسفّ الذي يعيث في الأرض فساداً من قروش الوول ستريت والبورصات والبنوك العالمية؟ وماذا تقول في الديمقراطية كنظام سياسي أصبح معياراً عالمياً وفي حقوق الإنسان التي أصبحت المعيار العالمي الأخلاقي أيضاً؟ وماذا تقول في الليبرالية التي تهب على العالم العربي وفي العلمانية التي أصبحت نقيضاً للإسلام السياسي وفي الإسلام السياسي الذي يعد بحل كل المشاكل كما وعدت الشيوعية من قبله؟ أخشى أن أعدكم الكثير فأقع في مطب ما سبق من الأيديولوجيات وما سيأتي. أعتقد أن الجواب أيضاً في بقاء تلك الجدلية بين التغيير والتقليد وفي الحرية التي تضمن هذا البقاء. لكني أخشى كذلك أن أقع في مطب التبسيط الشديد أمام معضلات هي غاية في التعقيد. لا أعتقد بوجود حل شامل أو نظرية عامة تشرح وتقدم حلولاً لكل المشكلات السابقة الذكر. وأترك هذه المهمة للأيديولوجيات الخلاصية مثل الشيوعية أو الدين السياسي أو الديمقراطية. وكما زعمت بأن الخير والشر محدودان مكانياً وزمانياً ساقول بأن حلول أية معضلة محدودة في سياقها الزماني والمكاني ولا تقبل حلولاً ثابتة لا تتغير. ولذلك ساقتصر في مقالاتي اللاحقة على بعض المبادئ الموجهة للفكر وعلى بعض الأفكار التي أعتقد بأنها خلاصة التجربة البشرية في عصرها الصناعي ومابعده. وهنا يجدر التنويه إلى ان عمل اليسار الجديد القائم على التعايش بين الاضداد يكمن في العمل نحو هدف إنجاز تغييرٍ ما أكثر منه في الوصول إلى تغيير مطلق لا تغيير بعده.
(يتبع)
تابعونا على صفحات وسائط التواصل الإجتماعي: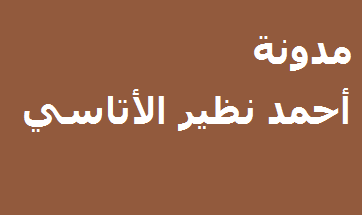


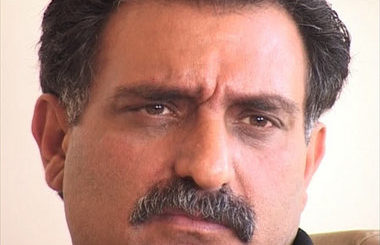

 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات