الشريعة والقانون في الثورة السورية

ظهر المقال على موقع المجلة الدولية لدراسات الثورة السورية في 21 سبتمبر، 2013
طالما كانت شعارات الثورة السورية بسيطة وموحدة كانت الأهداف واضحة وأقل إثارة للجدل والإختلاف، والحماسة الجماهيرية أكبر، والإنخراط في العمل التغييري أعم وأوسع. إنتقلت الثورة السورية في مراحلها المتعددة من شعارات الحرية والكرامة والوحدة الوطنية إلى شعارات إعلاء كلمة الله، فرض شرع الله، تجديد الدين وتصحيح العقيدة، والجهاد المستمر ضد الكفر المتمثل بالشيعة والعلويين والغرب ومايسمى بالبدع. هذا الإنتقال رافق الإنتقال إلى العنف وإن كان ليس نتيجة له. ونعتقد أن بذور الإنتقال كانت موجودة ومشجعيه موجودين إلا أن الدعم المادي الإسلامي المصدر أعطى دفعة كبيرة لهذا الإنتقال وأعطاه زخماً استطاع به فرض نفسه على الساحة السياسية والفكرية. هذا الإنتقال أدى إلى الفصل بين تيارين سياسيين أساسيين في الثورة هما التياران الإسلامي والعلماني، وإلى استقطاب أنصار الثورة بين هذين القطبين الذين أصبحا متصارعين ومتناقضين. إنعكس هذه التصارع سلباً على وحدة صف الثورة وعلى تطورها فجعل التعاطف الدولي صعباً وأخاف الرماديين أو الصامتين لأن القطبين أصبحا إقصائيين تجاه أحدهما الآخر. نعتبر هذه الإستقطاب عقبة أساسية أمام إستمرار الثورة ونجاحها وحظوظها بإنتاج مجتمع ودولة يتسعان للجميع ويوفران العدالة وتكافؤ الفرص للجميع. ولذلك وجب تحليل هذا الإستقطاب والخروج بتوصيات لتلافيه علها توضح الطريق إلى النجاح وتلقى أذناً صاغية من الطرفين. ولابد من التنويه هنا إلى أننا نتحدث عن العلمانية في الثورة السورية ولا نشمل بها مؤدي النظام الأسدي الذين لا يرون في العلمانية إلا العداء للإسلام فقط وحرية استهلاك المشروبات الكحولية ويطالبون بفصل الدين الإسلامي فقط عن الدولة. كما لا بد من التنويه إلى أننا نعني بالتيار الإسلامي هنا التيار السياسي الذي يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال الدولة أو بإقامة الدولة الدينية الإسلامية (أو ذات المرجعية الإسلامية على اختلاف تفسير هذاه المقولة) أو بإقامة الخلافة الإسلامية. ولا يدخل في هذا التعريف العالم الفقيه التقليدي غير المسيس أو المسلم العادي الذي لا يعتقد ان صحة إسلامه تمر من خلال الدولة الإسلامية.
سنتحدث في سلسلة مقالات عن القطبين السياسيين الإسلامي والعلماني (كأفكار وليس أشخاص محددين)، عن خصائص كل منهما، وعن المعوقات التي تفرضها بعض هذه الخصائص على نجاح الثورة، وعلى كيفية تذليل هذه العوائق وإحلال التوافق بين التيارين المذكورين. وسنبدأ هنا من إحدى الخطائص المشتركة بين التيارين، ونعني الجدل حول القانون الذي ستعتمده الدولة.
ففيما يخص قانون الدولة، فالتيار الإسلامي يعتقد بما يلي:
- بشرية القانون: ويعني هذا
- وضعية القانون وآنيته: أي أن القانون وضعي (من وضع البشر) ودنيوي وبشري وآني، وبالتالي فهو مشوه لارتباطه حسب زعمهم بالأهواء والشهوات الإنسانية المنحطة والآنية.
- قصور القانون: أي ضعفه ونقصه أمام الشريعة الإلهية المتفوقة بالمطلق لارتباطه بالمنطق الإنساني القاصر. ويصبح القانون قاصراً في مقاصده ومبادئه الفقهية وأحكامه وآليات تطبيقه. أما اقتصار الشريعة على بعض المجالات التي يغطيها القانون عادة فليس عائقاً امام الشريعة أو تقصيراً بسبب إحكام نصوصها وشمولية هذه النصوص في معانيها وقدرة أدوات الشريعة على استباط القوانين من هذه النصوص الشاملة.
- التعارض التام مع الشريعة: هذا يعني أنه لا تقاطع بين القانون والشريعة في المقاصد أو المبادئ أو الأحكام بل تعارض تام واستحالة الموافقة بينهما، فإما هذه أو ذاك.
- فساد القانون الحالي كليا: أي ارتباط القانون الحالي كلياً بالنظام الحاكم وبالتالي ضرورة التخلص منه نهائياً وكلياً. وهنا نرى ضمنياً مماهاة القانون الحالي بالقانون الوضعي وكأن وجود بعض الأحكام الجائرة في هذه القانون لا يفصله عن بقية القوانين الوضعية لأن سمة الجور متأصلة في القوانين الوضعية.
- إلهية الشريعة من مصدرها إلى أحكامها وتطبيقها: ويعني
هذا:
- لا مشرع إلا الله: وبالتالي فإن أي قانون حديث يصدره مجلس نيابي بشري هو عمل يتعدى فيه البشر على صفة إلهية لا يتمتع بها إلا الله وحده. وهنا يتم إلغاء مؤسسة مجلس الشعب المشرع الوحيد في الدولة الحديثة.
- أزلية الشريعة وتفوقها: إن إلهية الشريعة الإسلامية، وأزلية حكم الله الذي لا يتغير (غير وضعي)، يعني بالتالي تفوقها على أي قانون من مصدر بشري وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
- العدالة المطلقة: العدالة الإلهية مطلقة لا تتغير في الزمان أو المكان. أما الإختلاف ضمن أحكام الشريعة فهو محدود بحدود النصوص. وإذا لم يفهم البشر هذه العدالة فهذا من قصور منطقهم وما عليهم بالتالي إلا الخضوع والإذعان.
- للفقهاء دور ثانوي متمم: أي أن دور الفقهاء يصبح مكملاً لدور الإله وغير منتقص من كماله، فهم باستنباطهم للأحكام من النصوص يتابعون عمل الإله ويستخدمون الأساليب الإلهية نفسها، ويسنبطون الأحكام الإلهية التي لم يصرح بها النص الديني وإن كانت مستبطنة في معانيه. أما الناطق بالحكم فيصبح صوت الإله ومطبق الحكم يصبح يد الإله.
- المخالف لتمكين الشريعة كافر: أي أن كل مخالف لتمكين الشريعة وفرضها على المجتمع والدولة بقوة الدولة معاد لله وبالتالي كافر وبالتالي مستحق للموت أو النبذ من المجتمع والبلد.
- وحدة الشريعة وتكاملها: ويعني هذا
- وحدة الشريعة: أن الشريعة الإسلامية واحدة لا تتعدد ولا تتناقض (ولا يدخل في هذا المضمار إختلاف الفقهاء والمذاهب فهو ليس تناقض وإنما نعمة وتسهيل وله حدود).
- تحديد الشريعة: أي أنها تقتصر على المذاهب السنية الأربعة المعروفة في نسختها التي توقفت عندها في أواخر العصور الوسطى. ومن الصعب كذلك فتح باب لاإجتهاد الذي أغلق في تلك العصور.
- تكامل الشريعة: أي أنه لا يمكن الفصل بين النص الديني والمبدأ الفقهي والأحكام المستنبطة والإجراءات المتبعة والجهة المستنبطة أو المطبقة، فهي كل متكامل ينبع من بعضه ويغذي بعضه ويسبغ الشرعية الإلهية على مجموعه فلا يمكن اجتزاؤه والإقتصار على بعضه دون البقية الباقية.
- إرتباط الشريعة بالدولة: وهذا يعني:
- عدم الفصل بين الحُكم والحُكم (أو بين السلطات): الحُكم قديماً، سواءاً ألحقناه بالملك أو الخليفة أو الوالي أو القاضي فهو فصل بين متنازعين، أي هو بالمسى الحديث دور قضائي. ضمن هذه الفلسفة لا يوجد مشرع وإنما مستنبِط للأحكام أو الاصول (الذي هو الفقيه أو المفتي) ومطبق لهذه الأحكام (أي القاضي). وأحياناً يمكن تصور الخليفة على أنه مشرع ضمن حدود معينة وتحت مراقبة الفقهاء (نظرياً في الحقيقة، فالملوك والخلفاء كانوا دائماً مشرعين دون رقابة من أحد. فالدولة العثمانية مثلاً كان لديها الشريعة الإسلامية والقانون الذي هو قانون السلطان ولهذا سمي سليمان بالقانوني لأنه وضع القانون العثماني). وضمن هذا الإطار أيضاً لا فصل بين السلطات تشريعية والتنفيذية والقضائية، فالخليفة هو المشرع والقاضي والمنفذ، والفقيه قد يصبح قاضياً او مشرعاً. فما نسميه الحُكم في العصر الحديث (اي الدولة بسلطاتها الثلاثة المتنفصلة) يصبح مماثلاً للحُكم في العصر القديم وهو إما مؤسسة القضاء والتشريع (فقيه، مفتي، قاضي) أو مؤسسة الخلافة التي تجتمع فيها كل السلطات.
- لا مراقبة شعبية على المشرع: لأن المشرع هوالله. أما الفقيه في دوره التشريعي فهو مجرد متمم لعمل الإله. وهنا نرى أن الفكر السياسي الإسلامي الحالي لا يخرج عن فكرة ولاية الفقيه الكلية اي حكم الفقيه أو الجزئية أي مراقبة الفقيه للدولة دون وجود مراقبة بشرية عليه.
- ضرورة الدولة لتطبيق الشريعة: تعتقد معظم التيارات الإسلامية السياسية الحالية أن الإلتزام الفردي بالشريعة غير كاف وأن من واجب الدولة أن تضطلع بمهمة تطبيق الشريعة. وهذا يعني استخدام القوة الضاربة للدولة من شرطة وسجون ومؤسسة قضائية وجيش ومؤسسات رقابة من أجل تطبيق أحكام الشريعة سواءاً المتعلقة منها بالفرد أو بالمعاملات بين الأفراد أو بالمجتمع ككل أو بالدولة. يعني هذا أن الاخلاق تصبح مجالاً لسلطة الدولة وكذلك العبادات واللباس والأكل والفن والآداب. كما تصبح الدولة مجالاً لسلطة الشريعة كالحكومة والوزارات والرئاسة ومؤسسات الدولة والسياسة الخارجية والأحزاب والإنتخابات والجمعيات. وبهذا يصبح العقاب والإلزام احتكاراً للدين والدولة المتماهيين ومتغلغلاً في كل تفاصيل حياة الإنسان. وهذا مما يفرض التفكير بإمكانية جعل العدالة الإلهية دنيوية بحتة والعدالة الأخروية نافلة غير ضرورية.
- الدولة الدينية المتعالية: إن شرعية الدولة التي تطبق الشريعة لا تنبع من الشريعة نفسها وإنما من إلهية الشريعة لأنها تطبق قانون الإله، فتصبح يده. هذه الشرعية متعالية على المجتمع وعلى الزمن لا يمكن الإعتراض عليها وهي أزلية ما دامت الدولة تطبق الشريعة الأزلية. هذه الدولة لا شرعية لها إن طبقت القانون الوضعي.
- شمولية الشريعة: ونرى ذلك في شعار الإسلام دين ودولة (أو
دين ودنيا). ويعني هذا:
- تغطية أمور الدين: تغطي الشريعة العقيدة والشعائر والعبادات والصدقات والكفارات والأخلاق التي بها يصل المؤمن إلى النهاية الأخروية المرجوة.
- تغطية أمور الدنيا: تغطي الشريعة عادة الحلال والحرام (مباح، مستحب، مستحسن، مستقبح، حرام) من أفعال وأفكار وطعام وأيضاً العقود (ملكية، تجارة، زواج، شهادة) والمعاملات (تجارية ونقدية غالباً) والجنايات (قتل، سرقة، زنا) والاسرة (زواج، طلاق، ولاية، ميراث) وبعض أمور الحكم (طاعة الحاكم، خروج على الحاكم، خلافة، الخراج والمكوس، الملكية العامة) وعمل مؤسسة القضاء (الإفتاء، الجلوس للقضاء، الشهود، الأدلة) والفقه (المقاصد والأصول والفروع والمبادئ والأحكام).
- تغطية الدنيا قديمها وجديدها بكليتها: ويعلن الإسلاميون أن الشريعة قادرة على تغطية كل ما يستجد في حياة الناس سواءاً في علاقتهم ببعضهم البعض أو في علاقتهم بالدولة أو في أفعالهم الفردية. فمثلاً يعلنون وجود إقتصاد إسلامي (بنوك وبورصات) ودولة إسلانية ودستور إسلامي ومجلس تمثيلي إسلامي (شورى) وقانون جمعيات وأحزاب إسلامي وسياسة إسلامية وإدارة إسلامية للدولة والمؤسسات وحرب إسلامية؛ وحتى لباس إسلامي وعطر إسلامي وفن إسلامي وعمارة إسلامية وتلفزيون إسلامي وتعليم إسلامي وطب إسلامي وطريقة إسلامية في الكلام وإعلان حقوق إنسان إسلامي.
- المماهاة بين الشريعة والدين والدولة: باعتبار أن الشريعة شمولية بالمطلق فهي نفسها الدين الإسلامي فلا يوجد مسلم خارج الشريعة ولا إسلام خارج الشريعة ولا خلاص أخروي خارج الشريعة ولاحياة خارج الشريعة. كما لا يوجد مسلم خارج الدولة الإسلامية ولا دولة خارج الشريعة الإسلامية. ويمكن القول أنه لا يوجد إنسان متكامل الإنسانية خارج الإسلام وبالتالي خارج الشريعة وخارج الدولة الإسلامية.
أما التيار العلماني فيعتقد بالتالي:
- بشرية القانون: ويعني هذا
- ديناميكية القانون: أي ان القانون البشري ليس ثابتاً بل يتغير (من خلال المجلس التشريعي) ليلبي الحاجات المتغير للمجتمع البشري. هذا اعتراف بآنية القانون لكنه رفع من شأن الآنية مقابل أزلية الشريعة وبالتالي ما يوصف بجمودها وتحجرها وعدم تلبيتها للحاجات المتغيرة.
- تفوق القانون بمنطقه وديناميكيته: أي أن المنطق البشري متفوق على المنطق الشرعي الذي يعتمد على النص الديني الذي لا يتغير في صياغته وبالتالي في اعتماده الهائل على التفسير والتأويل. هذا المنطق البشري يتغير باتجاه تطوري نحو الأفضل وهو بالتالي نتاج الجهد البشري على طول التاريخ البشري. وبالتالي يصبح القانون متفوقاً على الشريعة في مقاصده ومبادئه الفقهية وأحكامه وآليات تطبيقه لأنه يتغير (وهي نصفها الصفة السلبية في القانون حسب الشريعة).
- حداثية القانون: يرتبط القانون الحديث بعصر التنوير الاوروبي والليبرالية الأوروبية التي نادت بأولية حقوق الإنسان (وأحياناً كونيتها وبهذا تقترب من الدين)، والإعتماد على العقلانية، وتنوع مصادر القانون (طبيعي، ديني، عقلاني، ثقافي). هذا القانون هو جزء من مشروع الحداثة التي نادى بها التنوير والليبرالية الأوروبية والتي أصبحت معياراً للقياس اليوم. هذا المشروع يماهي بين الحديث والجيد، بين التطور والتحسن والتقدم، بين البشري المتغير والديني المتحجر، بين القديم والجائر والمتخلف والهمجي، بين الغيبي واللاعقلاني، بين الدين والخضوع لسيطرة النص وسلطة علماء الدين.
- نسبية العدالة البشرية: العدالة البشرية نسبية تختلف حسب المكان والزمان والثقافة التي أنتجتها. فهي ليست مطلقة ولا أزلية (رغم ادعاء كونية حقوق الإنسان). لكن هذه النسبية التي يحتقرها الدين ويجعلها أساس قصور القانون البشري تحولت إلى سمة تفوق القانون البشري لأنه يحقق القبول والإجماع. إذا لم يعد الناس يفهمون الغرض من نص قانوني أو حكم فيمكن تغييره وبالتالي إعادة خلق الإجماع عليه. الخضوع (العبودية لله) في الدين فضيلة والخضوع في المذهب الحداثي عبودية لا تختلف عن العبودية للبشر.
- لا مشرع إلا ممثلو الشعب: لا يلغي هذا المبدأ حق الإله بالتشريع لكنه يفصل بين الدنيا والآخرة، فالدنيا مجال الإنسان وعدالة الإنسان، والآخرة مجال الإله وعدالة الإله. في هذه الدنيا يمتلك مجلس الشعب (المكون من منتخَبين يمثلون إرادة الشعب وإن نظرياً) وحده حق التشريع ضمن حدود البلد. لكن هذا المجلس يتغير وبالتالي يتغير المشروعون. ونعود هنا إلى نسبية العدالة البشرية التي أصبحت سمة تفوقها.
- فساد القانون الحالي جزئياً: القانون المتبع في سوريا صالح في معظم أجزائه، وما علينا إلا التخلص من القوانين الجائرة المرتبطة بالقمع واحتكار السلطة وربط الفرص وتوزيع الثروة بالنخبة الحاكمة.
- بشرية الشريعة في معظمها: ويعني هذا
- المشرّع البشري في الشريعة: ليس كل العلمانيين لادينيين وكثير منهم يعتقد بانتمائه لدين معين. ولذلك لا ينفون وجود نصوص تشريعية إلهية (الحدود المذكورة في القرآن مثلاً) لكنهم يعتقدون بأنها إما حد أعلى ليس من الضروري الوصول إليه إذا خالف ذلك معتقدات العصر، أو أنها توصيات إلهية متعلقة بالزمان والمكان وبالتالي قد لا تصلح لهذا العصر و/أو لهذا المكان. في هذه الحالة تصبح النصوص الدينية نسبية غير ازلية وتصبح مبادئ الشريعة وأحكامها التي استنبطها العلماء بشرية نسبية وبالتالي غير ملزِمة إلا لمن يؤمن بها كشريعة إلهية. هذا الإلزام لا يتعدى حدود إلتزام الفرد نفسه ولا يجب أن تكون الدولة طرفاً فيه وفارضاً له تحت وطئة العقوبة الدنيوية.
- نسبية الشريعة وقصورها وعدم حداثيتها: باعتبار الشريعة تعتمد على نصوص قديمة وباعتبار أنها لم تتطور في مقاصدها ومبادئها وأصولها وأدوات تطبيقها وفي معظم أحكامها منذ العصور الوسطى فإنها بالتالي قديمة ولا تتناسب مع عقلية العصر الحديث أو مع الحداثة. إنها نتاج العصور الوسطى بمعارفها وافكارها وأدواتها، فهي بالتالي قاصرة عن تلبية حاجات البشر في هذا العصر. وحسب نظرية الحداثة التي يؤمن به العلمانيون فإن قِدم الشريعة يجعلها غير مناسبة، قاصرة، متخلفة، جائرة وهمجية أحياناً.
- عدم تعارض القانون التام مع الشريعة: القانون، باعتباره متفوقاً على الشريعة بسبب حداثته وحداثيته، فإنه يشمل الشريعة وإن جزئياً، أي أنه لا يتناقض مع الكثير من مقاصد ومبادئ وأحكام الشريعة. وإذا حصل تناقض فحكم القانون أفضل. ويجب التنويه هنا إلى أن قانون الأسرة والميراث في سوريا يخضع تماماً لمعايير الشريعة الإسلامية أو المسيحية حسب دين الفرد.
- للفقهاء دور المشرع دون مراقبة: فقهاء وعلماء الدين لا يملكون حسب العلمانية الحق بالتحدث باسم الإله بناءاً على دورهم المتمم السابق الذكر. فهم حسب هذه النظرة ليسوا إلا مشرعين بشريين يصنعون الشرائع بالإعتماد على النصوص المقدسة ويسبغون عليها الشرعية الإلهية، مما يجعلهم بالتالي في مصافي المتسلطين لأنهم يتسلطون بأحكامهم على الناس دون مراقبة أو ردع أو محاسبة. هؤلاء المشرعون لا يمكن تعيينهم أو تغييرهم أو حتى الطعن بصحة قراراتهم (إجتهادات، قد يشكك بها علماء آخرون لكن ليس الشعب أو ممثلوه)، فهي وإن كانت إجتهادات فإنها ملزمة مع احتفاظ العالِم بحق تغيير الإجتهاد. كذلك فإن تعدد الآراء الفقهية وتعدد طرق الإلتحاق بعملية التشريع يجعل الإجماع صعباً مما يؤدي إلى تعدد وتناقض في الأحكام وفقدان المرجع الواحد الذي يجعل العدالة واحدة بين أهل العصر والبلد وإن كانت نسبية (أي أن هناك قنوات وقواعد لتغييرها وهي دائماً تحقق الإجماع وبالتالي القبول).
- فصل الشريعة عن الدولة:
- الفصل وليس القطيعة: ونعني بذلك أن العلماني لا يرفض الشريعة رفضاً قاطعاً ولكنه يرفض ربطها بالإله حصرياً وبكليتها. وذلك لأن المصدر الإلهي للشريعة يعني عدم إمكانية إخضاع المشرع للمراقبة الشعبية فهو إما الإله وإما الفقيه بدور المتمم لعمل الإله، وعدم إمكانية الطعن بالأحكام، وعدم إمكانية تغيير المبادئ وأحياناً الاحكام.
- فصل الفقيه عن المشرع: يمكن للفقيه أن يلتحق بمجلس الشعب ويخضع بالتالي لقواعده، لكنه لا يستطيع ان يسن القوانين وأن يعطيها الصفة الإلهية. بهذا يتخلى الفقيه عن دور خليفة الله ووريث الأنبياء وولي المجتمع. وبالتالي سيقتصر دور الفقيه على الأحكام المتعلقة بالعقيدة والعبادات والشعائر والاخلاق. ويُترك الإلتزام بأحكامه لإرادة الفرد دون مراقبة من الدولة للطرفين.
- المخالف لتمكين القانون: المخالف لتمكين القانون والمخالف لأحكام القانون ليس خائناً ولا كافراً ولا مرتداً وإنما مذنب لعُرف الجماعة، يُعاقب وفق القانون العقوبة التي أقرتها الجماعة وفقاً لمعاييرها.
- الدولة العلمانية البشرية: شرعية الدولة تنبع من تلبيتها لحاجات الناس (السلطة التشريعية) وتطبيقها للقانون (السلطة التنفيذية أو القضائية). وهي شرعية تتغير مع الزمن والثقافة والإجماع البشري. وفي الدولة العلمانية يمكن مراقبة المشرع من خلال المحكمة الدستورية العليا أو من خلال رئيس السلطة التنفيذية أو من خلال مجموعات المراقبة المدنية او حتى من خلال التظاهر والعمل الشعبي السياسي المباشر.
- نطاق القانون: ويعني هذا:
- بعض أمور الدنيا: لا يغطي القانون النية الفردية أو الأفكار أو المعتقدات أو العبادات أو الشعائر الدينية. كما أن القانون يقتصر على ضبط الحد الأدنى من الآداب دون أن يتعداها إلى الأخلاق. لكن القانون يدّعي الشمولية في تغطيته للدولة، والمعاملات بين الأفراد وبين المجموعات (خارج نطاق الأخلاق والآداب)، والعمل السياسي، ومراقبة الإقتصاد، وإعادة توزيع الثروة (من خلال الخدمات والضمان الإجتماعي والضرائب).
- التعامل مع المستجدات: إن التعقيدات الحديثة في الحياة العامة مثل الجمعيات والأحزاب، الإقتصاد والتجارة الخارجية والداخلية، الدستور والمجلسي النيابي، عمل أجهزة ومؤسسات الدولة، حقوق المواطن، البيئة، الضريبة ومصلحة الضرائب، الصحة العامة، الضمان الإجتماعي، الطرقات والنقل، البريد، قوانين العمل، الصناعة، التعليم، الزراعة، التخطيط، الخدمات العامة، القانون العسكري، التجسس والأمن القومي، الإحصاء، الملاحة والموانئ، المواطنة وواجبات وحقوق المواطن؛ هذه وما يستجد غيرها وما يتغير منها لم تعالجها الشريعة، وللقانون الحديث السبق والخبرة فيها. من الصعب ضم هذه المستجدات إلى النطاق الإلهي للشريعة وإسباغ الشرعية الإلهية على إجتهادات الشريعة في هذه المجالات؛ لأنها إما غير مضمنة في النصوص القديمة أو لأن أدوات الإستنباط التي تستخدمها الشريعة ستدفع بأحكامها بعيداً عن النص الديني بحيث تصبح الصلة بينهما واهية، وبحيث يتحول مزعم إلهية الشريعة مجرد أيديولوجيا سياسية لتبرير وجود طبقة حاكمة معينة تعتمد على الدين لصناعة شرعيتها. طبعاً يمكن الإستفادة من الشريعة كفقه قانوني باعتبارها التراث القانوني والفقهي للثقافة السائدة، كما يمكن تضمين الكثير من أحكام الشريعة في القانون كما بينا سابقاً. لكن لا يمكن أن نطلب من الشريعة أن تدخل بأدواتها المحدودة وتأخرها في هذه المجالات لبضعة قرون فقط وطريقة تدريب العاملين فيها في هذه المجالات متذرعين بأن القانون الحديث بشري أو وضعي أو لأن الإنسان بحاجة إلى قانون إلهي في كل تفاصيل حياته.
- فصل القانون عن الدين واحتكار العقاب: لا يتعدى القانون على المعتقدات الدينية أو الشعائر أو العبادات. يحتكر القانون المعاقبة على مخالفته لكنه لا يمنع الشريعة من الدخول وإبداء الرأي في مجال الجنايات وغيرها من مجالات الدولة دون الحق بإلزام الدولة على فرض هذه الأحكام أو الآراء او استخدام العقاب لفرضها. ويبقى الدين مجالاً للإله وعلاقته بالفرد يفرض عقابه الدنيوي أو الأخروي ويقيم عدالته.
- المماهاة الجزئية بين القانون والدولة والمواطنة: تفقد الدولة شرعيتها إذا لم تطبق القانون ونعني بالدولة هنا السلطة التنفيذية أو القضائية، لكنها لا تعني السلطة التشريعية إذا كان الفصل بين السلطات موجوداً. لا يمكن للمواطن كمفهوم سياسي فكري أن يوجد خارج القانون لكن يمكن للمؤمن أن يكون مؤمناً دون ارتباط إيمانه بالقانون ولا بالدولة. إن ادعاء كونية حقوق الإنسان (مما يقربها من الدين) يسمح أيضاً بوجود إنسانية الإنسان خارج محدودية بعض القوانين فتصبح هذه الحقوق محركاً لانتقاد القانون ومحرضاً على تغييره.
باختصار التيار الإسلام يضع الشريعة والشرعية والحكم والدولة خارج المجتمع البشري وإرادته ورغباته. هذه المؤسسات تصبح متعالية وإلهية لا يمكن تغييرها أو مراقبتها. أما التيار العلماني فيضع كل هذه المؤسسات داخل المجتمع البشري، فهي بالتالي نسبية وقابلة للتغيير والمراقبة وقيمتها تأتي من الإجماع عليها وتلبيتها لحاجات الناس في زمان ومكان وثقافة معينة.
تابعونا على صفحات وسائط التواصل الإجتماعي: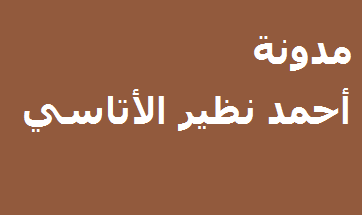




 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات