الدين والإلحاد والعلمانية وما بينها: نظرة تاريخية مستقبلية (2/1)

ظهر المقال على موقع الأوان في 26 ديسمبر، 2011. لكن بعد تجديد الموقع، اعطيت كل المقالات تاريخ التجديد، اي 8 ديسمبر، 2-13.
حديثاً، كتب سعيد ناشيد في “مستقبل الإلحاد” مجادلاً بأن قبضة الإسلام على الخيال رخوة تجعل إلحاد المسلم أسهل من إلحاد المسيحي الغربي الذي أحكمت المسيحية القبضة على خياله ووجدانه، فتماهت معهما. ممّا يجعل فقدان المسيحية للغربي، كما فهمت من جدال الكاتب، مشابهاً لفقدان معنى الحياة. وكتبت رجاء بن سلامة في “رد العلمانية إلى العالم” لتعطيناً صوراً مختلفة للتديّن يتداخل فيها الخاص بالعام والفرض بالعمل والواقع بالأيديولوجية، ولتتساءل في البداية والنهاية عن معنى العلمانية وسبل دمجها في الحياة كممارسة. من الواضح أنّ المسلمين وجيرانهم أمام معضلة كبيرة لا بدّ من التمعّن فيها واقتراح حلول لها. ألا وهي التعصّب للدين والمذهب، والتحزّب الطائفي، والتطرّف في تفسير النص الديني، وخلط الفرض الديني بالفرض المدني المحكوم بالقانون. ولا ينكر أيّ مراقب للأحداث مدى الاحتقان الطائفي والاجتماعي في العالم العربي والإسلامي، ومدى انحسار الحريات الفردية والجماعية، وتسلّط فئة تزعم أنّها تتكلم باسم الإله وتُدين بقانونه وتضرب بيده.
فهل تكمن المعضلة في الدين وتزول بتركه، أي بالإلحاد؟ أم أنّ الأزمة في رجال الدين وتنزاح بنبذ طاعتهم وتقليص سلطتهم، خاصة حيث تتطابق سلطتهم مع سلطة الدولة المحتكرة للعنف، أي بفصل الدين عن الدولة المسمّى أحياناً بالعلمانية؟ أم أنّ الاحتقان يسبّبه تأويل النص الديني وتراكم التأويلات الإقصائية والنافية للحريات ويخفّ باستنباط تأويلات جديدة أكثر مرونة واحتواءً للآخر المختلف وقبولاً بحقّ للفرد مختلف عن حقّ الإله، أي بتجديد الدين؟
وهنا لا بدّ من تحديد المفاهيم وإحكام التسميات وتمييز الداء وتوضيح المنهاج. هل يمكن أن نتكلم عن “ردّة دينية” إسلامية أو مسيحية أو غيرها دون أن يكون لدينا تعريف واضح ومحدّد للدين؟ هل يمكن أن نقدّم العلمانية أو الإلحاد كحلّين دون أن نعرّفهما؟ هل العلمانية هي نقيض الدين؟ هل الإلحاد هو العلمانية؟ هل الإلحاد نبذ للدين أم نبذ للإله؟ وهل العلمانية فصل للدين عن الدولة أم فصل للدين عن كلّ ما هو جماعيّ وجعله ممارسة فردية مقصورة على البيت أو الذات؟ هل الدين هو النص أم الدين هو الإيمان بوجود الإله وقدرته المطلقة المتسلّطة على الفرد والجماعة والطبيعة في آن واحد؟ يمكنني أن أذهب في هذه التساؤلات إلى ما لا نهاية. وكلّ قارئ أو قارئة سيفهمها حسب مرجعياته(ها)، فيتحوّل الحوار إلى “حوار طرشان” في “حمام ماؤه مقطوعة.”
لقد كانت الردود التي استدرجتها مقالة ناشيد من الرقة والشفافية ما لوّن الإلحاد في المجتمعات الإسلامية بألوان إنسانية ترفعه إلى مصافي التجربة الروحانية التي كان من المفترض في الدين أن يكونها. ولقد شدّت حكايات بن سلامة الدين إلى الواقع الفردي ما جعل دين شيوخ الفضائيات وفتاواهم هراء متعالياً فوق صحراء من الحيرة والتأزّم والرياء لا ماء فيها ولا حتى سراب. لكن ما استوقفني وحضّني على الكتابة هو الشحنة العاطفية في الردود التي قزّمت باعتقادي تحليل ناشيد الرصين، رغم ما فيه من فلسفة متعمّقة. وكذلك جبروت الجماعة والحياة بالنسبة لتجربة الفرد في الحكايات التي مزّقت باعتقادي تصنيف بن سلامة، رغم ما فيه من نظر ثاقب واتّزان علمي.
لقد ذكّرتني هاتان المقالتان بمأزق الأقسام الجامعية المسمّاة في الولايات المتحدة بأقسام الدراسات الدينية. ففي أواسط ستّينات القرن الماضي صدر قانون يسمح بدراسة الدين في الجامعات الأمريكية التي تتلقّى دعماً فدرالياً، على أن تكون دراسة “علمية” “علمانية” لا تدعو إلى دين معيّن ولا تفضّل ديناً أو مذهباً على آخر. وانتشرت هذه الأقسام في طول القارة وعرضها وأمّها طلاب وطالبات كثر ودرّس فيها متديّنون وملحدون وما بينهما على أن يكونوا حاملين لشهادات “علمية” “علمانية” في التاريخ أو الأنثروبولوجيا أو علم الاجتماع أو علم النفس (أي غير متخرّجين من ما يقابل كليات الشريعة عندنا). طبعاً في دولة تدّعي العلمانية وفي جامعات تدّعي العلميّة لا يمكن تعريف الدين على أنه كلام الإله وشريعته، فأجهدوا أنفسهم بتحصيل تعريفات للدين تضع منبعه في الإنسان وليس في الإله. وهنا طبعاً ينصبون منصّة يتبختر عليها كعارضات أزياء جهابذة الفلاسفة وغيرهم مثل دوركايم وفيبر وماركس وفرويد ووليام جيمس وميرسيا إلياد ونيتشه وكيركغارد ممن أدلوا بدلوهم في موضوع الدين، ويتركون للفرد المتلقي حرية الاختيار. لكن تمسُك الكثيرين من المدرّسين بشيء قرّروا تسميته التجربة الدينية منعهم من اختزال هذه التجربة إلى عوامل نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية فقط، فتراهم يدرّسون في موادّهم الأساسية ما يسمى بالعناصر السبعة للدّين (من وضع نينيان سمارت Ninian Smart) دون أن يحظى أيّ عنصر بحصّة الأسد فيُختزل الدين إليه. وهذه العناصر هي: الممارسة والشعائر، الوجدان والشعور، السرد والأسطورة، العقيدة والفلسفة، الأخلاق والشريعة، الجماعة والمؤسسة، والاقتصاد والمادة. وطبعاً كل عنصر يتجزّأ إلى عناصر تحته متعددة.
وباعتقادي تتلخص المقالتان المذكورتان أعلاه بمحاولتين لتحديد عناصر الدين أو نقيض هذه العناصر في تجربة المسلمين الآن. فناشيد يحاول أن يزن محتوى الإسلام من الوجدان والشعور والسرد والأسطورة، وأن يقارنه بمحتوى المسيحية الغربية من هذين العنصرين، مقرّاً بتفوق الأخيرة في هذا المجال (الذي سماه الخيال وعرّفه ضمنياً بالموسيقا والأدب والفن). مما يجعل الإلحاد (ولم يعرّفه الكاتب) عند المسيحي الغربي تجربة فقد أعمق منها عند المسلم الذي لا يفقد مالا يملكه أصلاً. وبن سلامة تبحث في الدين (أو تجارب دينية فردية) عن الفرض والقانون والمعرفة والأخلاق، لتجد في تحايُل هؤلاء الأفراد العملي على العوائق التي يضعها الدين في وجه ما نفهم ضمنياً أنه الغريزة والطبيعة الإنسانية الثابتة أثراً لعلمانية متجذرة في النفس الإنسانية أو على الأقل في طبيعة التجربة الإنسانية. والتجربة الدينية الإسلامية عند الكاتبين سلبية، فناشيد يرى فيها نقصاناً وبن سلامة ترى فيها أزمة وقناعاً أو رياء. قد أكون مخطئاً في تحليلي فأنا أمام نصوص ولست أمام أشخاص. لكنّ الجوهر فيما نفعله ثلاثتنا هو إنتاج المعرفة بقصد التأثير على الفرد المسلم(ة) والجماعة المسلمة. هما ينتجان معرفة وفق مرجعياتهما وأنا أعيد صياغتها حسب مرجعياتي حتى أفهمها، عسانا نخلص جميعاً إلى فهم (أو على الأقل إغناء الحوار حول) ما نعتقد أنه أزمة، مع اختلاف تحديدنا لها وفهمنا لآلياتها ونتائجها.
أرى أنه يجب الحديث عن تجربة دينية وليس فقط عن دين. فالتجربة مرتبطة بفرد أو بجماعة من الأفراد لكنها في النهاية مرتكزة على أساس من لحم ودم. أما الدين فهو فكر خرج عن نطاق اللحم والدم فصار نصاً (مكتوباً أو محكياً) جامداً، نصاً سردياً أسطورياً أو معيارياً ناموسياً (له علاقة بناموس يحكم الأفعال وحتى الأفكار). التجربة شعور وفعل، أما الدين فهو دالة انقطعت عن مدلولها، نعيد خلقها (أي تأويلها وربطها بمدلولها) كل يوم وكل لحظة من خلال التجربة. لكن كيف تختلف التجربة الدينية عن أية تجربة إنسانية أخرى؟ وكيف يختلف النص والمعيار الديني عن أي نص أو معيار آخرين؟ كيف أعرف أن ما أشعر به الآن ديني وأن ما أقرؤه أو أسمعه ديني؟ وهل التجربة الدينية واحدة في كل مكان وزمان وسياق ثقافي أم أنها تتغير؟ وهل الدين واحد أم متعدّد ومتغيّر؟ طبعاً يحلو للبعض أن يقول إن الإجابة واضحة سهلة: فكل ما له علاقة بالله فهو ديني وما خلا من الله فهو غير ديني. طبعاً البوذي سيحتجّ والهندوسي سيحتجّ وحتى المسيحي واليهودي. لكن ما أدراهم فهم قد ضلّوا عن جادّة الصواب وباؤوا بإثم عظيم ومأواهم جهنم وبئس المصير. انتهى النقاش وكفى الله المؤمنين شر القتال، أو الجدال.
أولاً أريد أن أقول إنّ العناصر السبعة سابقة الذكر لا تكون تقريباً كافية لدراسة الدين والتجربة الدينية إلا أن ندخل عنصر الزمن، لتتحول هذه العناصر من مكونات أوليّة ذريّة تتجمع ميكانيكياً إلى سيرورات وحراكات تتداخل عضوياً. المكونات الذرية الأولية لها جواهر وحدود، ومبدأ ومنتهى، وجمع وطرح، وزيادة ونقصان. أما السيرورات فهي تاريخ ومستقبل دون بداية ودون نهاية، ولها شدة وليس لها جمع، وخفوت وليس طرح، ولها تحوّل وتغيّر وليس لها زيادة أو نقصان. وأزعم دون برهان أن المعارف كلها اختزالية بطريقة أو بأخرى. بعض الاختزال مجحف متعسّف وبعضه تقريب يفي بالغرض. وبعض التجارب الدينية أو النصوص الدينية يمكن اختزالها إلى عنصر مكوّن أو أكثر دون تعسّف شديد، وبعضها يصعب اختزاله وحصره بجمع من العناصر المكونة. وما سأفعله هنا هو طرح تصوّر تاريخي للدين والتجربة الدينية، ومن ثمّ طرح اقتراح للأزمة التي يعيشها المجتمع الإسلامي مع دينه.
يعتقد بعض دارسي الديانات (وخاصة الديانات التوحيدية الثلاث) أن العالم والزمن ينقسم إلى مجالين، مجال المقدس أو المحرّم ومجال المدنّس أو المحلل. مجال المقدس مختص بالإله أو بالآلهة ومجال المدنس مختص بالإنسان. والتقديس والتحريم يعنيان الفصل والعزل والتمييز. فحرم الكعبة محدود بحدود واضحة مكانياً وزمانياً يتطلب اختراقها شعائر وطقوس تطهير تنقل الإنسان مؤقتاً من مجاله المدنس إلى مجال الإله الطاهر. ففي أيام الحج (أي الزمن المقدس) وداخل الحرم (أي المكان المقدس) يتحلل الإنسان من لباسه وكلامه وأفكاره وأفعاله (لا رفث ولا فجور) ليدخل في عالم وزمن هو نقيض عالمه، عالم لباس الإله وكلامه وأفكاره وأفعاله وزمنه. فداخل الحرم وفي أيام معدودات يتحول الإنسان إلى العري والذكر والصلاة والطواف، أي كما خلقته أمه في أقرب حال إلى ما يعتقد أنها الروح المطلقة المتحررة من الجسد، أي الروح التي كانت تعيش في ملكوت الإله تطوف حول العرش قبل أن تنزل إلى هذا العالم وتتدنس. فيصبح الدين وفق هذا الفهم كل ما يتعلق بالفصل بين المقدس والمدنس والعلاقة بينهما. ضمن هذا الإطار النظري (فصل المقدس عن المدنس) يصبح الدين شرع الإله والصراط المستقيم الذي يقود الإنسان من جسده إلى روحه، ومن مجاله المدنس إلى مجال الإله المقدس، وينتهي بخلاص الإنسان من آلام الدنس في جنة الإله المطهرة. وتصبح التجربة الدينية كل دخول في مجال المقدس، أي كل شعور بالاقتراب من الذات الإلهية عن طريق الشعائر كالصلاة والحج وغيرهما أو عن طريق الرياضة الروحية كالذكر الصوفي أو عن طريق الإلهام في الحلم أو الرؤيا أو اللحظات العرفانية التي يسمونها في المسيحية الأمريكية بالولادة الثانية.
باعتقادي، هذا فهم للدين لا يبتعد عن الفهم الإسلامي الذي ذكرته أعلاه، وإن كان واسعاً كفاية ليشمل المسيحية واليهودية وكل الديانات التي تؤمن بوجود إله أو آلهة متعالية خالقة، متحكمة، ومطلقة القدرة. وسأحاول هنا أن أتخيّل الصيرورة التاريخية (فحتى الإله له تاريخ) التي أنتجت هذا الفهم للدين والتجربة الدينية، لأبرهن من خلال هذه الصيرورة أن الفصل بين الدين وحياة الجماعة والأفراد، ليعود بعدها الدين متعالياً متسلطاً، أصليٌّ في الديانات التوحيدية. الجمع بين الفصل والتسلط في علاقة واحدة هو تناقض أساسي في بنية الديانات التوحيدية يقودها إلى أزمة مزمنة تضطرم أحياناً ثم تخبو لتعود فتضطرم من جديد.
هذا التأطير النظري للدين والتجربة الدينية يشبه النبوءة التي حققت ذاتها فدخلت في حلقة من إعادة خلق الذات. فالتجربة والدين يؤكّدان انقسام العالم إلى مجالي المقدس والمدنس. وهذا الانقسام يؤكّد بدوره ارتباط الدين بالمقدس وحصول التجربة الدينية داخل مجال المقدس. وهذا الفصل بين المجالين يؤدي إلى فصل الناس إلى جماعتين: الفرقة الناجية والفرقة الضالة، المؤمنون والكافرون، المطهرون والمدنسون. ويؤدي إلى فصل الأفعال إلى محللة (الصالحات) تسمح للإنسان دخول مجال المقدس ومحرمة (الطالحات) تبعد الإنسان عن المقدس وتبقيه أبداً في مجال المدنس وعذابه. ويعتقد البعض أن وجود المجال الرمادي المكون من الأفعال غير واضحة التحليل أو التحريم ( المستحسنة المستحبّة والمكروهة المستقبحة) ما هو إلا من رحمة الله بعباده. وأعتقد أن المجال الرمادي ضروري للتنفيس عن الاحتقان الذي يخلقه التقسيم الحاد الذي لا يقبل التفاوض بين المقدس والمدنس، المحلل والمحرم، والأبيض والأسود. وما توضحه حكايات بن سلامة هو أن الأفراد يحبون المفاوضة الدائمة ويفضلون مجالاً رمادياً واسعاً يمكنهم من الإبحار في تعقيدات الحياة الحديثة دون إحساس مهلك بالذنب وإبعاد محتمل عن جنة المقدس. طبعاً التفاوض لا يكون إلا على مستوى الأفراد، أي بين الإنسان وربه، لأن التفاوض الجماعي يحتّم إعادة صياغة للدين وإعادة تحديد لمجالي المقدس والمدنس، مما قد يثير بلبلة فكرية واجتماعية ومقاومة شديدة ممن ارتبطت مصالحه بالتحديد القديم.
فمن وضع نفسه حارساً للحدود القديمة وبنى عروشه على ترسيمها وعلى “تجارة الترانزيت” بين المقدس والمدنس لن يستسيغ فقدان الرساميل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والسياسية التي راكمها على مدى السنين. وسيحاربها بما أوتي(ت) من قوة وعدّة ورباط خيل. الأب (بكل أشكاله) الذي يرى طاعته من طاعة الإله، وأفعاله من إلهام الإله، وشرفه في اجتناب ما حرّم الإله وفعل ما حللّه، وقوته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لن يتفرج على الخاضعين يتفاوضون مع الإله مباشرة وعلى هواهم ليقلبوا الدنيا رأساً على عقب. وشيوخ الحيض والنفاس، الذين رسموا لأنفسهم سلالات نسب فكرية (هي الإسناد) تتطاول عبر ألف وأربعمائة عام لتعود إلى اللحظة المؤسسة والرجل المؤسس ومنه إلى الإله مباشرة، لن يسكتوا عن محاولات تكسير نسبهم الفكري وإعادة تركيبها أو نفيها وإقرار سلالات مغايرة لينتفع بها أناس آخرون. من كان سنده القرطبي وابن حنبل وابن تيمية لن يترك الحلبة لمن سنده ابن رشد أو ابن عربي والحلاج أو المعري، وحتماً ليس لمن سنده فرويد ونيتشه وداروين. وأعتقد أن المواجهة لا بد منها وأستبعد أن تكون سلمية وإن كنت آمل وأعمل لتكون سلمية.
فما العمل؟ هل نعمل على تجديد الدين (أي إعادة ترسيم الحدود بين المقدس والمدنس)؟ أم نعمل على نقض فكرة التقسيم من أصلها (أي نرفض الدين)؟ مهلاً، مهلاً، فإصراري على عنصر الزمن السابق الذكر (وبالتالي السيرورة والصيرورة) أساسي لفهم الظاهرة ومن ثم استجلاء الحلول. فلا بدّ من متابعة التاريخ.
أعتقد أنّ هذا الفصل بين المقدس والمدنس وليد العشرة آلاف سنة الأخيرة من عمر الإنسان، أي منذ اكتشاف الزراعة ونشوء المدنية. أربط هنا ظهور الآلهة المتعالية (القائمة خارج الطبيعة) بظهور المجتمعات الإنسانية، أي بظهور المدنيّة. قبلها عاش الإنسان ضمن جماعات صغيرة متنقلة ليس لها حدود جغرافية ولا حدود اجتماعية. المدينة بحد ذاتها فصل واضح بين عالم الفوضى خارجها وعالم التنظيم داخلها. ونرى في أكثر الأساطير الكوسمولوجية المعروفة (وهي أساطير مدنية من عهد التدوين أي تعود إلى الألف الرابعة قبل الميلاد على أقل تقدير) أن الوجود انتقل من مرحلة فوضى العماء المائي إلى مرحلة الخلق المنظم، ومن مرحلة الكون-الإله (أي الكون = جسد الإله) إلى مرحلة الإله المتعالي على الطبيعة والخالق لها من أشلاء آلهة قديمة أومن زوائده (البصاق أو المني أو الكلمة. وهذا ليس فيضاً وإنما انبثاق). وأرى في هذا الانتقال الرمزي انتقالاً من اعتقاد بوحدة الوجود إلى اعتقاد آخر بتعدد الوجود.
في عالم الوجود الواحد لا يوجد إلا جوهر واحد: فالإنسان والحيوان والنبات والجماد والرياح والأرواح والحياة والموت، ما هي إلا تجليات لهذا الجوهر، والحدود بينها واهية يسهل اختراقها. فروح الحيوان قد تسكن في الإنسان، وقد تنتقل بعدها إلى النبات ثم إلى الجماد، أو قد تهيم على وجهها ريحاً تلعب بالأغصان وتسيّر السحب، وقد تذهب إلى عالم الموت (أو النوم) في زورق يطفو على نهر يتجه غرباً لتعود بعدها إلى عالم الحياة (أو الصحو) على جناحي نسر آت من الشرق يحمل الشمس على كتفيه. وهنا أربط مفهوم الروح بالقدرة على الحركة وما روح الجماد إلا روح شاءت السكون أو شيء تخلت عنه روحه المحركة. في عالم الوجود الواحد لا وجود للمقدس والمدنس، للمحرّم والمحلّل، للصراط المستقيم وجادة الضالين. وكل تجربة إنسانية هي تجربة دينية إذ ليس هناك دين.
أما في عالم الوجود المتعدد فهناك أرواح متسلطة وأخرى خاضعة، وأرواح أبدية وأخرى محدودة زمنياً، وأرواح مربوطة بالجسد وأخرى طليقة، وأرواح قادرة وأخرى عاجزة. وقد يكون هذا الفصل انعكاساً لتعدد الأعمال وتخصصها المتزايد وارتباطها بإنتاج قيمة زائدة تسمح بالتبادل. فالمتنقل الصياد الجامع للنبات لا ينتج إلا أدواته وملابسه ولا يبني بيتاً دائماً، أما المزارع فينتج محصولاً قد يقايضه بأداة أو لباس أو آنية ويسكن في بيت دائم من صنعه. التوطن والتوقف عن الترحال يفصل العالم إلى بيت جوّانيّ وبريّة برّانية، إلى أمن وخطر، نظام وفوضى، حياة وموت. ومن الواضح أن المدنية ارتبطت بالزراعة وإنتاج الثروة وتخزينها، وظهور الأسرة والمأوى الأسري، وظهور التراتب الاجتماعي والاقتصادي، وتحوّل العمل إلى سلعة وتبادل السلع. التراتب الاجتماعي هو تفاضل في المكانة وامتلاك السلطة وتفاضل في اكتناز الثروة وتوزيعها. وكما تسلط أفراد على آخرين بتفاضل المكانة والثروة، فليس من الغريب أن تتسلط بعض الأرواح على غيرها لتتحول إلى أرباب (أي أسياد) يسكنون المدينة ويتخذون بيتاً لهم فيها وأزواجاً وأولاداً ويبنون الأسوار ويذودون عن الحمى. وهنا نربط ظهور الآلهة-الأرباب بظهور شخصية القائد-الملك أي المتسلط بالقوة والمالك للثروة. وليس غريباً أن يكون الإله- الربّ ملكاً ذا عرش وجنود وكتبة ومخازن وقانون وحجّاب، فباعتقادي أن تحول بعض الأرواح إلى أرباب تلازم مع تحول بعض الأفراد إلى أسياد وملوك ذوي عرش وجنود وكتبة ومخازن وشريعة وحجّاب.
تابعونا على صفحات وسائط التواصل الإجتماعي: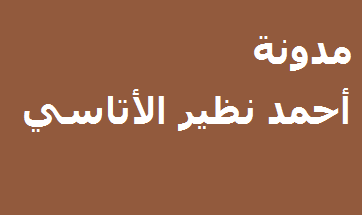




 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات