كيف أحبُّكِ؟ مجاهَدة لسانية

ظهر المقال على موقع الأوان في 19 ديسمبر، 2010
من الكلمة إلى الأنثى:
أشجاني مقال الأستاذ نادر قريط ثرثرة على ضفاف الكتابة حين ذكر رسائل كافكا إلى محبوبته متسائلاً “عن لغتنا وكيف يتأوّه الناس في بلادنا ويتسامرون، وكيف يُترجمون أشواقهم وعواطفهم وما يجتاح كينونتهم؟ وماذا يقول الفتى وهو يلمس يدها؟ وماذا تقول وهي ترمقه بخفر وحياء؟” وثمّنت صراحته حين أفصح عن مشاعر “الصدمة والخجل” التي خالجته إبان قراءة الكتاب. والشجا غير الشجو وغير الشجن. فالشجا غصة في الحلق، والشجو طرب وهيجان يولّدان حزناً، والشجن حاجة أو عوز في النفس تَهمّها فتُحزنها. وأصحّح فأقول أشجاني غصة وطرباً وشجنني فقداً وعوزاً. قلت نَعم، نِعم ما قال. وقلت لا، بئس ما قال. وقلت لا، لا أتباكى على الأطلال. فهيا إلى العقل أعصره، واللسان ألويه، والقلم أثقِله، والورق أدميه.
وإنّي أفهم قصده، لكنّي لا أشاركه المشاعر لأنّي ألفت الصدمات من زمن حتى استسغت طعمها لا بل طلبتها. وخلعت برقع الحياء والخجل متلذّذاً بالمجابهة، ساكناً للفضيحة. ولا يهمّني المعنى الأخلاقيّ هنا بقدر ما يهمّني المعنى الفكريّ. وبقيت سؤالاته تموج بي، وجاس بي طيف كافكا حتى هَوَسني وهو يُعْوِل كشيخ الجبّ (البئر) الذي كانت جدّتي تخوّفنا به لإبعادنا عن أهوال السقوط في البير. لكن أين حكمة جدّتي من حكمة “أليس” التي ما وصلت إلى بلاد العجائب إلا بسقوطها في البير. فكفاكَ صراخاً يا كافكا فما أنت إلا غرّ جاهل بالحبّ والجسد يدّارئ خلف كلماته يخفي بها اضطراب قلبه وانقباض أمعائه وهذيان عقله أمام عالم المرأة الذي لم يختلس حتى نظرة متلصصة متلذذة من خرم بابه.
وسؤال نادر قريط أظرِفه في ظرف كلماتي رافعاً عنه السلبية مسبغاً عليه الإيجابية هو التالي : هل يا ترى تتضخم اللغة وأدواتها حين نحسن التعبير عن مشاعرنا وأفكارنا؟ هل يمكن للكاتب أن تبزّ مشاعرُه لغتَه غنىً وتنوعاً؟ أم أنّ المشاعر تتقلص وتتقلّل لتجاري فقر اللغة؟ وهنا أجترئ فأقول إنّ اللغة قد تتفخّم وتتضخّم لتخفي ارتباكنا وخوفنا من الإبحار في خضمّ المشاعر دون دليل. لم أقرأ كافكا ولم يرمِ يوماً في وجهي قفّاز التحدّي ولم يؤجّلني إلى فجر الغد للمبارزة. لكني وبذكورة تنتشي بخمرة التستسترون سأقوّله ما ألمَح إليه قريط وسأساجله في عالم ذكورته المتضخّم، أي اللغة.
لن أكتب نثراً فيكتورياً في الحبّ العذريّ، أو بالحقيقة المتعذّر، محافظاً أنيقاً منمقاً مدبّجاً مدمجاً متصلّباً كالمصاب بكتمان البراز أو بتصلّب فقرات العنق. ولن أكتب نثراً أقُطّ فيه أذني لأرسلها إلى الحبيبة معتقداً، في دوراني النرجسيّ حول صرّتي، أنّ الحبيبة لا تطلب من حبيبها إلا قطعة من جسده، أذنَه كانت أو قضيبه أو حتى خصلة من شعره. لكني سأكتب نثراً يسعى بين مروة الجسد وصفا الشعور، هائماً في عالم الذكورة النرجسية بحثاً عن أوّل الخيط الذي قد يقودني إلى الأنثى. فأنا الجالس على كرسي الاعتراف أقول: “إني مريض بالأنا الذكرية، هذه الغابة من القضبان التي تحجبني عنكِ وتحجبك عني، ولن أصلِ إليك إلا بأن أجاهد أناي باللسان حتى يسحّ العرق من كلّ مسامّ في جلدي. حتى أتجاوز ذاتي في مرآة وجهك لأرى وجهك كما تحبّين أن أراه”.
الكلمة والمعنى، آح الفكرة ومحّها، هيكلها ومحتوها، صورتها وهيولاها؟ لا أعرف الجواب يا أستاذ قريط لكني سأرمي نفسي في البير دون أن أرمي حصوة أوّلاً لسبر الغور. كالمصارعين الأتراك سيطلي كلٌ جسدَه بزيت الزيتون ثم ستتشابك الأيدي. سيمطّ المعنى أوصال الكلمة حتى الألم، وستحشك الكلمة المعنى في قوالبها حشراً حتى الاختناق. سأستجدي الكلمات على أبواب القواميس حتى تطردني كما يُطرد الشحّاذ الملحاح النقّاق. سأكسر كلّ قواعد الصرف واستنباط الكلمات حتى يقولوا : “قالتِ العرب كذا، لكن قال نظير كذا” أو يقولوا “هي كذا علمناها بالسماع من قبيلة تائهة برواية نظير”. سأذهب إلى زوابيق العامية وأدخل مجالس الفصحى وصالوناتها. سأستبضع للغتي عند لغات أخرى لأنجب جيوشاً من المولّدين، وسأترك بابي مفتوحاً ليحرث الغريب في حرثنا يدحمُهنّ دحماً (كما وعد الحديث أهل الجنة)، فما الولد إلا للفراش. فنحن لا نعرف بين اللغات إلا علاقات سفاح فنسميها تلاقحاً إن استحسنّا واختراقاً إن استهجنّا.
لست أرى تراجيديا قطباها الكلمة والمعنى أفضل من مبارزة كافكا على أرض طينيّة زلقة لم يألفها كلانا، وأعني الغوص الاعترافي في غياهب الذكورة من أجل الخروج على ضفاف الأنثى وتقديم إكسير الحياة : “يا امرأتي، أعرف كيف أحبّك”. لن أحبّها إمرأتي، أو أعشقها أو أهيم بها أو أجِد بها، فهذه ليست إلا مشاعر أنانية نحبّ من خلالها أنفسنا قبل أن نحبّ الأنثى، أو على أقلّ تقدير نحبّ حبّنا لها. لكني سأنقُب الأرض بحثاً عن سبيل إلى حبّها كما تريدني أن أحبّها لا كما أريد أن أحبّها. أذكر هنا نصيحة مضيفات الطائرة : “إذا طرأ طارئ ضع قناع التنفس على وجهك قبل أن تضعه على وجه من تحبّ، وإلا متّما كلاكما اختناقاً”. والحقيقة المُرّة التي يجب قبولها هي أننا لن نحسن حبّ الآخر ما لم نبرع في حبّ أنفسنا قبلاً، ولن نعرف الآخر حتى نعرف أنفسنا، ولن نفسح للآخر مكاناً في قلوبنا ما دامت ذواتنا تملأ قلوبَنا. إذاً، لن أمارس حبّ ذاتي متقنّعاً بقناع العشق والهيام والوجد، بل سأدخل لجّة ذاتي أسبر الأغوار مستقصياً من أدناها إلى أقصاها عن التي أحبّها ولستُ هي حتى أصل إليكِ أنتِ. أنتِ الكائنةُ بذاتها خارج ذاتي، أنتِ بما هي أنتِ، أنتِ كما أنتِ كائنة، لا كما يجب أن تكوني.
من الذكر إلى الأنثى – هل من طريق؟
قَضَبَ الشيء قطعه، والقضيب غصن مقتطَع من شجرة. اختبل عقلي حين خصاني لسان العرب. أحسست بوخز مبضع الجرّاح بين فخذي لما علمت أنّ القضيب فرع وليس أصلاً، أنه لا يكون قضيباً إلا بالقضب أي القطع. هل يُعقل أن يكون الله قد أخطأ قراءة مسودة مشروعه فبدل أن يقضب جزءاً من حواء ليجعله في آدم قضيبَه، كسر جزءاً من آدم ليجعله حواء نفسَها. زَبلت لسان العرب وكفرت به وبجامعي مادّته من الأعاجم وأمسيت دخيل المحكية السورية تحميني وتجيرني من أعجميّ سمع أعرابياً منذ ألف شتاء يقول اقتضب بسؤالك يا علج، أي أقصر. فأنا أبحث عن التطاول ويهولني التقصير. ردّ لي ذكورتي قضيب الرمان في بستان جدّي وقضيب الخيزران في سوق الجمّالين والحمّارين والبغّالين في حمص. غصن البان وعود الريحان وقضيب الرمّان، والفرق واضح. الرمان شجيرة قديمة قدم تاريخ البلد، فروعها متينة لكن طيّعة، تتلوّى في الهواء كخيط الحرير لكنّ وقعها على الجسد كالسوط المجدول، صبورة على العطش، ضنينة بأوراقها، سخيّة بوخز إبرها، متشبّثة بثمارها تُضمِّنها ظرفاً ثخيناً وتحشوها حامضاً قارحاً. كم خدد جلودَنا قضيبُ الرمان لكنه ابن أبيه، شبل من ذاك الأسد، جدير برمز الذكورة. لا يكون القضيب إلا من الرمان، وما عداه أعواد وأخشاب وعِصِيّ، راسخ، أصيل، يخشى مسَّه الجميعُ وعلقمَ جلدة ثمرته وتقريحَ عصيرها الحامض.
“رجل” (ويقف وهلة) كما يحلو لأبي أن يقول، “رجل”؛ وفراغات المعنى تملؤها قرون من التراث. مفهوم لا تحيط به الكلمات ويكفي الصمت للتعريف به. لا توجد كلمة تتماهى مع معناها ككلمة رجل. الصورة هي المعنى، إذ تكفي الكلمة لأدائه ولا تستطيع أية كلمة أخرى أداءه ولذا لا حاجة بنا إلى جملة إسمية يعرّف خبرُها بمبتدئها. المبتدأ يكفي بذاته، والخبر يكفينا الصمتُ مؤونة اختراعِه.
مرة ألح عليّ طلابي الأمريكان، وكنت أدرّسهم العربية، أن أعلّمهم فنّ الشتيمة في اللغة العربية، فالحظوظ كبيرة أن تكون أوّل كلمة تسمعها في بلد أجنبيّ أو أوّل كلمة تنطق بها في بلد أجنبيّ شتيمة. فكّرت ملياً في الأمر ثم حزمت أمري أن أجعلها تجربة عسيرة من النوع الذي يطلب المسيحيون من الربّ في صلواتهم أن يبعدهم عنه. فرسمت على السبورة ثلاثة مربعات تربطها علامات جمع. في المربع الأول تربعت كلمت “أيري” وفي المربع الثاني أخضعت “الكس” للأير السابق له بحرف جرّ قادر متسلّط. وفي المربع الثالث أضفت إلى “الكسّ” عبارة “أية أنثى من أقارب المشتوم في تركيب إضافة” حيث “الكس” هو المضاف والقريبة هي المضاف إليه. ثم جمعت الكلمتين الأوليين بمربع واحد يقوم بديلاً عنهما عنونته “أنيك”. وكما يصمت الناس بعد كلمة “رجل” (إلا إذا أضافوا العبارة الدرامية التي تبرز خطورة المعنى “والرجال قليل”) يمكن أن نصمت عن كلمة “أيري” وأن نلفظ الواجب معرفته بالضرورة (أي ضرورة أذى الشتيمة)، وأعني “كس + قريبة للمشتوم”. وحسبت أني دفعت التجريد إلى حدّ تحويل الشتيمة المثيرة إلى نظرية لغوية مملّة، وإذا بهم يطلبون قائمة بالقريبات المحتملات، مرتّبات حسب شدّة وقع الشتيمة. فابتدأت بالأمّ وأتبعتها بالأخت. وهنا ينتهي الشرف وتبدأ إراقة الدماء لكني أؤكّد لكم أنّي سمعت مَن جادت قريحته السادية بقريبات أخريات مثل أخت الأب وأمّ الأب وأمّهات الأجداد، والغالب أن يكنّ من طرف الأب لأنّ لطرف الأم رجالا يذودون عن حماه وليس المشتوم معنيّا بهنّ.
عندما ننتقل من فضاء لغة إلى فضاء لغة أخرى نترك إرث الأولى مع كلماتها يغيب في ثنايا الدماغ وننطلق أحراراً خفافاً في فضاء اللغة الجديدة دون موانع تعوق تقاطُر الكلمات إلى اللسان، مثل الإحساس بالذنب أو الخزي أو العار، وكأننا نحبّ أن نسمع الكلمات الجديدة دون أن نوقد في أذهاننا نيران أفران محرّكات اللحظات والتجارب التي تصوغ المعنى. لكن عندما درّست العربية دخلت في عوالم لم أعرفها ولا خرائط لها عندي تعرّفني بتضاريسها، سهلها وجبلها، عسيرها ويسيرها. عندما ألفظ الكلمة العربية أستحضر المشاعر والتجارب التي تكوّن معناها، لكن في فضاء اجتماعي لا يعرف سوق الرموز هذا، قد أتلذّذ بنقل ما أحبّ من المعاني من خلال ما يحضرني من ذكريات مربوطة بخيط اللفظ، وقد أتلذذ أحياناً أخرى بلفظ كلمات تابوهات دون الخوف من العقاب الذي قد يُنزله المجتمع المنتِج للمعنى بي. فهل يا ترى جرجرني الطلاب إلى عالم الشتائم أم أنّي انسقت إليه متقنّعاً بالحرج والخجل؟
لكن هذا اللعب الطفولي بالرموز ودلالاتها وتبعاتِها الاجتماعية انتهى بصاعقة الغثيان التي انتابتني حين أصرّ الطلاب أن أشرح لهم معاني الشتائم التي اختصرتها بنجاح لم أتوقّع عواقبه ولا حمدتها. كلّ الشعوب تتكئ على القضيب كأداة تعذيب جسدي ومعنوي (بالأحرى أداة اغتصاب)، ولم يكن من العسير إحالة الطلاب إلى لغتهم الأمّ لتبيان المعنى العامّ للشتائم العربية. إلا أنّ ذهني أبحر وحده مشدوداً باستكشاف كهوف اللغة الأمّ، هذه الأمّ التي مكنتني من أن “أنيك أمّهات كثيرات”. لم يخطر يوماً ببالي أنّ صوراً لوجوه إنسانية وأعضاء إنسانية وأفعال إنسانية يمكن أن تحلّ محل الكلمات المحاطة بمربعاتي. ما هو الفعل الذي نعنيه “بكس أمك”؟ ما هي تفاصيل الممارسة؟ أين تكمن الأذية الموجّهة إلى المشتوم؟ أهي في هتك العرض؟ أم في دغدغة أوديب المشتوم بإلصاق أبٍ بأمّه كان قد حسب أنه قتله وانتهى منه؟ أم في القهقهات الشيطانية لمغتصب يعذّب ضحيتَه أمام من يحبُها؟ وتظل الأمّ هنا جسداً منتهكاً لا قيمة له ولا حساب في اتفاق ضمنيّ بين الشاتم والمشتوم يحوّلها إلى مجرّد ناقلة للأذية. “النيك”، هذه الرجفات الإيقاعية التي لا يرى فيها الذكر الشاتم السكران بذكورته المستفَزّة إلا طَرقات مطرقة، ضربات سوط، لطمات كفّ، ضربات عصى، لسعات قضيب رمان.
“وماذا يقول الفتى وهو يلمس يدها؟” يقول: طرق، ضرب، خجأ (ضرب)، دحم (دفع)، قضى وطره، وطئ، علا، افتضّ (ثقب)، افترع (أدمى)، باضع (شق)، ركب، فلح، حرث، فتح، فتق، شق …
وإن غطس في اللسان، لسان آبائه وأجداده وكل السلف الصالح الطالع من بين سطور (أو أساطير) النصوص القديمة، لن يجد إلا هذه اللولوات: يا كِناز (الجارية الكثيرة اللحم، وكذلك الناقة)، يا سَلْهَبة (الجَسِيمةُ، وليست بِمدْحَة)، يا بَهْصَلَة ويا بُهْصُلة (الشديدةُ البياض، وقيل هي القَصيرة)، يا فُنُق ويا مِفْناق (جسيمة حسنة فَتِيَّة مُنَعَّمة. الأصمعي: وامرأَة فُنُق قليلة اللحم)، يا هِرْكَوْلة (الضَّخْمة الأَوْراك، ذات فخذين وجسم وعَجُز، الجارية الضخمة المُرْتَجَّة الأَرْداف)، يا مُزَوْزِكة (التي إِذا مشَتْ أَسْرَعت وحركت أَلْيَتَيْها)، يا دَرْماء (لا تستبين كُعُوبُها ولا مَرافِقُها).
“وماذا تقول وهي ترمقه بخفر وحياء؟” تقول: يا سبعي، يا ضبعي، إني أنكَحتُك نفسي … فانكحني. ولا يجوز أن تقول نَكَحتُك فهذا ما لم تقله العرب، العاربة والمستعربة والمُعرِبة والمعرَبة والمعرِّبة والمعرَّبة والمتعرِّبة والمتعرَّبة والمتعاربة والمنعربة والمُعْرَبَّة، ولن تقوله، لأن العين منقلبة عن فاء بالفطرة والراء مُبدَلة بحاء طبيعةً والباء سقطت سهواً وحلت محلَها لام، فَحْل.
من الأنثى إلى الذكر – حيث تنتهي كل الدروب:
لطالما فكّرت في الفراسة، هذه المهارة التي زعمت كتب التراث، وما أكثر ما زعمت، أن الأعراب القدماء امتلكوها. هل يمكن فعلاً أن أعرف شيئاً عن خبايا نفسكِ بإمعان النظر في وجهكِ؟ هل غضون وجهك أبواب إلى طيّات ذاتكِ؟ ألهذا كانت الأنفة من ارتفاع الأنف؟ فما الصلة إذاً بين الحَنَك والحِنكة؟ وهل الأفوَه دائماً مفوّه؟ وحقيقةً، إن اللحيظات القليلة التي يعترض فيها جسدُكِ نظري لا أملك إلا تلك الصورة المنطبعة في عينيّ. فإذا بعُدتِ لم أعرف إلا شخصك وقامتك، وإذا قرُبت ساحت نظراتي على أجزاء جسدك تستنطقها جزءًا فجزء. وفي الحالتين لستِ إلا صورة تعوم في بحر الوهم. لكنها ملكي أتسلّط عليها سلطة مطلقة. صورتكِ هذه ملكي أفعل بها ما أشاء وتتلاشى شيئاً فشيئاً مع كلّ كلمة تلفظها شفتاك. لكني غالباً ما أتفادى الكلمات قاصراً معرفتي على صورة لا تنطق ولا أريد لها أن تنطق. صورة تقرأ أفكاري وتطيعها دون مويجات صوتية من فمي أو فمك، آمرها فتفعل. ملكي أنا وحدي ألعب بها، أقلّبها، أعرّيها، أتحسّسها. ما أسهل أن نملك إنساناً آخر أو إنسانة حين لا يكونان إلا خيالاً مسلوب الفكر والإرادة والحركة والفعل.
شعرك، نهداك، خصرك، ردفاك، أعمدة أرجلك، ووجنات قفاك، لا أرى فيكِ مِنْ أنتِ إلا جسمَكِ وهَنَاكِ. منذ خلق الله إسماعيل وأنطقه العربية كانت الأسماء ستة لكنهم لم يعلموني إلا خمسة: أبٌ، أخٌ، حَمٌ، فو، ذو. قالوا هذه أقوى الأسماء في العربية لأنه تُعرَب بالأحرف لا بالحركات أو بالأحرى تُعرِب عن نفسها دون خفر بحرف واضح جليّ وليس بحركة هي أقرب إلى الإيماء منها إلى البوح بالمخبّإ. لكنها متى تأنثت (باستثناء أب وفو) استحيت واكتفت بالإشارة والومى. أليس صمت العذارى لغة، لكنها لغة لا تعرف إلا كلمة واحدة، نعم. لكن السرّ، الكاعب المخبوءة، الذي يتناقله الصبية المراهقون كما يستمنون هو أن الأسماء ستة، وسادسها، أعنى سادستها، المنبوذة المخلوعة من قبيلة الأسماء التي تفصح عن نفسها بالحروف وليس بالإشارة إسم مؤنث، الأنثى الوحيدة، هَنٌ (أي عضو الأنوثة). جماعة الخمسة، جماعة الرقم العقيم المفرد أخفت سادستها حتى لا تزدوج فتخصب الجماعة كلها، أخفتها بأن أهملتها ثم بأن فرضت عليها قِناع المعنى المزدوج (كلمة هنٌ تعني أيضاً الشيء). السادسة مصابة بانفصام الشخصية، شخصيتها الأولى عضو (أو عضوة) منبوذ مخلوع، وشخصيتها الثانية جماد لا وجه له، شيء، ليس مذكراً ولا مؤنث. “أعطني هَناكِ يا أختَ العرب، أعني قلمَكِ!”، “خُذ هَنايَ يا أخا العرب، أعني قلمي!”
حين أتفرّس في هَنيكِ يا حبيبتي تحلّ بي مهارة الأجداد العجيبة في معرفة المعنى من الصورة، في معرفة العمق من السطح، وفي معرفة الطوية من القسمات. حين أتفرّس في هنيك يا حبيبتي فإني لا أرى بين الإسكتين وعلى شفا الشفرتين إلا حفرة مدمّاة تركها الإله حين اقتلع قضيبكِ من شرشه. عفواً أستاذ بروفسور فرويد أعتقد أنك على حقّ، لقد أضاعته، وهي تحنّ إليه ليل نهار وتغار مني لأني حافظت عليه في حين أنها أضاعته. يا لبؤسها. لا بدّ أنها الخطيئة الأولى التي يتحدثون عنها.
عفواً مرة أخرى أستاذ بروفسور فرويد، لا أستطيع أن أكذب على محلّل نفسيّ، لأنك كالقسيس الكاثوليكي في مقصورة الاعتراف، لا تقبل إلا الحقيقة التي لا يكون الغفران دونها. إني أسخر منك وأعتقد أن فراستك مثل فراستي، لأني حين نظرت إلى حبيبتي من الكوة الوحيدة التي تقودني إلى محتواها لم أرَ إلا خيال نفسي. فكيف أحبُكِ؟
تابعونا على صفحات وسائط التواصل الإجتماعي: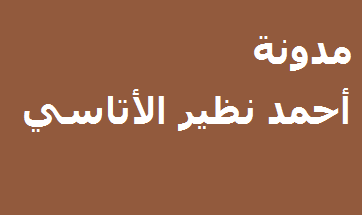


 أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أنا، أحمد نظير الأتاسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإجتماعية في جامعة لويزيانا التقنية (لويزيانا، الولايات المتحدة). في عملي الأكاديمي، أدرّس مقدمة لتاريخ العالم، تاريخ الشرق الأوسط (القديم والقروسطي، والحديث). وأعمل أيضاً كرئيس للمركز الإستراتيجي لدراسة التغيير في الشرق الأوسط،
أحدث التعليقات